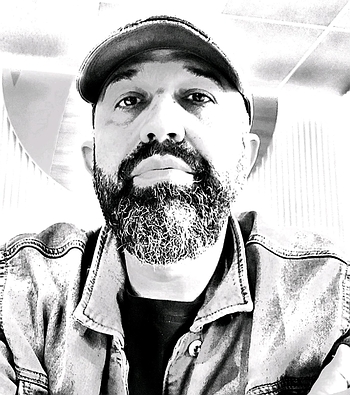عاصم محمود أمين
قبل أيام، ترددت في الفضاء السياسي أصوات ميتة تُشبّه الجولاني بصدام حسين. ورغم أن هذا التشبيه قد يبدو للوهلة الأولى مجازًا متسرّعًا أو مقارنة سطحية بين شخصين متباعدين في السياق والوسائل، إلا أنه في عمقه يحمل دلالة أبعد وأثقل. إنها ليست مجرد مقارنة بين رجلين، بل استحضار لذاكرة سياسية مثقلة بالدم والانقلابات والمقايضات والخيانات. تشبيه كهذا يفتح باب التأمل في آلية اشتغال السلطة في العالم العربي، حيث لا يُدفن التاريخ، بل يُعاد تدويره في أقنعة جديدة، وبأسماء تتبدل، بينما الجوهر يبقى على حاله.
كما فرض صدام حسين سلطته المطلقة من خلال شبكة من التنازلات والتحالفات الملتبسة، واستثمر في القمع كأداة دائمة للشرعية، يبدو الجولاني اليوم – بملامحه المختلفة – يسير على طريق موازٍ، وإن تغيّرت الأدوات وتبدّلت الشعارات. فصدام كان نتاج دولة مركزية تمتلك جيشاً ونظاماً مؤسسياً وهيكلاً بيروقراطياً، بينما الجولاني وُلد من رحم الفراغ، في لحظة انكسار الدولة السورية وتفتتها، وجاء محمولاً على موجة العسكرة والفوضى وتعدد الرؤوس المسلحة.
لكن الفارق السياقي لا يُلغي التشابه البنيوي. صدام خاض حروباً بجيش وطني نظامي، بينما الجولاني يعتمد على شبكات فصائلية عابرة للحدود، محكومة بعلاقات معقدة مع أجهزة استخبارات إقليمية ودولية. كلاهما أعاد تعريف “العدو” و”الصديق” تبعاً للظرف والمصلحة، وكلاهما مارس التضليل السياسي والخطاب التعبوي القومي أو الديني لتخدير الشارع واستدراجه نحو الطاعة.
وقبل أن ينقلب صدام حسين على أحمد حسن البكر، كان قد مهّد لانقلابه بسلسلة تنازلات استراتيجية، أبرزها اتفاقية الجزائر عام 1975، حين تخلى عن جزء من شط العرب لإيران مقابل وقف دعمها للثورة الكردية. هذه المقايضة – رغم كلفتها السيادية – أتاحت له فسحة زمنية لإعادة ترتيب أوراق السلطة، والسيطرة الكاملة على الدولة.
واليوم، يسلك الجولاني مسارًا مشابهاً في البنية وإن اختلف في الشكل؛ إذ تشير الوقائع إلى تنازل غير معلن عن ملف الجولان لصالح إسرائيل، مقابل قبول إقليمي ودولي بدوره في كبح أي مشروع كردي ذاتي أو إداري في شمال سوريا. هذه الصفقات الصامتة تُدار بذهنية “رجل المرحلة”، لا بوعي سياسي وطني حقيقي. وكما كان صدام ابن الدولة العميقة، فإن الجولاني يبدو اليوم كأحد تجليات الدولة الأمنية العابرة، حيث تحرّكه تقاطعات المصالح الدولية والإقليمية أكثر مما تحرّكه أي إرادة نابعة من الثورة أو مطالب السوريين الأصليين.
في ضوء ذلك، يصبح من المشروع التساؤل عن طبيعة الحكم في العالم العربي، وعن الكيفية التي يُعاد بها إنتاج الاستبداد. فبتتبّع المسار التاريخي، نلحظ أن الغالبية العظمى من الحكام العرب لم تُفرزهم صناديق انتخابية حقيقية، ولا حملتهم إرادة جماهيرية حرّة، بل جاؤوا إلى السلطة على ظهور الدبابات أو من خلال واجهات انتخابية مزوّرة صُمّمت لإضفاء شرعية زائفة على سلطة الأمر الواقع. إنهم أبناء تحالفات خفية ومعلنة مع قوى الهيمنة العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة والغرب، الذين لطالما فضّلوا “الاستقرار” على الديمقراطية، و”الحليف المطيع” على القائد المنتخب.
هذا النسق السلطوي لم يكن عرضياً أو نتاجاً لعطب محلي فحسب، بل كان حلقة في منظومة أوسع من الهيمنة وإعادة إنتاج التبعية. لقد أُريد للمنطقة أن تبقى رهينة لاستبداد مستدام، عبر ثلاثية قاتلة: تجهيل منهجي،وفقر مُمأسس، وتخويف دائم. فبهذه الأدوات، يُعاد تشكيل الوعي الجمعي ليقبل بالقهر، ويُختزل مفهوم الوطن في صورة الزعيم، وتُحوّل السياسة إلى طاعة عمياء، والمعارضة إلى خيانة.
وفي هذا السياق، لا يمثل الجولاني استثناءً من القاعدة، بل امتداداً لها. سلطته ليست تجسيداً لطموح وطني تحرّري، بل إعادة تدوير للاستبداد تحت راية جديدة. إننا أمام سلطة تلبس لبوس “الثورة” وهي تعمل على نقيضها؛ تنطق باسم “التحرير” وهي ترسّخ التجزئة؛ وتدّعي “التمثيل” وهي لا تعترف أصلاً بشرعية الاختلاف.
إن المأساة الحقيقية لا تكمن في وجود الديكتاتور فقط، بل في قبول الجماعة به، او صمتها عنه، او اكتفاءها بالتبديل دون تفكيك البنية. وما لم يتم القطع مع هذا النسق من الجذر – لا في الشخوص فحسب، بل في البنية الذهنية والسياسية والاجتماعية التي تُنتجه – فسيبقى الجولاني وصدام ومَن على شاكلتهما يظهرون بأسماء مختلفة، ويواصل التاريخ في هذه الرقعة من العالم تكرار نفسه بشكلٍ أكثر مأساوية في كل دورة.