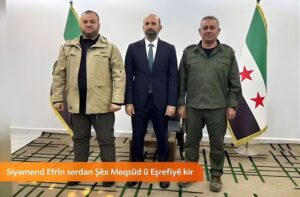إبراهيم اليوسف
عندما انطلقت الثورة السورية ربيع 2011، كانت الأحلام والآمال لا تزال تتأجج في مخيلات وصدور ونفوس السوريين، على امتداد خريطة سوريا المستحدثة من”عين ديوار” حتى” كويا”، إلا أن القلوب كانت متواددة متماسكة في أوج صورها. آنذاك، لم يكن أحد يتخيّل، رغم الفوضى، أن يتحوّل المشهد إلى صراع مزايدات في توصيف” الملأكَة” و”الشيطنة”، بل إلى سباق دموي في نزع الاعتراف أو صناعته. إذ سرعان ما بدأ العقل السوري- أو ما تبقّى منه بعد نيران الأجهزة- ينقسم لا إلى رؤى متعددة، بل إلى معسكرات تصنع رموزها وفق نفعية فاقعة، وتعيد تعريف” الملأكَة” و”الأبلسة” بحسب موقع الخصومة أو التحالف.
ولكل هذا فإننا نرى أن المفارقة لم تكن في الاصطفاف، بل في إعادة تشكيل الوقائع بمنطق الانتقام لا بمنطق الذاكرة. حيث جرت” ملأكة” الشيطان، لا بصفته خصمًا فعليًا، بل لأن خصمه الحقيقي بات عدوًا أكثر وضوحًا. وهكذا، في الضفة المقابلة، شُيطن من كان يُشار إليه سابقًا بكونه مدافعًا عن الأرض، فقط لأنه خالف خطابًا طارئًا أُريد له أن يكون أصلًا لا فرعًا. أجل، إن كثيراً من هذا الأنموذج من السوريين لا يغيّر رأيه لأن الحق تغيّر، بل لأن ميزان الحقد تبدّل، لأن كردياً بات يلوم بمطالبه خارج ما خططت له الثقافة العنصرية بحقه زوراً وتجنياً.
إنما الكارثة الكبرى لا تكمن في تبدّل المواقف الفردية، فهذه من طبائع البشر، بل في تحويل نوى هذا التبدل إلى أسّ عقيدة جديدة، تُبنى على تصفية الآخر سياسيًا، وتشويهه أخلاقيًا، ثم تقديمه للرأي العام بوصفه شيطانًا متلبسًا بثوبٍ وطني. حيث لم يعد يكفي لبعضهم أن يخالفك، بل عليه أن يسحب عنك آخر ملامح وخصائص من الإنسان، وليس المواطنة الحقيقية المطلوبة، لا مواطنة درجة ما بعد التصنيف بحسب المعايير المختلة المهيمنة والسائدة التي تجعل بعض أسراها يخرجون من أطوارهم أنى قال الكردي: وأنا أيضاً لي حقوقي، كما أراها!
تأسيسًا على ذلك، بات الخطاب السوري محكومًا بآلية تأثيم لا مراجعة. فإن كنت في الطرف المساند لفصيل عسكري، فأنت وطني مهما ارتكب، وإن كنت من المنتقدين لسلوكياته، فأنت إما خائن أو متآمر، وهذا ما ينطبق تمامًا على النظرة إلى “قسد” أو القوى السياسية الكردية عمومًا، إذ وُضعت جميعها في خانة واحدة، ثم وُزّعت عليها تهم واحدة، رغم الفروقات البنيوية والتاريخية بينها، إذ إنني أرى في قسد أقل من ارتكب الانتهاكات وأكثر من خدم سوريا، بمن فيهم من هم الآن بطانة السلطة جميعاً، رغم أنني من عداد أكثر ناقدي قسد ومن وراءه، وأرى فيه- تحديداً- نواة قوة وطنية سورية، كما أرى في الحركة التقليدية الكردية التي تأسست في العام 1957 وحدها ممثلة للشعب الكردي في سوريا، رافضاً أية تبعية لأي خارج كردستاني إلا ضمن إطار مد يد العون لا فرض قيود الوصاية والتنمر كما فعل ب ك ك تاريخياً.
من هنا فإنه لا يمكن الاستمرار في هذا النمط من التفكير دون تمزيق ما تبقّى من أي رابط جمعي سوري. حيث لا يُعقل أن تستمر بعض الأصوات في تصدير خطابات تحريضية ضد الكرد، وأن حركتهم السياسية الممتدة، والتي تمثّلت في قوى وأحزاب كردية وطنية، لم تُمنح من قبل دمشق- حتى الآن- أدنى مساحة في خطاب التمثيل أو التفاوض، لمجرد أن الطرف المدعوم دوليًا هو وحده من جرى تقديمه كالممثل الحصري للكرد، وهذا خطأ كبير. عندما يعتمد على-الخارج- لتشديد قبضة اليد والتجبر على الداخل، وهو ما مارسته الأنظمة السورية القوموية العنصرية منذ عهود الدكتاتوريات وإلى الآن، إلا أنه خيار هش لا يحمي مستقبل أي نظام، بل يجعله مجرد أداة يمكن التخلي عنها، كما حدث لبشار الأسد الذي سقطت غطرسته بمجرد التخلي الدولي الإقليمي عنه، كي تقدم قوى أخرى أنها محررة ومنتصرة ومقررة.
ولئن كانت قسد قوة عسكرية نشأت من مزيج كردي عربي سرياني آشوري، فإنّ اختزالها في البعد الكردي وحده، واتهامها بكل تهمة جاهزة في دفاتر الإيديولوجيا القوموية أو الطائفوية، يعبّر عن نية واضحة لتجييش الشارع السوري ضد أي استحقاق كردي، حتى لو كان دستوريًا وسلميًا. إذ ما يُراد ليس النقاش، بل ترسيخ أسس إبادة وتذويب الكردي كما تم تنفيذ ذلك منذ إقحام مصطلح- العربية- على اسم” الجمهورية السورية”، وتمت محاولة فرض تعريب كل شيء عبر آلة العنف والقمع من: بشر- وتبر- وحجر- وشجر!
إن أخطر ما في هذا السياق ليس مجرد الكذب أو التضخيم، بل اعتماد ما يمكن تسميته “شيطنة الملائكة”: أي رفض الاعتراف بأن هذه القوة، على ما فيها من ملاحظات ومآخذ لابد أن تخضع كما غيرها لمعبر: العدالة الانتقالية الشاملة. أجل الشاملة بما في ذلك السلطتين السابقة والحالية واللاحقة، فهي لم ترتكب المجازر بحق المكونات السورية، وقد واجهت داعش في لحظة تخلى فيها جميعهم عن السوريين، ثم قُدمت للعالم بوصفها المقاتل الأكثر جدية، في وقت كان فيه الآخرون ينهبون ويرتزقون ويبيعون المعابر، وها نرى عودة كثيرين من رموز داعش في إهاب آخر مفروض دولياً.، ضمن نواة السلطة الحالية، إلى الدرجة التي بتنا نجد أن من كان في الأمس يتهم تلك الفصائل بالارتزاق، عاد اليوم ليتغنّى بها، لا لأنها تغيّرت، بل لأنه بات يرى فيها أداة لعرقلة بل لكبح الكرد. وحتى من صنّفهم قاعديين أو جبهوين أو متطرفين، صار يراهم حلفاء، لا لأنهم اعتدلوا، بل لأنهم يتوسمون فيهم رفع الشعار المعادي للكرد، وتحديدًا ضد القوى التي رفضت الهيمنة التركية، وفرضت شراكة شديدة الكلفة في حربها على الإرهاب. وهكذا تنقلب السردية من ضحية إلى جلاد، ومن مقاوم إلى انفصالي، بمجرد أن يرفض الانحناء لأوامر الطرف الأقوى. حيث لم يعد المعيار هو ما تفعل، بل من تُغضب ومن تُرضي.
ومعروف أنه لمجرد أن الساحة السورية لم تعد مفتوحة لغير الأصوات التي تصرخ ولا تسمع، فقد أصبح النفاق معيارًا للبقاء، والإنكار وسيلة للإقناع، والتاريخ غدا ملفًا لا يقرؤه أحد إلا بحثًا عن إدانة مسبقة. أجل، إننا أمام مشهد باتت فيه الحقيقة تؤخذ من فم المحاور الأمني لا من الضحية، لا من فم ممثل الشعب، باتت تؤخذ من عقل المهزوم المأزوم وحتى المريض لا من وجدان المنكوب.
وإذ نعود إلى سؤال الكرد في هذا السياق، فإن التجاهل الممنهج لحركتهم السياسية ليس مجرد تفصيل إجرائي، بل تكريس لمنطق “الاختزال المقصود”. حيث أُقصي ممثلوهم في الحوار، وأُهمل تاريخهم، في مقابل رفع شأن من لم يحمل يومًا مشروعًا مدنيًا جامعًا. بل تم تجنبهم حتى من قبل المعارضة الرسمية- المستحدثة- الطارئة- التي تدّعي شمولية التمثيل، وتُسهم بذلك، عن وعي أو تبعية، في إقصاء مكوّن وطني أصيل، فقط لأنه لا يتطابق مع سرديتهم المتفق عليها مسبقًا.
من هنا نرى أن هذا التجاهل لا يمكن فصله عن الجذر العنصري المتغلغل في الخطاب السوري السائد، حالياً، سواء في لباسه القوموي أو الإسلاموي المتطيف.إذ تتقاطع عقلية البعث و النسخة العروبوية من الأخوان أوالفاشيات القوموية الطائفوية في نقطة واحدة: لا اعتراف بالكرد إلا بوصفهم تفصيلة ملحقة، لا أصلًا شريكًا.
وباعتبار أن هذا التواطؤ بات يشتد بل تستعرأوار فتنته، فإن كل محاولات الحوار تبدو- عيانياً- محض تمويه. فلا يمكن بناء عقد وطني جامع إذا انطلقت الحوارات من مبدأ: “أمنحك اعترافًا إن تخلّيت عن ذاتك”. وهذا هو ما يحوّل أي مفاوضات جارية بين القوى الكردية ودمشق، إلى محاولة إخضاع مقنّعة، لا مسعى نحو صياغة حل دستوري شامل.
فحتى لو تم التفاوض على حقوق جزئية، فإن انعدام الثقة بالنية السورية المركزية سيجعل أي تسوية عرجاء. إذ طالما لم يُعترف بالكرد كشعب، له ثقافته ولغته ومظلوميته التاريخية، فإن أي حل سيوضع على الطاولة لن يكون أكثر من رشوة سياسية مؤقتة.
وإنما الكرد، مثلهم مثل كل من حمل الثورة بصدق، ليسوا بحاجة إلى صكّ غفران من أحد. ما يطلبونه هو العدالة، ليس عدالة الخطابات، بل عدالة البناء الدستوري، الذي يُنهي الهيمنة، ويرسّخ مبدأ الشراكة لا الإلحاق. وهذا ما يجب أن تدركه النخب الثقافية والسياسية التي ما زالت تمارس ازدواجية لا أخلاقية في خطابها، ترفع شعار الوطنية حين يكون الخصم ضعيفًا، وتتحوّل- أي هذه النخب- إلى ناطقة حتى باسم المحتل حين تجد في ذلك فرصة لإقصاء مكوّن أو شيطنته.
ولذلك فإن المطلوب الآن ليس أن نُعيد تعريف الولاء والهوية، بل أن نُعيد تصحيح طريقة تصنيف الناس. فمن قاتل داعش لا يمكن أن يُقارن بمن بايعها. ومن دافع عن قريته لا يُوضع في خانة من أحرق القرى. ومن بنى إدارة، مهما كانت مؤقتة أو ناقصة، لا يُساوى بمن لا يجيد إلا بناء السجون.
من هنا، تماماً، فإن أي حديث عن سوريا المستقبل لا يمكن أن يُبنى على أكتاف الخطابات الانتقائية. إذ لا يمكن إصلاح ما جرى دون إقرار شامل بأن القضية الكردية هي جزء أصيل من القضية السورية، وأن تهميشها يعني تفريغ سوريا من أي أمل بالعدالة المرجوة أو المنشودة التي حلمنا وسعينا جميعاً لأجل تحقيقها!؟
وهكذا، فإن الخروج من دوامة “ملأكة الشيطان وشيطنة الملائكة” يتطلب أولًا الاعتراف بأن الكرد ليسوا ظلًّا لأحد، ولا شوكةً في خاصرة أحد، بل ركنٌ أساسيٌ في مشروع وطني حقيقي، لا يبدأ من محاور السيطرة بل من جسد المأساة المشتركة.