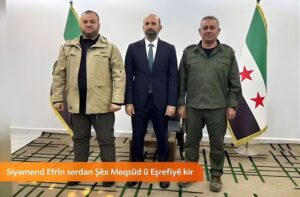إبراهيم محمود
وتابعتُ هذا الصباح ” الرباح الاستثنائي ، وبعد مخاض مزمن، بعين اليقين، ويقين فرح غامر داخلي، كل ثانية رافقت حركة إسقاط تمثال المعبود الوهمي ابن المعبود الوهمي باسل حافظ الأسد في مدخل مدينة قامشلو اليوم صباحاً ” 8-12-2024 ”
إسقاط تمثال كهذا، كما شاهدت كيفية إسقاط تمثال الطاغية أخيه في دمشق وفي أكثر من مكان، وفي ساحة لها دلالتها ” ساحة الأمويين ” إزاء مكتبة لها دلالتها الاسمية ” مكتبة الأسد ” ولا أدري أي اسم ينتظرها، مثلما الحال مع آلاف مؤلفة من الأمكنة والمواقع التي جرى تحميلها باسم المتصوَّر ” خالداً إلى الأبد ” وهو حكْم الزمان النافد في أهليه دون استثناء.
تابعت كل حركة، مرفقة بذلك الهياج النفسي، المكبوت النفسي الجماعي المحيط بذلك الذي كان عنواناً لمدينة تتكلم الكردية أكثر من العربية، وتدين لها الجغرافيا نسَباً أكثر من أسلاف أحفاد عياض بن غنم وسواه، حيث تسبقه اللوحة الكبيرة التي تبرز صورة أخيه ” بشار ” مقابل مطار قامشلو، كما لو أن التحليق إلى السماء مرفق به، مثلما أن الفروسية، ودلالتها التاريخية والاعتبارية والحيازية ، قارّة في أصل هذا التمثال، وما كان لذلك الهياج بصوته الذي تعجز اللغة عن وصفه، من إشهار للحظة انعطافية في التاريخ، وفي أساس الجغرافيا، وكيفية زحزحة التمثال( باسل بانتصابه على صهوة الفرس/ الحصان ، بخيلاء الإعلام الموقَّر) وترنحه وسقوطه في الطرف المقابل لنزلة المطار، كما لو أن الذين أسقطوه أرادوا إشعار كل قادم من جهة الجنوب، في الحال، برؤية ما يجب رؤيته، وما يترتب على هذا السقوط المدوي من بعد جماهيري، حيث الشعب هو الأول والآخر والأخير في النهاية، والقتال المستمر ضد الظلم بكل أشكاله قائم:
نيرون مات ولم تزل روما بعينيها تقاتلْ
وتابعت كغيري وعبر مشاهد حية، ومن خلال وسائط كثيرة، ما تفعله قوة التاريخ المباغتة، وجلاء أمرها فيمن يوقفه أو يلجمه، ليكون اجتثاث أصوله” باسمنته أو خرسانته المسلَّحة، وقبعته، ومحيطه الدائري، ما يذكر بـ( وعلى الباغي تدور الدوائر ).
تابعت فرِحاً، كما يستحق الفرح، بكامل التركيز النفسي، كما تستحق لحظة تاريخية صباحية في التوقيت كهذه من اعتبار ومن تنفّس الصعداء، وحول التمثال من كانوا قبل ظهوره صنماً مفروضاً، وما صيَّره أثراً يمحى هكذا، ومن يستحقون الاستمرار في التاريخ، وأظنهم في الغالب كرداً. ولا أدري هل كان هناك حضور عربي، قبل كل شيء، لأنهم معنيون بنسبه، بلغته المعتبَرة والمحروسة، وعقيدته المحروسة ، حضور له دلالته، تأكيداً على أنهم ضد الظلم، وأن الظلم كان يعني الجميع، وليكونوا أقدر على تقبّل الآتي والاستعداد لبناء مجتمع آخر، مدينة تحتضن الجميع عرباً وكرداً وسرياناً وأرمناً، وبمختلف الأديان الموجودة؟ أم تراهم، في قرارة أنفسهم، وهما يتابعون ما يجري، وفي نفوسهم قهر من نوع آخر، قهر يسميهم، كما كان يجلوهم في مأثرة مزعومة لـ” أمة عربية واحدة- ذات رسالة خالدة ” أي ما يجعلها خارج التاريخ الأرضي، وحسابات المتحول في الزمان والمكان؟أم أنهم أدركوا أو سيدركون أن الذي جرى ويجري أكثر من كونه حدثاً تاريخياً مجيداً، حدثاً تسونامياً، وأكثر، لأنه يفجر ما في الداخل، ويضع ذاكرة المقورين وعلى امتداد عقود من الزمن، في مواجهة تاريخ البطاشين، القاهرين، المتحلقين حول مخلَّد لا يخلَّد، وهم سكارى شعارات ألبستهم ويلات؟
أسقط التمثال الموسوم، وتحرر الحصان نفسه، من ثقل المحمَّل به، طليقاً، ربما، شاعراً براحة في الهواء الطلق.
لعل في ذلك ما أشعرَ قامشلو بدخولها لعتبة عهد جديد، وما ينبّه من يرون التاريخ من زاوية واحدة، أن ليس من تمثال من هذا القبيل أو الفصيل أو الدخيل التاريخي ، مهما كان تمثيله انتماءاً جنسياً أو اثنياً أو لغوياً، وهو بطغيانه بباق.
وأنا من دهوك العزيزة أردد وأنا أيمم شطرك بلهفة محب لمحب، كما تستحق اللحظة المكثفة:
صباح الخير يا قامشلو
صباح الفرح الواعد أكثر يا أهل قامشلو بكل لغاتكم، أديانكم، ثقافاتكم، طالما أن قامشلو تزداد جمالاً وإشراقة روحية بها.
كل صباح وأنتم على وعد بآت يضمكم إليه وملء نفوسكم توق إلى الأجمل، الأصلح والأفضل إنسانياً..