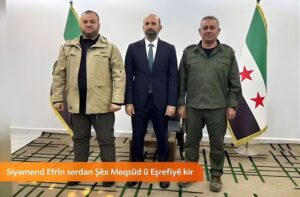إبراهيم محمود
شاهدتُ في مقطع فيديو، كيف أن طفلين بحدود العشر سنوات عمراً، يبولان” يشخان ” على تمثال نصفي لحافظ الأسد وفي مشهد آخر، لرجل ملقب بـ ” أبو طه ” وربما تكرر ذلك في أمكنة كثيرة أخرى في سوريا، حيث ذكَّرني ذلك بالذي كان يضرب بـ شحاطته ” على صورة للطاغية صدام حسين، بعد إسقاط نظامه .
تلك هي نهاية متوقعة ولماحة، مهما كان الزمان أو قصر، لكل مستبد. إذ يشترك كل من البول والصندل أو الشحاطة بقاسم مشترك، مرئي، وهما يفصحان عن ذلك الكبت أو القهر المتراكم في النفس، وإلى أي درك حل فيه صاحب الصورة أو التمثال المتداعي من جهة القيمة، أو الاحتقار، أي ما يعرَف بـ” مزبلة التاريخ “.
من يمكنه التنكر لحكمة التاريخ وحكمته، لانتقامه، ممن يكتبونه بإشراف أو ضغط وغيرهما، تعظيماً لما يجعل مما يوهم بوقف التاريخ في نطاق الجاري تعظيمه؟
إن نظرة سريعة إلى تاريخ المنطقة، ومصير طغاتها منذ آلاف السنين، تظهر الصورة المقيتة والمخزية، كما يستحقونها لهم. ليس من ناج بفعله من انتقام التاريخ، فالتاريخ هذا الذي يُسحب من ” ذيله ” ليكون صوت الطاغية وكل مستبد، صورته، رائحته، ظله، كلامه، صحوه ونومه، قيامه وقعوده، تعليماته…إلخ، هو نفسه الراكل له في وقت معلوم.
غريب أمر هؤلاء الذين يكررون ما هو تاريخي بالصوت والصورة، ولا يتعظون. فالشخاخ، كما هو المتداول عامياً، ما يجري التخلص منه، باعتباره مضراً بالجسم إن جرى حبسه فيه، أو عدم التخلص منه، ليكون ممرّراً لذلك القهر النفسي، ومفيداً لصاحبه، وهو يراه في خيطيته، أو تناثره على التمثال أو الصورة التي كان يجري حملها أو حراستها وعبادتها.
هكذا الحال مع الشحاطة، باسمها العامي كذلك، وهي بتلك القيمة المستهلكة، أداة انتقام، وتمريراً لقهر تاريخي مماثل، وإشعاراً بالنهاية المهينة والاحتقارية للمتبوَّل عليه، أو الجاري ضربه شحاطياً.
مفارقة، يبدو أنها نافذة في الزمان والمكان، وفي منطقتنا كثيراً، جهة هؤلاء الذين لم يدخروا ولا يدخرون جهداً في توجيه شعوبهم بـ” الصرماية ” وها هم يجري دوسهم بالصرماية.
في فقرة للشاعر والذي اعتقل في سجن النظام نظام حافظ الأسد، فرج بيرقدار، قرأت ما هو مرعب، حيث تمضي بهم حافلة محروسة من سجن صيدنايا إلى سجن تدمر، إن لم تخني الذاكرة، من خلال شتائم أحد سفلة النظام في الحافلة، وبعد شتائم عدة:
ولِك بولو ينشرب .. خريتو تتاكل !
وها هو ومن جاء في أثره معروض تحت الشخاخ والرجم بالخرية … يا لحكمة التاريخ مجدداً.