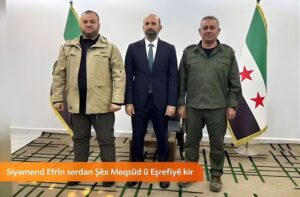إبراهيـم محمود
إبراهيـم محمودتلك هي المقولة التي يمكن للمرء أن يخلص إليها، لحظة متابعة مسلسل عنف النظام السوري ضد شعبه، بما في ذلك الذين استمالهم شخصياً إليه، لأن اعتبار الآخر أداة عنف أو في موقع المدافع المستميت عنه بدعوى أحقيته، لا يقل شراسة وعسفاً عن اعتبار المرئي في موقف المعارضة لجبروت النظام وأحاديته في قبضته الأمنية.
ولأول مرة، يمكن للمتابع أن يتأكد من الديمقراطية المحققة من قبل النظام، في عدم التفريق بين مدينة وأخرى، بين قرية وأخرى، وبالتسلسل، كما هو الملسوع من قفاه، بجعلها مرتعاً للخراب والموت وصراخ الأرض!
إن تحويل بلد كامل براً وجواً وبحراً، بليله ونهاره إلى جبهة عملية كاملة ومعاداة الآخرين: الشعب عموماً، ليس أكثر- بالمقابل- من إعلان حالة التعبئة الكاملة ضد عدو شغلَ الداخل وتوقف العمل بالخارج، فلا يعود الحديث ممكناً هنا عن حدود فاصلة بين العدو والصديق ومنطقة حيادية أو عازلة، وإنما عن تحويل البلاد والعباد إلى مزرعة لعنف النظام.
الملاذ الآمن الوحيد هو أن تعلن وقوفك إلى جانب النظام، وهذا لا ينفع في الواقع، لأن من السهل تعرضك للقتل لحظة الدفع بك إلى الأمام وجعلك متراساً أو كبش فداء وأنت مرغَم على الدفاع عن رموزه، بدءاً بـ(القائد التاريخي)، وهو بالكاد يُرى، وانتهاء بكل من يمثّله ضمن حدود معينة، إذ يستحيل في الحالة هذه أن يدّعي أي منهم أنه مقرَّب من النظام وفي مأمن، عندما تكون الفرصة مواتية لإطلاق النار عليه فجأة، واتهام آخرين في الخارج، والخارج هو الداخل في الغالب كما تقدم، انطلاقاً من مبدأ وحيد أوحد هذه المرة: إن نظاماً لم يجد سوى صورته في مرآته التاريخية، ولم يسمح على مدى عشرات السنين إلا بأن يُهتف باسم رمزه التاريخي، من السهل الاستنتاج بأن الجميع في عداد قرابينه البشرية، وإلا فكيف يكون تفسير: الله، سورية، بشار وبس؟!
إنها ديننة المجتمع باسم نظام لا يؤمن إلا بأبديته وهي زائلة، وإيمنته حيث إيمانه الوحيد هو سهولة مزج الماء بالدماء والشعور بنشوة النيل من الثائرين أو المعارضين.
شعار يراد منه إسناد كل حركة تاريخ إلى المعتبر مالك المصائر، وباسمه تدار المصائر، عبر جماهير غيبية مجردة من أرواحها الحرة، أكثر مما لو قورنت بالذين يتحدثون عن” الحنبلية” أو التشدد في التحكم بعقول الناس واحتكار إراداتهم، في راهن يبز كل ما عداه، ومن خلال النتيجة المريعة: الله المصمت في عليائه- طبعاً- وسوريا المكان المفرَّغ من أهليه الأحياء فعلاً، والقائد التاريخي نظير وحده، وحده في هذه البلاد، ودونه لا أحد، أو حين يحوَّل الشعار إلى شعار آخر، أو يُجتهد في تركيبة شعارات أخرى مع الصورة (أشير هنا إلى لوحة” مستطيل شاهق بطول عدة أمتار، بالكاد يذكر عرضه البائس مع طوله النفَّاث” سبعةأمتار”، حيث الاتجاه ميمَّم شطر العاصمة أو مسقط الرأس، والظهر موال ٍ إلى المدينة في الأسفل بعمق المعنى”، لوحة منصوبة أمام مدخل مدينة قامشلي، وفي موقع له دلالته القصوى، دلالة تبث الخوف في الاختيار، على الطريق الدولي الداخل إلى المدينة، مقابل المطار، وتحت أعين الشرطة العسكرية، حيث صورة الرئيس بكامل طولها، ويده اليمنى تحوم في فضاء لا أحد فيه، يمثل الشعب المضمر، وابتسامة لافتة تعني المبتسم ولا أحد سواه،، لوحة موجَّهة إلى الخارج، ولمن هو قادم إلى المدينة، وفي الوسط مباشرة، ثمة عبارة مكتوبة ليقرأها الداخل: ” الله ، سوريا، شعبي وبس” بما يشبه الزنار، وهي ترجمة بتصرف للشعار السالف الذكر، وما يشبه شد الحزام في وضع إسعافي، ومن قبل ما يسمى بـ” مجلس مدينة القامشلي” ، سعياً إلى حيازة من يحاول التفكير مختلفاً، ويروم مختلفاً ويعيش اختلافاً ملهِماً، ولعلها لا تخفي سرعة توليفها تناسباً مع التحديات، أي بقصد الاستهلاك المعنوي، لهذا كانت تقابل منطقة الهضم: المعدة في الجسم مباشرة، دون معاينة للبعد الجمالي: الفني، إذ الشعب يكون في حكم الغائب، وهو مغيب بالجملة تبعاً لحركية الصورة، تلك التي تستنسخ وتوزع وتركَّب هنا وهناك، مع نسيان معادلة قوية بتأثيرها النفسي، وهي أن الإكثار من الصور يعادل المزيد من الكلام، وإفقاده كل قيمة منشودة كما يعني تجاهل الآخر، وحتى نسيان مكانة المصوَّر بدقة.)!
هذا المشهد الدامي جغرافياً وتاريخياً، يزداد مأسوياً على مر الأيام، ويظهِر ما كان خفياً، إذ لا يعود كل ما له أي صلة بالشعب والحرية والكرامة إلا في باب ما لا يُلزَم.
إن توقيت ساعة النظام على هوى رغباته، يعني الإطاحة بملايين الشعب المؤلفة، يستوي في ذلك العربي والسرياني والأرمني والكردي والجركسي، ويبقى التنويع تعبيراً عن نهَم النظام إلى افتراس المحيطين به، أو لعله بتنويع الشعب اثنياً يعادل تنوعَ وجبات فاتحة لشهية الموت والقتل وقد تنامت وتيرة وحام الافتراس! إنها قيامة نظام فاقد لرشده، حيث لم يكن له رشد فيما مضى، كمرجعية قانونية أو دستورية، كما تقول ممارساته في وضح النهار، وفي مرأى من العالم أجمع، وإلا فكيف يمكن تفسير شعب ينادي بكرامته وحريته، ويقابل بالرصاص والقتل والزج بالمعتقلات، وتنامي وِحام التمثيل بالضحايا.
النظام يريد إسقاط الشعب! تلك هي الحقيقة التي تزداد نصاعة عبر وطأة الأيام المثقلة بصراخ قرابينه المؤلَّفة.
وربما كان الأدق هو: النظام يريد تركيع الشعب، لأن مفهوم” الاسقاط” حدث منذ زمن طويل، وهو إسقاط طال المعنى والمبنى وفق ذرائع مقننة، أما التركيع فهو في درس” الشبيحة” الخفي، والذي لا يُعترَف بهم، وهم بمثابة الزبانية الذين يكونون فوق التصوير والتعبير، كما لو أنهم منزلون لإنقاذ نظام يتحدى تاريخه الشخصي، ويعيد عبارة (الله، سوريا، بشار وبس) إلى حقيقتها، حينها لا تعود الشبيحة موجودة، إنما أشباح الضحايا والخرائب.
وفي الحالة هذه يكون في مثابة المطلب الملحّ، ومن قبل القانونيين والحقوقيين وكل من له صلة بالسياسة والاقتصاد واللغة، النظر جلياً في كل شعار يتردد في الجمهورية الخاوية على عروشها، أو جملة تعريف بقوى معينة تستهدف الحرص على سلامة الوطن المزعوم والشعب المزعوم، من نوع (الشرطة العسكرية عين الشعب الساهرة)، وقد أفقئت هذه العين، والأمن الذي صار مشكلة النظام وإرثه البغيض، فرؤية الأمني تعني الإهانة أو الاعتقال أو القتل أو تحويله هو نفسه إلى ضحية عند اللزوم الممسرح من قبل المتقدم عليه، من قبل أحد الشبيحيين، ليكون الشعب في العموم البضاعة الأكثر موصوفية بالمهرب والمستحق العقاب الأقصى، وهنا تكون ” الجمارك” من نوع معارِك آخر: أي كل من له صلة بمفهوم” الانضباط” الحدودي أو الداخلي..
إن رؤية الآليات العسكرية في الشوارع، سوف يكون من مآثرها التمهيد لولادة أطفال من نوع آخر، عبر أمهات يتوحمن على رؤية آلة العنف، أطفال هم أجنَّة تنتظر الولادة، يكونون مميزين بصفات أخرى، أو مجردين منها، وهو خيار يقع على كاهل النظام وحده، مسئولية ما يجري، طالما أن كل شيء مرتجع إليه، ومدفوعة فاتورته من عرق الفقراء وخفقان قلوب الأغنياء، إذ الجميع مستهدفون وقد صرخوا ضداً على هذا العنف الدامي، وهي المرة الأولى التي يتوحد فيها الجميع، رغم صنوف التفريق بين عامة الشعب، ليكون النظام نقيض اسمه و”بس”..