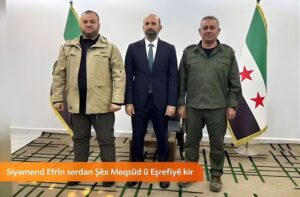أحمد اسماعيل اسماعيل
أحمد اسماعيل اسماعيل
كثيراً ما يتغنى الحاكم العربي بديمقراطيته الخاصة التي لم ينقلها عن أحد،أو عن ديمقراطية الآخرين التي يدعي أنها ليست سوى حصان طروادة آخر، يراد بها غزو البلاد ، بينما ديمقراطيته المصنعة محلياً، ستفتح للوطن والمواطنين أبواب الخير والازدهار والكرامة ،وقد أخذ هذا الحاكم ، ومنذ رحيل الاستعمار، ينقش ديمقراطيته هذه على ظهر المواطن بأحرف من نار.
إذا كان آكل الطعام لا طاهيه هو خير من يحكم على المأدبة ، حسب أرسطو،فإن الحاكم العربي ظل دائماً حريصاً على بقاء حالة التخمة لدى محكومه، وهي تخمة من نوع خاص ، لا تصيب إلا الجائع للحرية ، وهو جوع يُخلف لدى صاحبه أحاسيس الخوف والقلق التي تلازمه أينما حلَّ :في البيت والمدرسة ومكان العمل… وليس انتهاءً بمكان معين تحت سماء الوطن التي غرسها الحاكم
بعيونه (البصاصة).
والمحكوم العربي في سعيه لتأمين معاشه، أو ممارسة دوره في الحياة ، لا يطالب بقوة عمله أو مؤهلاته العلمية، أو ما يمتلك من مواهب وقدرات، فما يحصل عليه المحكوم مقابل ما يقدمه من خدمات في هذا المجال ، أو ذاك، ليس ثمناً لأتعابه، أو تقديراً لما يمتلكه من مواهب ومؤهلات علمية وغير علمية موظفة، بل هو هبة ومنحة من لدن الحاكم، هذا السيد الذي اختزل كل شيء في شخصه: القوانين والمؤسسات والحقوق والوطن، مستعيناً في تحقيق ذلك بحراس قمقم سلطته، الذين استطاعوا بما منحوا من صلاحيات مطلقة في تعاملهم مع المحكوم، صياغة شخصية هذا الكائن بما يناسب بنية وطبيعة سلطة الحاكم المطلقة، الأمر الذي أنتج مواطناً ذا شخصية قدرية، مقموعة، مشوهة، تعيد إنتاج القمع الذي تغلغل في أعماقها بشكل آلي ويومي،وبما يشبه نمط المعيشة السائد في كل خلية من خلايا المجتمع الذي كرس روح الخنوع والامتثال،وقمع روح النقد ،والإبداع ،والمسؤولية،والتي بقدر ما يحتاج علاجها ، أو إلغاء أسباب قيامها ، إلى ممارسة الحرية ، بقدر ما يشكل وجودها، أو دوام بقائها، عائقاً جدياً أمام سبل نشر وتحقيق أي نوع من أنواع الحريات العامة ، أو الخاصة، وذلك لتعارضها مع شروط قيام و تواجد أي شكل من أشكال الديمقراطية، كالعلمانية التي تحرر الفرد من نزعات قداسة النصوص والأفكار والأشخاص ، إضافة إلى العصبيات بمختلف أشكالها، ولقد استطاعت الدكتاتورية بما غرسته من افرازاتها المرضية تلك، في وعي المحكوم العربي، أن تشوه مفهوم الديمقراطية وصورة دعاتها لدى المحكوم والشارع العربي زمناً طويلاً، وما يزال هذا التشويه مستمراً لدى شرائح وقطاعات واسعة: الجاهلة وغير المسيسة، والمتعلمة المسيسة سلطوياً على حدًّ سواء، والتي ترى في الديمقراطية شر كبير، وغير أخلاقي، وحصان طروادة تقوده، وتروج له، حفنة من المخدوعين وأتباع الأجنبي.غير أن ثورة المعلومات التي أخذت الجميع على حين غرة، وخاصة الحاكم العربي المطمئن إلى نتائج غرسه، قد كشفت الغطاء عن ديمقراطيته البديلة، المعلبة، المصنعة هنا ..
والآن .
-الديمقراطية والحاكم العربي :
سئل ماركيز مرة: ما نوع الديمقراطية في بلد البطريرك ؟ فأجاب: في بلد البطريرك لا توجد ديمقراطية.
إذا كان لويس الرابع عشر قد قال يوماً : أنا الدولة. فإن الحاكم العربي الذي افترس الدولة، سيزيد عليه بقوله : أنا أبو الشعب، ومثل رب أي أسرة بدوية، يدير شؤون بيته، وأحوال أفراد عائلته بتصرف، وبلا منازع ، كذلك سيفعل أبو ورب الشعب، وسيعتبر أية مشاركة له في إدارة شؤون هؤلاء العيال والرعايا بمثابة الشرك ، لا الشراكة.
هذه النزعة، أو الجينات القبلية ما تزال تفعل فعلها في شخصية الحاكم العربي ، وعياً ونفسية وسلوكيات ، وذلك على الرغم من كل مظاهر التحضر التي أحاط بها نفسه، وهي برمتها مظاهر استهلاكية ومستوردة، يزين بها سلطته التي يحرسها جيش من أزلام وقوى وعناصر طارئة ومحدثة تنتشر في كل مفاصل الدولة، ولقد استطاع هذا السيد أن يركب موجة كل تيار يسود في حينه ، وأن يميعه بالإكثار من رفع شعاراته؛ قومياً كان هذا التيار، أم اشتراكياً ، أم إسلامياً ، أو يركبها كلها معاً،دون أن يغير ما في نفسه ،أو من ممارساته ، أو أحكامه.
مستفيداً في ذلك من قابلية هذه التيارات، والأيديولوجيات ، للتفسيرات المتعددة ومن انشغالها بصراعات كبيرة ، بعيدة عنه، ولا تمس سلطته، ومن عدم وعي الشعب المقهور بطبيعتها الحقيقية.
واليوم، ومع نهوض الديمقراطية، وانتشار مفاهيمها بشكل سريع وواسع، لم يلجأ هذا السيد الفهلوي إلى حيلته السابقة في ركوب الموجة، وقيادتها إلى نهايتها، برفع شعاراتها وممارسة ما يناقضها، ليس عن إحساس بالذنب، أو عن خجل ،بل عن عجز في مجاراة هذا التيار الواضح، والمحدد، والذي يمس سلطته المطلقة مباشرة، وبالدرجة الأساس.
الأمر الذي دفعه إلى الجهر بمعاداتها ، والإعلان عن ديمقراطيته البديلة، المناسبة للزمن والمكان العربيين.
غافلاً، أو متغافلاً ، عما يحدث للزمن والمكان، والناس، في عصر ثورة المعلومات هذا ، ويتلخص جوهر ديمقراطيته في عدم الشرك به، أو أي نوع من أنواع المشاركة الشعبية الحقيقية، التي يمكن أن تحدد بعض سلطاته المطلقة، ناهيك عن رفضه المطلق لمبدأ تداول السلطة ، وسيادة الشعب، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، والمساواة أمام القانون… وغيرها من أصول الديمقراطية المناهضة لديمقراطيته البديلة ، التي هيأ لها طوال سني حكمه والقائمة على سياسة القهر والإفساد وانتهاكات حقوق الإنسان..
الضمانة الأكيدة لقبولها، ودوام استمرارها، الأمر الذي أدى إلى انتكاسات خطيرة في جسد الوطن وروح ووعي المواطن، وذلك بعد استنزافه لقدرات وثروات الوطن،وهدره لإمكانيات المواطن وتدمير مواهبه الفردية بحكم تسلطي مستبد.تحت يافطة ديمقراطيته الأصيلة، وغير المستوردة.
–عود على بدء:
لم تدم فرحة المحكوم العربي برحيل الاستعمار ونهوض بعض المشاريع الوطنية، والتقدمية في العديد من البلدان العربية خاصة، فسرعان ما انهارت بعض هذه المشاريع، وأُفرغ بعضها الآخر من محتواه، وذلك عشية نكسة حزيران سنة 1967، والسبب الرئيس في ذلك لا يعود إلى الاستعمار الذي عاد من الشباك ، بعد أن خرج من الباب،حسب تشخيص الحاكم ومواليه، بل يعود إلى عدم تسوير هذه الأنظمة لمشاريعها بسور الديمقراطية، والتي قامت بتهميشها، وتأجيلها، بحجة انشغالها بتسوير الوطن بالجيوش لمواجهة عدو متربص.
غير أن هذا السور لم يستطع الصمود دائماً لكثرة الثغرات التي أحدثتها فيه سياسات القمع والفساد، وفي المجتمع الذي ينتمي إليه ويدافع عنه هذا الجيش ، والذي لم يستطع بما يعانيه من تهميش، وقهر، وتخدير ، أن يدافع عن المشاريع الوطنية التي راحت القوى الطفيلية، والبيروقراطية، التي تعملقت، وتوحشت في مناخ الاستبداد، تفرغ هذه المشاريع والإنجازات من محتواها ، وتلتهمها بشراهة.
وبدل مراجعة أسباب الخراب الذي أصاب جميع مناحي الحياة داخل الوطن، ومعالجتها من قبل الحاكم المعالجة المناسبة له،وللوطن الذي يحكمه، لجأ إلى أساليب المناورة، والقمع ، والكذب ، وبيع الأحلام وافتعال الأزمات، الخارجية والداخلية ، كما لجأ إلى تحصين نفسه من الشعب، بتعيين الأقارب والمتسلقين والطفيليين في مراكز الدولة الحساسة، وذلك بعد أن استطاع أن يضمن ولاء بعض الأحزاب التقدمية، خاصة، بقليل من المغانم التي سرقها من قوت الشعب والمناصب التي انتزعها من سيادته، مكتفية -هذه الأحزاب- ببعض الهمس ، والغمز من قناة الحاكم في بعض الأوساط الشعبية حفاظاً على ماء الوجه، أو على وهم الاستقلالية التي تتغنى بها دائماً .
صفير قطار التاريخ:
لا شك أن سياسة القهر والاستبداد التي يمارسها الحاكم العربي شكلت على مدى عقود طويلة المعوق الوحيد أمام تطور وتقدم الوطن، بل وتحرره من أشكال الهيمنة الخارجية، التي يدعي الحاكم العربي التصدي لها، وذلك يفعل ممارسته لسياسة تشيؤ المواطن، وحبس طاقاته الخلاقة وشعوره الوطني بالانتماء متجاهلاً بديهية إنسانية ومدنية يكررها التاريخ في كل زمان ومكان، والتي صاغها المفكر الفرنسي فولتير على شكل حكمة تقول: (لا وجود لوطن حر إلا بمواطنين أحرار) فالديمقراطية أو ممارسة الحرية، ليست مفهوماً سياسياً غربياً أو غير غربي، بل مفهوماً حياتياً جوهره المساواة: القيمة الإنسانية والكونية التي تمنح الإنسان فرصة تحقيق ذاته الإنسانية على كافة الأصعدة، بعد أن تكون قد مهدت له الظرف المناسب ، والصحي لإبراز مواهبه، وتفجير طاقاته، والتي سيوظفها الوطن في خدمته، لتحقيق ازدهاره وزيادة رفعته،ومنعته.
فهي وسيلة وغاية في الوقت نفسه.
أشبه بفن قيادة السيارة التي لا يمكن تعلمها إلا بقيادة السيارة .
ولكن ها هو الجيل الجديد ، الجيل غير المقنن والمقولب في أطر التحزبية والإيديولوجيات التي اهترأت قد أخذ مكانها خلف مقود حركة التاريخ بعد أن عجزت الأجيال السابقة عن قيادته أو حتى زحزحته من مكانه بسبب العطب الذي كان قد أصابها وشل قدرتها فاقتنعت بأن ما يحدث هو نهاية التاريخ، المقولة التي حاربتها فكرياً وخارجياً، ومارستها عملياً داخل أوطانها، غير أن ما يحدث لا يمكن أن يكون نهاية التاريخ، كما أكد المسرحي راحل سعد الله ونوس، فها هو القطار يطلق صفيره في كل الشوارع العربية ، ولاشك أنه سيغادر المحطة| الكابوس التي طال وقوفه فيها طويلاً، تاركاً على أرصفتها كل من أبتلي بداء النقرس والشلل والعطب التاريخي والحياتي.