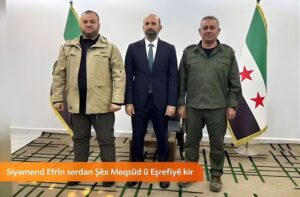روني علي
هي الحيرة بعينها، حين نقف معقودي اللسان أمام أسئلة من نسميهم في قواميسنا ومصطلحاتنا بـ (البسطاء)، وهي تضرب على الوتر الحساس، وتستند إلى بديهيات تفرضها حقائق الأمور، حين تتناول الشأن الحزبي الكردي وأداء “نخبه القائدة” تجاه استحقاقات القضية الكردية، انطلاقاً من براءة أصحابها من لوثة السياسة وعدم الخبرة بالنفاق والتملق، لكونهم أصحاب ضمائر حية في تناولهم للهموم والقضايا العامة، بعيداً عن الأنانيات والمصالح الذاتية، في واقعنا الذي أضحى فيه كل شيء عرضة للاستهلاك، كما القيم التي تنهار أمام معاناة المرء في مواجهة احتياجات العيش وسطوة آلة القسر، تلكم التي تعمل على وضعه فوق “سرير بروكوست”، وتحويله إلى مجرد آلة لا حول له ولا قوة
هي الحيرة بعينها، حين نقف معقودي اللسان أمام أسئلة من نسميهم في قواميسنا ومصطلحاتنا بـ (البسطاء)، وهي تضرب على الوتر الحساس، وتستند إلى بديهيات تفرضها حقائق الأمور، حين تتناول الشأن الحزبي الكردي وأداء “نخبه القائدة” تجاه استحقاقات القضية الكردية، انطلاقاً من براءة أصحابها من لوثة السياسة وعدم الخبرة بالنفاق والتملق، لكونهم أصحاب ضمائر حية في تناولهم للهموم والقضايا العامة، بعيداً عن الأنانيات والمصالح الذاتية، في واقعنا الذي أضحى فيه كل شيء عرضة للاستهلاك، كما القيم التي تنهار أمام معاناة المرء في مواجهة احتياجات العيش وسطوة آلة القسر، تلكم التي تعمل على وضعه فوق “سرير بروكوست”، وتحويله إلى مجرد آلة لا حول له ولا قوة
بعد أن تم إفراغ المجتمع من إمكانات البناء وطاقات المشاركة في رسم مستقبل البلاد، بحكم أن كلمة “لا” قد أزيلت من قاموس المفردات المتداولة بين كل من يحاول النطق بها، خاصةً إذا ما تعلقت بممارسات النظام وسياساته، أو كانت لها صلتها بنزعات أولي الأمر والقرار، المشتغلين بادعاءاتهم من أجل الاستنهاض بقيم الحرية والديمقراطية.
ولعل السبب الكامن وراء عدم امتلاكنا للأجوبة، أو رغبتنا بعدم التصدي لها، وإن كنا نلامسها – أحياناً – بصيغة المواربة، يعود بالدرجة الأولى إلى إشكالية “الناظم” الذي يضبط قوانين الفعل في الوسط الحزبي، ذاك المتداخل مع “الناظم الأساس”، المحدد لحركة المجتمع السوري وقواه السياسية.
كون الإحاطة به أو إماطة اللثام عنه، بصيغة التجرد والمكاشفة، يضعنا أمام إشكاليات، كنا قد قطعنا على أنفسنا – ومنذ فترة – ألا نقترب من تخومها، وبالتالي ألا نتناول الوضع الحزبي الكردي، بشؤونه وشجونه، من خلال الكتابة، أو على الأقل، بشيء من الشفافية، وذلك لأسباب قد نأتي عليها، حينما نصل إلى تلك القناعة، أن للكلمة باتت فعلها في الوسط الحزبي، وقد أصبحت سلاحاً في التغيير وأداةً للحوار، بعيداً عن الارتهان في أحضان الثقافة “التابعوية” أو الانزواء خلف التعبيرات الساكنة التي نسميها – تجنياً – جزءاً من معادلة التغيير، حتى لا نكون أمام طحن بلا طحين، أو ننفخ في أزمات هي من وزن الانقلابات، ونثيرها في واقع لم نمتلك بعد مفاتيح التعامل مع استحقاقاته، وإن كنا ندرك أن في ذلك نوع من النكوص، أو البقاء ضمن القمقم، وفي أجواء من اللا حراك.
لأنه ببساطة، ومع امتدادات التشكيلة الحزبية القائمة بشخوصها المفروضين كـ “أمر واقع”، وطاقمها المتحكم بكرسي القيادة، وفق قران كاثوليكي، والممتلك لأدوات الدفاع عن ذاته وبقائه في سدة “الحكم” عبر منهجية متحكمة ومستحكمة، بفعل جملة من الشروط والمقومات والضوابط، وجعلت من عملية الخروج عليها دخولاً إلى مزيد من نثر “غبار الطلع” في مناخ الشقاقات والتشققات، كان لا بد أن نستكين إلى الحلم – الأمل – عسى أن نغير في ثقافتنا باتجاه مرتكزات الديمقراطية، وبها نحيل الحزب وصناعته إلى أهدافه، حتى يكون حاضناً لكل المنخرطين في أطره، وليس وقفاً على فئة بعينها، تأبى التفاعل مع خيارات تلك الصناعة بناءً على عنصر الكفاءة والانفتاح على الطاقات، بل إبقاءها ضمن دوامات الجدل البيزنطي، تتلاطم فيه أصناف من اللغات، بين التناحر والتجاذب والتصارع والتنافر واختلاق الاختلاف، والتي تصب بمجملها، في خانة الصراع على ما هو هامشي، قد يكون الهدف منه، تهميش الجوهري، أو إدارة الأزمة البنيوية في بناء الأداة الحزبية، بغية الحفاظ على اللوحة بما تخدم ما هو مفروض بحكم الأمر الواقع، وبالتالي اللعب على مدارات تبعدها عن شرور ملامسة الوقائع والحقائق.
مع أننا قد تعودنا، بحكم التربية الحزبية، أو المنهل الثقافي، على سماع ادعاءات الطواقم المتنفذة في (الأحزاب)، مراراً وتكراراً، اقترابها من تخوم ملامسة أسباب التشرذم والانقسامات، واحتضانها لمشروع التآلف، فضلاً عن تباكيها على وحدة الحركة الكردية عبر صرخات (( وجدتها ))، إما على جثة مشروع الإجماع، أو تابوت الإطار الشامل، بعد أن تكون المنافذ قد سدت في وجوهها، وتحولت – كذهنية – إلى منتجة التفريخات، وتيقنت بتوصل المهتمين بالشأن السياسي في الشارع الكردي إلى قناعة، أن القضية التي ندعي حملنا لواء النضال من أجلها، لا تحتمل مثل هكذا تفقيسات، أو أنها بمنأى عن الذي يتم التقاتل عليه، واعتباره من سياقات الصراع، البعيد عن مرتكزاته والمعتاش على قوانينه الخاصة به، ليجعل من القضية الأساسية أسيرة ترهاتنا، وبالتالي وضعها في أحضان سياسات النظام ومشاريع النيل منها، دون أن تعيد، طواقمنا تلك، قراءة اللوحة السياسية الكردية، كي تتمكن من تحديد المستفيد من سلوكياتها، ودون أن تناقش في قرارة نفسها، رسالتها والغاية من مشاريعها التي تتآكل بفعل التكلس، وكذلك جدوى البرامج التي تدعي اختلافها عليها وفيها، وأين ستؤدي بنا هذه الحالة وهي على ما عليها من ذهنية، أعتقد أنها لم تعد تتلاءم حتى مع ما هو في الحضيض من تلك القناعات التي تتباهى بها.
وإذا ما حاولنا العودة إلى أسئلة الطائفة الآنفة الذكر، وهي تقف عند ممارسات “أصحاب القضية” حين تكون المسائل بالنسبة لها محكومة بماهيتها الحزبوية، وكأن ما أطلق عليه تسمية الحزب، لا شغل له سوى الحفاظ على ما تصبوا إليها من مشاريع، تنطلق من الذات وتنتهي عند تضخمه، أي لا هدف له سوى خدمة الأجندات الشخصية وتحريك الساكن في المهاترات، كنا -وبالرغم عنا– أمام إثارة في اللا شعور، ونفخ في نيران كادت أن تخبو تحت الرماد، وسط معمعة كردية، تدار رحاها في البيت الحزبي، من خلال التهم المتبادلة ضمن المشيخات الحزبية، ومحاولة كل طرف أن يبث في وجدان مريديه، أن الآخر جزء من أجندات النظام، ويقف وراء الانتكاسات التي تلحق بالقضية، حتى يخال لنا وكأنه هو من يدير السياسات الأمنية في البلد، ثم سرعان ما تتحول تلك التهم إلى خصائل حميده، عبر تدبيج المقالات عن مناقب الخصم، حين تدق لحظة الوداع نواقيسها، ويكون الفاصل بينا وبينه حفنة من التراب .
هذا المشهد المتكرر في الحالة الكردية، وتحديداً حين يرحل عنا الرموز المتنفذة في الحركة الحزبية، يذكرنا بحالة المتباكين على وحدة الصف الكردي، بعد أن أجهضوا عليه وعملوا على تفتيته، إما نزولاً عند نزعاتهم ورغباتهم، أو انسجاماً مع “الناظم الأساس” الآنف الذكر، خاصةً أولئك الممتلكين لموهبة الكتابة من بينهم، وهو أيضاً يضعنا في حالة من التناقض مع تصوراتنا حيال المستقبل، حين نجد البعض من نخبنا الثقافية، الرافضة للعقلية الحزبية، تسلك السلوك ذاته، لا بل تجتهد – بالنيابة – من أجل الوصول إلى تاج النصر عبر سياقات الطواقم التي تدعي خروجها عليها، لأسباب فكرية أو مسلكية، حتى يبدو لنا وكأن المسألة برمتها تخضع إلى ضوابط حرفة التجارة، وما الادعاءات سوى استخفاف بعقلية المتلقي .
وعليه نقول، عجبي من (أكرادنا) المشتغلين في حقول السياسة والثقافة، الممتهنين لحرفة التجارة بالأحياء والأموات ..
وعجبي من (أكرادنا) الذين يدعون المعرفة، وهم على معرفة بفن التجارة وقوانينها في التعامل السياسي قبل أي شيء آخر.
ولعل السبب الكامن وراء عدم امتلاكنا للأجوبة، أو رغبتنا بعدم التصدي لها، وإن كنا نلامسها – أحياناً – بصيغة المواربة، يعود بالدرجة الأولى إلى إشكالية “الناظم” الذي يضبط قوانين الفعل في الوسط الحزبي، ذاك المتداخل مع “الناظم الأساس”، المحدد لحركة المجتمع السوري وقواه السياسية.
كون الإحاطة به أو إماطة اللثام عنه، بصيغة التجرد والمكاشفة، يضعنا أمام إشكاليات، كنا قد قطعنا على أنفسنا – ومنذ فترة – ألا نقترب من تخومها، وبالتالي ألا نتناول الوضع الحزبي الكردي، بشؤونه وشجونه، من خلال الكتابة، أو على الأقل، بشيء من الشفافية، وذلك لأسباب قد نأتي عليها، حينما نصل إلى تلك القناعة، أن للكلمة باتت فعلها في الوسط الحزبي، وقد أصبحت سلاحاً في التغيير وأداةً للحوار، بعيداً عن الارتهان في أحضان الثقافة “التابعوية” أو الانزواء خلف التعبيرات الساكنة التي نسميها – تجنياً – جزءاً من معادلة التغيير، حتى لا نكون أمام طحن بلا طحين، أو ننفخ في أزمات هي من وزن الانقلابات، ونثيرها في واقع لم نمتلك بعد مفاتيح التعامل مع استحقاقاته، وإن كنا ندرك أن في ذلك نوع من النكوص، أو البقاء ضمن القمقم، وفي أجواء من اللا حراك.
لأنه ببساطة، ومع امتدادات التشكيلة الحزبية القائمة بشخوصها المفروضين كـ “أمر واقع”، وطاقمها المتحكم بكرسي القيادة، وفق قران كاثوليكي، والممتلك لأدوات الدفاع عن ذاته وبقائه في سدة “الحكم” عبر منهجية متحكمة ومستحكمة، بفعل جملة من الشروط والمقومات والضوابط، وجعلت من عملية الخروج عليها دخولاً إلى مزيد من نثر “غبار الطلع” في مناخ الشقاقات والتشققات، كان لا بد أن نستكين إلى الحلم – الأمل – عسى أن نغير في ثقافتنا باتجاه مرتكزات الديمقراطية، وبها نحيل الحزب وصناعته إلى أهدافه، حتى يكون حاضناً لكل المنخرطين في أطره، وليس وقفاً على فئة بعينها، تأبى التفاعل مع خيارات تلك الصناعة بناءً على عنصر الكفاءة والانفتاح على الطاقات، بل إبقاءها ضمن دوامات الجدل البيزنطي، تتلاطم فيه أصناف من اللغات، بين التناحر والتجاذب والتصارع والتنافر واختلاق الاختلاف، والتي تصب بمجملها، في خانة الصراع على ما هو هامشي، قد يكون الهدف منه، تهميش الجوهري، أو إدارة الأزمة البنيوية في بناء الأداة الحزبية، بغية الحفاظ على اللوحة بما تخدم ما هو مفروض بحكم الأمر الواقع، وبالتالي اللعب على مدارات تبعدها عن شرور ملامسة الوقائع والحقائق.
مع أننا قد تعودنا، بحكم التربية الحزبية، أو المنهل الثقافي، على سماع ادعاءات الطواقم المتنفذة في (الأحزاب)، مراراً وتكراراً، اقترابها من تخوم ملامسة أسباب التشرذم والانقسامات، واحتضانها لمشروع التآلف، فضلاً عن تباكيها على وحدة الحركة الكردية عبر صرخات (( وجدتها ))، إما على جثة مشروع الإجماع، أو تابوت الإطار الشامل، بعد أن تكون المنافذ قد سدت في وجوهها، وتحولت – كذهنية – إلى منتجة التفريخات، وتيقنت بتوصل المهتمين بالشأن السياسي في الشارع الكردي إلى قناعة، أن القضية التي ندعي حملنا لواء النضال من أجلها، لا تحتمل مثل هكذا تفقيسات، أو أنها بمنأى عن الذي يتم التقاتل عليه، واعتباره من سياقات الصراع، البعيد عن مرتكزاته والمعتاش على قوانينه الخاصة به، ليجعل من القضية الأساسية أسيرة ترهاتنا، وبالتالي وضعها في أحضان سياسات النظام ومشاريع النيل منها، دون أن تعيد، طواقمنا تلك، قراءة اللوحة السياسية الكردية، كي تتمكن من تحديد المستفيد من سلوكياتها، ودون أن تناقش في قرارة نفسها، رسالتها والغاية من مشاريعها التي تتآكل بفعل التكلس، وكذلك جدوى البرامج التي تدعي اختلافها عليها وفيها، وأين ستؤدي بنا هذه الحالة وهي على ما عليها من ذهنية، أعتقد أنها لم تعد تتلاءم حتى مع ما هو في الحضيض من تلك القناعات التي تتباهى بها.
وإذا ما حاولنا العودة إلى أسئلة الطائفة الآنفة الذكر، وهي تقف عند ممارسات “أصحاب القضية” حين تكون المسائل بالنسبة لها محكومة بماهيتها الحزبوية، وكأن ما أطلق عليه تسمية الحزب، لا شغل له سوى الحفاظ على ما تصبوا إليها من مشاريع، تنطلق من الذات وتنتهي عند تضخمه، أي لا هدف له سوى خدمة الأجندات الشخصية وتحريك الساكن في المهاترات، كنا -وبالرغم عنا– أمام إثارة في اللا شعور، ونفخ في نيران كادت أن تخبو تحت الرماد، وسط معمعة كردية، تدار رحاها في البيت الحزبي، من خلال التهم المتبادلة ضمن المشيخات الحزبية، ومحاولة كل طرف أن يبث في وجدان مريديه، أن الآخر جزء من أجندات النظام، ويقف وراء الانتكاسات التي تلحق بالقضية، حتى يخال لنا وكأنه هو من يدير السياسات الأمنية في البلد، ثم سرعان ما تتحول تلك التهم إلى خصائل حميده، عبر تدبيج المقالات عن مناقب الخصم، حين تدق لحظة الوداع نواقيسها، ويكون الفاصل بينا وبينه حفنة من التراب .
هذا المشهد المتكرر في الحالة الكردية، وتحديداً حين يرحل عنا الرموز المتنفذة في الحركة الحزبية، يذكرنا بحالة المتباكين على وحدة الصف الكردي، بعد أن أجهضوا عليه وعملوا على تفتيته، إما نزولاً عند نزعاتهم ورغباتهم، أو انسجاماً مع “الناظم الأساس” الآنف الذكر، خاصةً أولئك الممتلكين لموهبة الكتابة من بينهم، وهو أيضاً يضعنا في حالة من التناقض مع تصوراتنا حيال المستقبل، حين نجد البعض من نخبنا الثقافية، الرافضة للعقلية الحزبية، تسلك السلوك ذاته، لا بل تجتهد – بالنيابة – من أجل الوصول إلى تاج النصر عبر سياقات الطواقم التي تدعي خروجها عليها، لأسباب فكرية أو مسلكية، حتى يبدو لنا وكأن المسألة برمتها تخضع إلى ضوابط حرفة التجارة، وما الادعاءات سوى استخفاف بعقلية المتلقي .
وعليه نقول، عجبي من (أكرادنا) المشتغلين في حقول السياسة والثقافة، الممتهنين لحرفة التجارة بالأحياء والأموات ..
وعجبي من (أكرادنا) الذين يدعون المعرفة، وهم على معرفة بفن التجارة وقوانينها في التعامل السياسي قبل أي شيء آخر.
وإذا بقي أن نقول كلمة بحق الراحل، بعيداً عما ورثناه من ثقافتنا الحزبية التي تنصف الشخص في قبره، بعد أن تصيبه في مقتل وهو على قيد الحياة، كان علينا أن نقول : نم قرير العين أيها الراحل، فما الذي يجري في حقولنا ( النضالية ) سوى شكل من أشكال التعبير عن عقد الانكسار، فالمستقبل لا بد وأن يضع على شاهد قبرك وردةً تفوح منها رائحة المناضلين الحقيقيين، البسطاء في طبائعهم والبسطاء في تطلعاتهم.
وإلى ذاك اليوم ما لنا سوى أن نحمل للأمل أناشيدنا وللغد أمنياتنا.
وإلى ذاك اليوم ما لنا سوى أن نحمل للأمل أناشيدنا وللغد أمنياتنا.