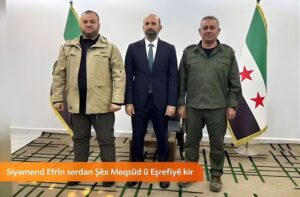د. محمود عباس
كشفت الدراسات والبحوث التي جرت مؤخرا، من قبل المراكز الثقافية والاجتماعية، الديمقراطية، مدى ضخامة تأثير عملية احتلال الكونغرس على المجتمع الأمريكي وخاصة على الساحة السياسية، والذي لربما سيحتاج إلى عقد وأكثر ليتخلص من آثارها. فمهاجمة الآلاف من أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، في السنة الماضية على المبنى، أيقظت النزعة والثقافة العنصرية، من سباتها الطويل، وأحيت ما كان قد تم طمره طوال نصف القرن الماضي، هؤلاء الذين وصفهم الديمقراطيون وبعض أقطاب الجمهوريين، أمثال سناتور تكساس (تيد كروز) ورئيس الأقلية في مجلس النواب (كيفن مكارثي) قبل أن يتراجعا، ربما حفاظا على وحدة الحزب، ونائبة مجلس النواب (ليز تشيني) ابنة نائب الرئيس جورج بوش الأبن (ديك تشيني) وأخرين، بالمجموعات الإرهابية، وصنفوا الحدث على أنه هجوم إرهابي على الديمقراطية الأمريكية، وقارنته نائبة الرئيس (كاميلا هاريس) البارحة في خطابها، بقصف اليابان لپيرل هاربر في الحرب العالمية الثانية، ولـ 9/11.
كما وبينت تلك الدراسات مدى الترسبات العنصرية المترسخة في ثقافة نسبة غير قليلة من المجتمع الأمريكي، أغلبهم من الجيل الذي عاشر العنصرية، ومن بينهم الرئيس السابق دونالد ترمب، أو من العائلات المعارضة لمضمون المادة الدستورية للحقوق المدنية الصادرة عام 1961 من قبل (جون كيندي) والتي بعد اغتياله؛ أستمر في تنفيذها خلفه (ليندون جونسون) عام 1964 م كما وأضاف إليها في العام التالي 1965م قانون حق التصويت لجميع الأمريكيين ومن ضمنهم الزنوج، ويمكن أدراج هذه بالمرحلة الرابعة خلال قرنين من الزمن في مسيرة تحرير العبيد، سبقه قرار (فرانكلين روزفلت) السماح لجميع الأمريكيين بالانضمام إلى الجيش دون تمييز، وذلك قبيل الحرب العالمية الثانية، تلاه قرار الرئيس (هاري ترومان) بإنهاء التمييز في الجيش عام 1948م. أحيت هذه القرارات البنود الثلاث عشرة الخاصة بتحرير العبيد والتي أصدرها (إبراهام لينكولن) من الحزب الجمهوري، بعد الحرب الأهلية. فما فعله جون كيندي بقراره، أنه واجه الثقافة العنصرية والمدافعين عنها في الواقع الميداني، ودعم بشكل مباشر أنصار التحرير، وتمكن من نقل التحرير من الواقع النظري إلى العملي، وأجرم العنصرية بكل أشكالها. وما يتم اليوم وحيث الحد من الحركات المستخدمة العنف تحت الغطاء السلمي أو مناهضة العنصرية حتى ولو كانت من العرق الأسود، ديمومة لتلك القرارات، مثل التحذيرات الصادرة بحق حركة (حياة الزنوج مهمة-Back lives matter) التي تشكلت حديثا في عام 2013م والتي لا تخلوا من العنف رغم أن بنية تكوينها تدعوا إلى السلام وإزالة العنصرية، قرارات الرئيسين الأخيرين، دفعت بالأمم المتحدة على إصدار مماثلهم، في عام 1963م؛ أحدهم تحت رقم (1904) ويتضمن وضع حد لكل أشكال التمييز العنصري في جميع أنحاء العالم، والتي كانت تكملة لقرار رقم (1514) الصادر عام 1960م، حول منح استقلال الشعوب.
على صدى الهجوم، أظهرت البحوث حقيقة كانت شبه مخفية، وهي أن نسبة الراديكاليين تتجاوز 1% من السكان، وهي ليست محصورة في الشريحة غير المثقفة والريف الأمريكي كما كانت تنشرها المراكز الثقافية والإعلامية الأمريكية. ففي الدراسات التي أجريت على مهاجمي مبنى الكونغرس بعد خطاب ترمب في 6/1/2021م على خلفية خسارته في الانتخابات، أن ثلثهم كانوا أصحاب السوابق، و13% من عناصر المليشيات العنصرية، بينهم من ينادون بانفصال ولاية تكساس عن الولايات المتحدة الأمريكية، وهي منظمة تؤمن بقوة السلاح في تنفيذ أهدافها، علماً أن 25% منهم من خريجي الجامعات، فهذه المؤشرات تعكس ثقافة شريحة لها صدى بين نسبة من الأمريكيين، رغم أنها مرفوضة ومنبوذة من المجتمع الأمريكي العام.
الحزب الجمهوري، يؤل ما تم إلى خلفيات سياسية، والصراع على السلطة، بينما الديمقراطيون، يعرضونها على أنه هجوم على الديمقراطية وصروحها، ومحاولة لأحياء الثقافة العنصرية، وهو ما أدى إلى توسع الصراع بين الحزبين، ليس على التشهير بنزاهة الانتخابات أو كيفية التعامل مع الوباء العالمي، أو استراتيجية الصراع الدولي، بل حول البنية الثقافية للمجتمع الأمريكي، ومساراتها، وعلى أثرها بدأ الديمقراطيون يروجون على أن مرحلة إدارة ترمب كانت من أحد أسوأ المراحل التي مرت بها أمريكا طوال قرابة قرن من الزمن، ليس في البعد الاقتصادي، بل الثقافي والاجتماعي والسياسي، ويدرجون الرئيس السابق دونالد ترامب كأسوأ رئيس في تاريخ أمريكا، وأنه كان يضع مصلحته الشخصية فوق كل الاعتبارات الديمقراطية أو المصلحة الوطنية.
علما أن الجمهوريين، ورغم كل ما تم، لم يتخلوا عن دونالد ترمب، ونسبة تأييدهم له ظل في حدود ألـ 73%، كان في فترة نجاحه تتجاوز 85%، ليس حبا به وبمواقفه وبسياسته، بل حفاظاُ على مكانة الحزب، وهي ذاتها التي أدت إلى سقوط نسبة التأييد لنائبه (مايك بينس) إلى ما دون 30% على خلفية تصريحاته المعارضة لموقف الحزب من المهاجمين ودور ترمب في التحريض على عملية الاعتداء على الكونغرس. وبالمناسبة فقد كان نائب الرئيس ترامب (مايك بينس) موجودا في قاعة الكونغرس، أثناء الهجوم واحتلال المبنى، والعبث بمحتويات مكتبه ومكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وكان يترأس اجتماع الكونغرس، أجبر من قبل الحرس الخاص على الخروج.
رغم ارتفاع نسبة التضخم إلى قرابة 6%، والبطالة، وعدم إيقاف مد الوباء، وتراجع الاقتصاد العام، خلال مئة يوم من أستلام إدارة جو بايدن للبيت الأبيض، لا تزال إشكالية هجوم 6/1 من العام الماضي تهز مكانة الحزب الجمهوري، وتدفع بترمب ومؤيديه إلى التركيز على تهمة التزوير في الانتخابات، والتي أصبحت ورقة دفاع عن الذات، لا بحثا في البعد القانوني، وعليه لم يتمكنوا من إيقاف أصدرا الأحكام بحق 125 شخص من أصل 725 يتم محاكمتهم، وقد يزداد العدد لاحقا، فما تم تصويره من خلال أجهزة المراقبة، تتجاوز 1700 ساعة تصوير، بإمكانهم متابعة كل فرد دخل المبنى، أو كان سببا في قتل أربعة من المهاجمين، وأثنين من الشرطة، وانتحار أربعة من البوليس فيما بعد، إلى جانب 150 جريحا، والمئات من الذين يعالجون نفسيا. والتي على بنيتها ركز (جو بايدن) في خطابه بمناسبة مرور عام على القضية، على أنه لم يكن صراع سياسي، بل كارثة وطنية، وهجوم على الديمقراطية في أمريكا، كما قالتها رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، قبل سنة، وبعد الحدث مباشرة (تعرضت اليوم ديمقراطيتنا إلى هجوم مخجل).
واجه دونالد ترامب ومؤيديه الهجمات الإعلامية الضخمة ضده، بالترويج لاحتمالية تشكيل منظمة سياسية بعض أعضائها من الحزب، قد تنافس مجموعة (حزب الشاي) المتكون قبل عقدين من الزمن والذي ضم شريحة من المتطرفين والراديكاليين (التسمية جاءت تيمناً بالجماهير التي كانت تناهض البريطانيين قبيل الحرب الثورية الأمريكية أو ما يسمى بالاستقلال (1775-1783)). لم يتمكن ترمب ومستشاريه ومؤيديه، من التغطية على التهم، على أن المنهجية إرهابية وذات بنية عنصرية، لمجموعات تصارع من أجل البقاء كقوة ضمن المجتمع، بعد إحساسهم بخساراتهم المتتالية، ونهايات قوة التحكم بالسياسة والاقتصاد والمجتمع، ووضوحها في الواقع العملي، وبعد عقدين أو قريبه من صدور البند الدستوري المذكور، أصبحوا ليسوا سوى مجموعات تتجه نحو الزوال، خاصة وأن الثقافة المركزة المناهضة للعنصرية، والتي تدرس للأطفال من السنوات الأولى وفي جميع المراكز العلمية، أعطت نتائج مبهرة، أدت لتخريج أجيال ذات حساسية عالية تجاه كل ما تتعلق بالثقافة العنصرية.
ولنكون أكثر مصداقية مع البنية الثقافية للمجتمع الأمريكي، وحيث التشديد الصارم حول التمييز العنصري، مقابل مخلفات المراحل العنصرية الكارثية السابقة الواضحة، فإن معظم المسيرات المناهضة للتمييز أو المؤيدة للسلام والمساواة، يمارس فيها العنف، ومن كل الأطراف، فلا زال كل مكون اجتماعي يحتضن بشكل أو أخر شرائح ذات منهجية عنصرية، إن كان بالفعل المباشر كما تم في عملية الهجوم على الكونغرس، أو برد الفعل كما يستخدمها ممثلو العرق الأسود، تحت شعارات مناهضة التمييز العنصري، ويافطات سياسية-سلمية، حتى ولو كانت تبرر على خلفية القرون الطويلة من الإنكار والظلم والاستبداد.
وبغض النظر عن نسبة العنصريين، عالية أم لا، إلا أن بقايا الماضي، لا زالت تبرز عند معظم الأحداث، وخاصة المتعلقة بالعرق الأسود. فحيث بنية التمييز العنصري التي تكونت عليها أمريكا، ومراحلها بحق الزنوج، كمنعهم من ممارسة الطقوس الدينية بكل أشكالها، وتحريمهم من التعلم والقراءة والكتابة، إلى درجة أية محاولة كانت كافية لقتلهم. مرت قرون قبل السماح لهم، باعتناق المسيحية والكتابة والقراءة، وتقبلهم كبشر، ومن ثم إعطاءهم والهنود الحمر أصحاب الأرض، حق الانتخاب والترشح في عام 1968م، من قبل الحزب الديمقراطي، علما أن الحزب الجمهوري هو الأول الذي نادى بتحريرهم، واليوم نفس الحزب متهم من قبل الديمقراطيين على أنهم سمحوا لترمب بأن يتمادى إلى درجة هجوم مؤيديه على الديمقراطية وإحياءهم الثقافة العنصرية. وعليه يروج الديمقراطيون على أنهم مع المراكز الإنسانية، يعملون على إنقاذ المجتمع الأمريكي من مخلفات الماضي، من خلال مواجهة شريحة من الجمهوريين، أمثال دونالد ترمب، وإضعاف صوتهم ودورهم على الساحة السياسية والاجتماعية.
لا شك المسيرة طويلة، ستكون هناك تضحيات جديدة، والصراع ليس سهلا، ليس في مواجهة مجموعات المؤيدين لمنهجية دونالد ترامب بل مواجهة الترسبات الثقافية؛ مع ذلك فالأغلبية المطلقة من الشعب الأمريكي تؤمن بأن المسيرة الثقافية الصحيحة هي الراجحة، ويتجه المجتمع نحو التخلص من ترسبات القرون الماضية.
د. محمود عباس
الولايات المتحدة الأمريكية
7/1/2022م