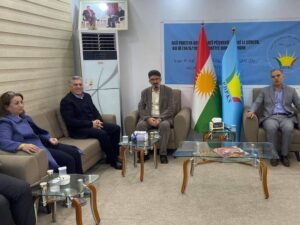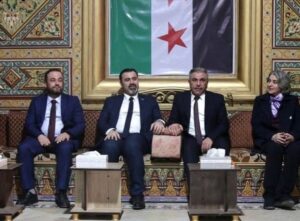إبراهيم اليوسف
إبراهيم اليوسفمالاشك فيه، أن خاصية البث الافتراضي، الديجيتال، عبر الإنترنت، وما يسمى البث، عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي – الفيس بوك- جاءت لكسرمركزية الإعلام المتسلط المتحكم به من قبل الحكومات والجهات المقتدرة مالياً، أو المدعومة تمويلياً، في زمن نفاق الممول: وتجار شنطة الإعلام، وكانت وسائل الإعلام الحداثية/لتقليدية، والجهات التي تديرها، في خدمة الأنظمة، كما كان الإعلام في كل مرحلة، إلى أن جاء هذا المنجز العظيم ليوفر لكل مواطن عالمي إمكان أن تكون له محطته التلفزيونية- أقولها تجاوزاً وأنا أدرك العلامات الفارقة لكل حالة- إلا أنها نسخة طبق الأصل عن الـ “تي في”. إنها نسخة افتراضية، عما هو افتراضي – أصلاً- فما الـ “تي في” ذاته إلا افتراض، في مواجهة ما هو فيزيائي، وقد بات الإعلام الرسمي الذي كان يصنع الرأي العام أمام تحد كبير، بل إنه غدا في مواجهة مراقبة عليه،
ويمكن هنا أن نقارن بين صاحب بث فردي له جمهوره المليوني، عبر العالم، مقابل فضائية عربية من أمات الفضائيات تمويلاً وحضوراً وتأثيراً “الجزيرة”، فنجد كيف أن البعبع الكرتوني في الإعلام المهيمن وهو يرضخ أمام إعلامي بأدوات متواضعة، من حيث الإمكانات الذاتية، وستكون المفاجأة أعظم عندما نعلم أن تكلفة برنامج البث الافتراضي هي من دون “فلس” أو “قرش” أو حتى “قشة”، مقابل مليارات الدولارات التي تصرف على هذه الفضائية أو غيرها، ما جعل الإعلام الرسمي في مأزق كبير، إذ إنه -الآن- أمام مرحلة جديدة يضطر خلالها للتخفف من أكاذيبه، وتبني الخطاب الأقرب إلى الموضوعية، فيما إذا كان يمتلك نقطة أو ذرة من –ماء الحياء- في وجهه- إن لم يكن وجهه قد تصحر أو سقط في أحط درجات المستنقع الكريه، فيما إذا كان من ذلك النموذج الإعلامي الذي يخفي ويقزِّم أو يشوه ما يريد ويظهر ويضخم ويعملق ما يشاء، وما أكثر النماذج هنا!
وما إن بدأ البث عبر الفيس بوك، حتى بادر عدد من المتمكنين، المهرة، للاستفادة من هذه الخاصية، إلا أن غيرالمتمكنين، الأدعياء، والذين لاتتوافر لديهم أبسط وادنى الإمكانات – حتى الأميون منهم- هرولوا إلى هذا العالم، كمحللين سياسيين. والتحليل غدا المجال الأكثر استسهالاً لطالما هناك من يمتلك “اللسان” حتى وإن لاتتوافرفيه صفة من صفات الحكواتي، واستطاع قسم من بيننا إثبات ذاته وتطوير نفسه، واللحاق بالركب، وشد الانتباه، وتقديم خطاب متوازن، يستحق الثناء، إلا أن بعضهم الآخر، سقط في الهاوية، أو: الحاوية….، ليس فقط لجهله المعرفي، أو المهني، فحسب، وإنما لافتقاره للضوابط المطلوبة، إذ غدا نسخة فوتوكوبية عن إعلام الأنظمة، بل ثمة من راح يبزُّ إعلام الأنظمة من خلال التنصُّل من القيم الأخلاقية والضوابط، وذلك في اللحظة التي بات فيها القانون – حتى في أوربا- يقف مكتوف الأيدي أمام تمادي بعض المنفلتين الذين يعملون على جبهتين:
الكذب على المختلف معهم وتشكيل رأي عام مضاد
استخدام المفردات والعبارات البذيئة التي تقشعرّ ُلها الأبدان: شتم المختلف معهم واستهداف كرامته وعظام موتاه وحتى مقدساته!
ولايمكن الإقدام على هكذا بذاءات إلا من خلال من يعتبر ذاته مسنوداً إلى – ما يشبه المافيا- من القوة والجبروت والعنف، وهو ما يبدو من لغة التحدي والعنترة لدى بعضهم، وهم من الأقزام حقاً، لاسيما و إنه يدور الحديث حالياً عن – تمويل- بعض منهم، وشراء ما يلزم لهم من أدوات وتقنيات لتطوير “أدوات التواصل” وصناعة “الجمهور” أو “تصنيعه”، من قبل دوائرهم، والالتفاف حولهم من خلال تأمين صبيان معلقين، يتصرفون بعيون وضمائر مغمضة، ينفذون مايملى عليهم، أو أنهم باتوا يتصرفون – تلقائياً- بعد أن تم تدجينهم، من خلال استخدام -أسطول إعلامي- في موازاة الحرب الدائرة في البلاد، وكان لهذا الأسطول المعد من جيوش من الذباب الأزرق، والهكر، والمبوقين، أو البواقين، مغسولي الدماء، والذين يهرلون من أجل أمور، سبق وأشرنا إليها: الرّبت، أو المرتبة، أو حتى الراتب، وهناك من يقبضون، وقد أشار أحد الذين برزوا في مجال البثِّ الديجيتالي، في أكثر من مرة إلى بعض من أساؤوا إليه، من خلال تسمية بعض الأوكار، ومن وراءها!
ومايقال -هنا- عن هذا الإعلام المضلل، المزيف، يقال، في الوقت ذاته عن أي إعلام آخر، في المقابل، ينخرط في اللعبة، وإن كان ذا جهود فردية، شخصية، وقد جاء كرد فعل، وبأدوات ضعيفة – لكن مؤثرة- مزلزلة، في مواجهة هذا التفرد، والتنمر، والتغول، وينسحب عليه الحكم ذاته في حالات التنصل من الوازع الأخلاقي القيمي، لأنه يسقط في المستنقع ذاته، إلا إذا كان متسامياً عن التشويه والتحقير الكاذبين، بعيداً عن لغة هتك الأعراض والقيم والتاريخ!
لقد شكل هؤلاء، ومن هم وراء هذا الإعلام العابر جبهتين، انطلاقاً من قاعدة “من ليس معنا فهو ضدنا”، مستهدفين كل من يقدم حقيقة ما، ويغدو صاحب الرأي – المخالف- المختلف- أكثرعرضة للاستهداف والتشويه، متى كان أكثر إخلاصاً، لأدواته. لرؤيته. للحقيقة. لشعبه، رافضاً للإغراءات والتهديدات، أو لنقل رافضاً لثنائيتي: الترغيب والترهيب، بل وتزداد درجة الكيدية، والعنف، وثقافة ما بعد الكراهية بحق بعضهم إن قارب – عش الدبابير- وراح يسمي أدوراه، وأخطاره، وكيفية تدميره لبناء إنساننا وبنيته وبنيانه ناهيك عن حلم جغرافيته أو: كردستانه، بدعوى النضال لأجلها، وهو ما خندق حوله حتى بعض من يحسبون على الإعلام أو الثقافة أو المجتمع، وهم من عابري المراحل بزئبقياتهم!
ومن هنا، فقد وجدنانا أمام جبهتين، إحداها الناجية، وثانيتها الجانية على نفسها، وفق رأرآت هذا الإعلام المخادع، والثانية الضالة، ما يذكِّر بأسطورة- الدجال وسفرة طعام آخر الزمان- وما عليها مما لذ وطاب والتي يترامى في “زفر” أو “دبق” مرقتها كل من أكره، أو انعدمت به السبل، أو تهافت لجشع لأحد دواعي السقوط، غير البريئة البتة، ما عدا من زين له الأمر زوراً، وارتمى في المصيدة، ولكن: أنتصور، أن هناك فاقداً للمنظومة العقلية التقويمية إلى هذه الدرجة من السذاجة؟ أقول هذا ونحن أمام من يقدم ذاته كمشروع إعلامي، بل “ملك” الإعلام، في لحظة غبش وتضبب رؤيا ورؤية وعقل وضمير لديه ولدى المصفقين له، والنافخين في قربته الفارغة!
وبأسف، فإن حالة الفرقة كردياً، وكردستانياً، لم تصل، في يوم ما، إلى هذا المصير الأليم الذي آلينا إليه، حتى في أحط اللحظات التي لجأت فيه القوى المحتلة لكردستان لاستمالة طرف ضد طرف، لأن من كانوا في كلا الطرفين إنما كانوا القلة القليلة، بينما لم يبق الآن، أحد، في زمن: ما بعد الحداثة المعلوماتية أو التكنولوجية “والسلاح المستخدم ضمن حدود المصطلح الأخير”، لذلك فإن جبهة الغيارى في الإعلام والثقافة – وهي بدورها مشتتة مبعثرة- لابد من أن تتوحد، من أجل هتك وتمزيق أستار ما هو تضليلي، لأن لا عذر قط لمن يتهاون الآن، تحديداً، لاسيما من بين صفوف – الرماديين- فإما أنهم مع وليمة “الدجال” أو هم ليسوا في منأى عنها، ولا ضير إن سكتوا، إلا إن من يرجح كفة هؤلاء، بغزله المعلن أو المستور، مواجهاً أصوات الخلاص، فإنما هو في النهاية في الجبهة الأخرى، لامحالة!
ولئلا تبدو الصورة قاتمة، فإننا، الآن، بصدد الحديث عن مستويين: النخبة وشبيهتها الملتفة، من حولها، في هذا الطرف أو ذاك، ولا أعني أبناء شعبنا الذي إما هو وفي نسبته الـ “99 بالمئة” أو أكثر، إما رافض لهذا الخطاب، علناً أوسراً، لأن – النخب المستفيدة- بهذا الشكل المعنوي أو الملموس- من هذا الطرف أو ذاك، هم ذواتهم من يسعرون خطاب الهلاك الكردستاني. خطاب الاستعداء. خطاب الانتحار، حتى وإن أكره بعضهم للمشاركة في كرنفالات التلذذ بسقوط الذات: من لدن هذا الطرف أو ذاك!
وإذا كنت قد عنونت هذا الفصل بـ “الديجيتاليين/ الديجيتاليون” فلأنهم الآن الأكثر تماساً مع الناس، لأن من لا يستطيع كتابة خبر صحفي بسيط مراعى الشروط يمكن نشره في صحيفة ورقية أو إلكترونية محترمتين، ولا يستطيع كذلك كتابة مقال في الوقت ذاته في مجلة محكمة، فإنه غدا إعلامياً وله جمهوره، من دون أية عدة، وإن كنا نجد أن هذا وذاك لايستطيعان رمي نفسيهما في البحر ما لم يجيدا السباحة، ولا يستطيعان ممارسة الطب ما لم يكونا قد تعلما في إحدى الأكاديميات، إلا إنهما أعلاميا -الفجاءة- أو اللحظة الساقطة في إعلامنا، وأستثني هنا كل معتدل في خطابه، في أي طرف كان!
ولايسعني هنا، إلا أن أدعو إلى أن يكون هناك – ميثاق شرف- ولو في الحدود الأولى، ولا أقول: الدنيا، يتفق عليه كل من يعمل في مجال الإعلام، في هذا الطرف أو ذاك، بحيث أن تكون هناك خصوصيات يمنع اختراقها، وهنا فإنني لأدعو المؤسسات الإعلامية والثقافية الكردستانية – الرسمية وغيرالرسمية- ذات الحضور، أن تتداعى إلى عقد مؤتمرعام، لصياغة بنود مثل هذا الميثاق، واعتبار من يخرج عليه شاذاً، ولا ضيرمن اللجوء إلى القانون، في دول الاغتراب أو في الوطن، بعد أن تشدد هذه الأخيرة على البنود، وألا يكون الميثاق ذريعة وأداة بيد أي طرف لمنع الإعلامي من ممارسة حقه و دوره النقدي في فضح أي انتهاك، بل هناك حدان: أولهما يتعلق بالخصوصية وصونها وثانيهما يتعلق بماضي وحاضر ومستقبل شعب ووطن وخريطة، يمنع المساس بحرماتهما!
يتبع….