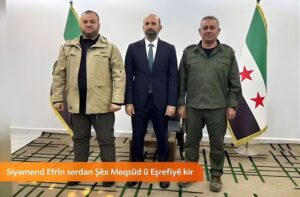أحمد اسماعيل اسماعيل
أحمد اسماعيل اسماعيلأن نشاهد ونسمع من يلغي وجود حيوان ما كالعنقاء مثلاً، أو كائنات مثل الجن، أو يشك في حقيقة وجود مبدع مثل شكسبير على أنه كاتب آخر غير وليم شكسبير (1564 -1616) وإن الروائع التي كتبها هي من ابداع مواطنه ومعاصره الكاتب كريستوفر مارلو، فتلك مسألة فيها وجهة نظر، رغم ضعف حجة من يدعيها أو يدعي أنه عربي سوري الأصل ينحدر من إحدى قرى طرطوس السورية!! وينطبق الأمر نفسه على درجة صدق رسالة رسول أو مصداقية دين، سماوياً كان هذا الدين أم غير سماوي، فالعلم لا يؤمن بالمسلمات، وكذلك العقل غير المرهون بما هو خارج المنطق، لا يقر هو أيضاً، مثل العلم، بالتسليم بحقيقة أمر ما قبل خوض مسافة طويلة من الغوص والبحث تبدأ من ضفة الشك وصولاً إلى اليقين.
إذا كان هذا التوجه أو النهج صحيحاً، بل ضرورياً، في أمر يخص فرد ما، نبياً كان أم مبدعاً، كما هو الحال بالنسبة لشكسبير مثلاً، أو مسألة فكرية أو مسلمة أو ظاهرة ما اختلط فيها الحقيقي بالوهمي والأسطوري بالواقعي، أو حالة نهضت في زمن مضى ثم توارت وانقطعت كحلقة من سلسلة متواصلة، إذا كان ذلك مسلماً به في حالات كهذه؛ فهل يمكن تسمية من يتوسل الشك وسيلة للوصول إلى اليقين في وجود ما هو ظاهر للعيان ماديا وتاريخياً بالمنطقي أو العاقل؟
هل يحتاج الشجر مثلاً والنهر والبحر والقمر والإنسان إلى إثبات وجود؟!
ومثل وجود الشجر والقمر والبحر هل يحتاج شعب يتجاوز تعداده عشرات الملايين من البشر ممن لهم ما لبقية أبناء الشعوب الأخرى من صفات عضوية ونفسية واجتماعية؛ كان موجوداً منذ آلاف السنين وما يزال مستمراً في الوجود، إلى العودة للمخابر وقاعات البحث والدرس وإمضاء وقت طويل من الانتظار أشبه بانتظار غودو الذي لا يأتي، هل مثل هذه البديهيات كانت غاية منهج العم ديكارت؟
نعم يحتاج.
يجيب قائل بصوت مسموع وإن بشكل لا يخلو من مواربة.
وهو قول لا يثير الدهشة رغم غرابته إلا لمن يجهل علّة قول القائل ودافعه والحواس البدائية التي تنهض لديه حين يتعلق الأمر بموضوع الوجود القومي للآخر، الشريك، حينها يصبح موضوع الدرس والبحث هو نفي وجود هذا الآخر لا إظهاره، نفي يتجلى في محو كل ما لهذا الآخر من حضور في التاريخ، قريباً كان أم بعيداً، وإخفاء كلّ رسم له في الجغرافيا أو شاهدة حتى لو كانت لقبر، ونزع ارتباطه بالأرومة البشرية التي انحدر منها واستبدالها بأرومة أخرى، قد تكون حقيقية ولكنها عاصية، أو خرافية، وكلُّ ذلك بقصد الوصول إلى إلغائه من الوجود نفسه: جغرافياً وتاريخياً وأرومة ونسباً.
والحق يقال أن شعوباً أخرى كثيرة قد عانت، مثل الشعب الكردي، من نتائج هذه الذهنية أو السياسة أو الثقافة، ليس الهنود الحمر المثل الوحيد في هذا المجال، بل شعوب أخرى كثيرة مستضعفة، ومن طريف ما حصل في هذا الخصوص لأحد هذه الشعوب في زمن تاريخي مضى هو ما أقدمت عليه ملكة انكلترا فكتوريا حين وضعت يدها على موقع هولندا في الخارطة وقالت: لم يعد هذا البلد موجودا؟!
وإذا كان هذا الفعل قد أصبح اليوم مثار سخرية، بل استهجان كل عقلاء اليوم والبارحة، ولن أقول أحراره، لأسباب قد يطول شرحها، فكيف سيتم التعامل غداً مع أفعال هؤلاء القوميين الأحاديين الذين يجهدون بكل ما أوتوا من قدرة لنفي وجود الكرد: بشراً وحجراً وأرضاً، متوسلين لإثبات أو تجسيد هذه الرغبة، كل ما مالكت أيديهم وعقولهم وقلوبهم من براهين ومراجع تاريخية ووقائع وتضليل سياسي وتاريخي واعلامي وتهجير وسيانيد!
فهل سيتلقى العالم كل ما ذهبوا إليه في هذا المجال بالسخرية؟!
قد يكون الجواب: نعم، وقد يكون :لا.
من يدري؟ وقد لا يكون هذا ولا ذاك!!
فمازالت المخيلة المتورمة ذاتها تطرح صوراً مختلفة للكرد ذاتهم للقصد ذاته.
هل يحتاج الأمر إلى مراجعة وعودة إلى الماضي؟
إذا كان هدف العود إعادة تصحيح المسار.
فهو أحمد ولاشك.
حين كانت الجن حاضرة في الزوايا المعتمة من الأماكن والعقول، وكانت العفاريت والأشباح تطارد البشر وتُقلق راحتهم، أبدعت المخيلة التي لا تتخيل للكرد وجوداً يوازي وجودها ويضارعها، أنساباً يختلط فيها الحقيقي بالوهمي والأسطوري بالخرافي، وتُعد طرفة انتساب الكرد للجن من أولى نتاجات تلك المخيلة، وكي لا أُتهم بالشطط وعقدة الاضطهاد، أقول ربما كان السبب في ذلك أن الجن قوم لا ينتمون إلى هذا العالم، وليست لديهم أرض واقعية يسكنون عليها مثل بقية الأقوام، فأرضهم في مكان آخر غير هذا المكان أو حتى العالم، فمن الطبيعي، والحال هذه، أن يكون الكُرد، مثل أسلافهم الجن، موجودون في الحقيقة وغير موجودين في الواقع!
وحين تغير الزمن وتبدلت الأحوال، وبدأ العالم يفرق بين عزيف الجن ولغة البشر، وبين حكايات الأشباح وفعل التشبيح، بل وحين أصبح الحديث عن الجن غير لائق بكل منتم للحضارة والعصر، وأصبح للشعوب مسكناً اسمه الوطن وليس وادي عبقر أو الموت، وسادت أوطان واُغتصبت أوطان، اجتهدت تلك المخيلة في إيجاد نسب آخر للكرد، بل أنساب، امتدت هذه المرة إلى الخارطة الوراثية وليس التاريخية والجغرافية كما فعلت في زمن مضى، فأبدعت للكُرد أصولاً لا ترجع إلى أرومة واحدة كما حين كانوا أبناءً للجن، وقد جاء ذلك نتيجة، وبالتزامن مع، توزيع بلاد الكُرد كعكة جغرافية على بلاد الطوق الكردي، فكان من الصعب، والحال هذه، على الفائزين بهذه الكعكة أن يقتلعوا منها سكانها المغروزين فيها مثل جبالهم العالية وأنهارهم الغزيرة، فأبدعت مخيلتهم تشريد الاسماء بدلاً من مسمياتها، وذلك بقصد نفي وجود أصحابها؛ اسماء مدناً وقرى وقبائل وأنساباً وبشراً، فأصبحت هوازن، لا بوطان أو برزان مثلاً هي من تناسل عنها كُرد جزء من تلك الكعكة، وأتراك الجبال اسماً للكُرد في جزء آخر، وأبناء عم ضالين في جزء ثالث، وإن من جاؤوا مع تلك الكعكة في جزئها الرابع ليسوا سوى كائنات تدحرجت في غفلة تاريخية من جبال الجزء المتاخم له، ولن نندهش في زمن قادم، حين تتحول فيه قصص الخيال العلمي إلى واقع معيش، ونشاهد سكان كواكب أخرى يتجولون في مدن كوكبنا الأرضي، وشوارع مدننا، لن نندهش حينها من سماع من يتحدث عن الكُرد على أنهم كائنات قادمة من كوكب آخر خارج المجموعة الشمسية، أو مسافرون جاؤوا من زمن منفلت من السيرورة هو زمن غير زمننا هذا!!
وحين مرت السنون وتتالت المراحل وتبدلت المعالم التاريخية، وظل الكُرد كُرداً ولم يصبحوا من قوم هوازن أو عدنان أو أتراك الجبال أو أبناء عم ضالين، أو قوم طارئ على الجغرافيا والتاريخ، وحين أصبح للربيع في هذه المنطقة عربة يجوب بها كل الأوطان التي امتد فيها التصحر من الطبيعة إلى القلوب والعقول، وفي هذا الزمن أيضاً أبدعت المخيلة ذاتها، فيما أبدعت، في هذا الربيع القارس، حيلاً لا حلولاً، تعترف بالكردي كفرد من مجموع مجتمع متعدد، له ما له وعليه ما عليه من واجبات وحقوق، لقيط تاريخي بلا هوية اجتماعية، وغصن مكسور من شجرة انتمائه القومي.
ثم اجتهدت في تقديم اعتراف آخر بالأكراد كمجموعات بشرية لا بالكُرد في مجتمع له خصوصياته وعلاماته الفارقة، البسيطة ولكن الواضحة والمميزة، ثم وفي زمن أصبحت الساعة فيه تسير على عجلات الأحداث المتسارعة، علا صوت من المخيلة ذاتها يعترف بالكُرد شريكاً في الوطن كأقلية قومية وليس كشعب؛ تكون القومية الغالبة فيه سكانياً وليس المتفوقة حضارياً، سيدة لهذه الأقلية ووصية عليها.
ومن آخر نتاجات هذه المخيلة الاعتراف بالكُرد شعباً وليس أقلية أو تجمعاً بشرياً، ولكن ذلك الشعب الضيف على الوجود، السياسي وغير السياسي، لا العضو الدائم كغيره من شعوب هذه القرية الكونية، حتى ممن هو أكثر منها عدداً، وممن هي أحدث منه ولادة أو ظهوراً تاريخاً.
قد لا يكون كل ما سبق من كلام جديداً لمن رأى وسمع عن الكُرد في بلادهم المشطورة إلى أربعة أقسام كقطعة حلوى، فلم يعد الأمر بعد كل هذا الزمن من دوام الحال واستمرار الايهام بحقيقته مثار السخرية ولا الحزن أو حتى التعاطف،
غير أن الجديد دائماً، هو تماهي الكُرد مع مناخات هذه المخيلة وتكرارهم ردَّ الفعل نفسه باستمرار، وبشكل مساو له في القوة والشدة ومعاكس له في الاتجاه.
والمتجاوز له في بعض الأحيان!!
ردّ فعل عاطفي وانفعالي لا فعل عقلي حقيقي.
مشهد تراجيدي لا يكفُّ عن التكرار، وجدل بيزنطي في ماركة محلية.
والنتيجة..
اجترار سياسي، واستنزاف للطاقات والجهود وإضاعة للزمن والفرص.
هنا بالذات يصبح العود أحمد،
عودة لا تكتفي بمراجعة “ابداعات” تلك المخيلة وما تمخض عنها، بل بمراجعة دفاتر يوميات “نخبهم” السياسية والثقافية والفكرية..
والميدانية حالياً، مراجعة تبدأ من الواقع لا من الأوهام، ومن البديهيات والمسلمات لا من الجدل العقيم، والعمل على صياغة الاسئلة المتعلقة بوجودهم ومستقبلهم بعيداً عن مناخات المصائد وطبيعة الفخاخ المنصوبة لهم من قبل هواة ومحترفي رمي الكُرد في المياه العكرة لتسهيل عملية اصطيادهم ومشاركتهم في جعل السهام الموجهة إليهم؛ إلى عقولهم وقلوبهم لا تخطئ هدفها.
حينها فقط سيصبح الحديث عن الفعل لا رد الفعل، وعن فعل التلقي المنتظر، المناسب والفاعل للآخرين، أو حتى رد الفعل الساخر من أوهام ونتاجات مخيلة مريضة، وأيدي غير نظيفة.
ممكناً و منطقياً.
ليس رد الفعل إلا حركة روح محتضرة وفعل آلي.
أما الفعل فهو من خصائص الأحيّاء وصفات الكائنات العاقلة، ذلك الفعل الذي يؤكد أننا فاعلون لأننا بشر أسوياء ولسنا كائنات غافلة أو أدوات طيعة بيد أحد:
أيّ أحد.
a.smail1961@gmail.com
هل يحتاج الشجر مثلاً والنهر والبحر والقمر والإنسان إلى إثبات وجود؟!
ومثل وجود الشجر والقمر والبحر هل يحتاج شعب يتجاوز تعداده عشرات الملايين من البشر ممن لهم ما لبقية أبناء الشعوب الأخرى من صفات عضوية ونفسية واجتماعية؛ كان موجوداً منذ آلاف السنين وما يزال مستمراً في الوجود، إلى العودة للمخابر وقاعات البحث والدرس وإمضاء وقت طويل من الانتظار أشبه بانتظار غودو الذي لا يأتي، هل مثل هذه البديهيات كانت غاية منهج العم ديكارت؟
نعم يحتاج.
يجيب قائل بصوت مسموع وإن بشكل لا يخلو من مواربة.
وهو قول لا يثير الدهشة رغم غرابته إلا لمن يجهل علّة قول القائل ودافعه والحواس البدائية التي تنهض لديه حين يتعلق الأمر بموضوع الوجود القومي للآخر، الشريك، حينها يصبح موضوع الدرس والبحث هو نفي وجود هذا الآخر لا إظهاره، نفي يتجلى في محو كل ما لهذا الآخر من حضور في التاريخ، قريباً كان أم بعيداً، وإخفاء كلّ رسم له في الجغرافيا أو شاهدة حتى لو كانت لقبر، ونزع ارتباطه بالأرومة البشرية التي انحدر منها واستبدالها بأرومة أخرى، قد تكون حقيقية ولكنها عاصية، أو خرافية، وكلُّ ذلك بقصد الوصول إلى إلغائه من الوجود نفسه: جغرافياً وتاريخياً وأرومة ونسباً.
والحق يقال أن شعوباً أخرى كثيرة قد عانت، مثل الشعب الكردي، من نتائج هذه الذهنية أو السياسة أو الثقافة، ليس الهنود الحمر المثل الوحيد في هذا المجال، بل شعوب أخرى كثيرة مستضعفة، ومن طريف ما حصل في هذا الخصوص لأحد هذه الشعوب في زمن تاريخي مضى هو ما أقدمت عليه ملكة انكلترا فكتوريا حين وضعت يدها على موقع هولندا في الخارطة وقالت: لم يعد هذا البلد موجودا؟!
وإذا كان هذا الفعل قد أصبح اليوم مثار سخرية، بل استهجان كل عقلاء اليوم والبارحة، ولن أقول أحراره، لأسباب قد يطول شرحها، فكيف سيتم التعامل غداً مع أفعال هؤلاء القوميين الأحاديين الذين يجهدون بكل ما أوتوا من قدرة لنفي وجود الكرد: بشراً وحجراً وأرضاً، متوسلين لإثبات أو تجسيد هذه الرغبة، كل ما مالكت أيديهم وعقولهم وقلوبهم من براهين ومراجع تاريخية ووقائع وتضليل سياسي وتاريخي واعلامي وتهجير وسيانيد!
فهل سيتلقى العالم كل ما ذهبوا إليه في هذا المجال بالسخرية؟!
قد يكون الجواب: نعم، وقد يكون :لا.
من يدري؟ وقد لا يكون هذا ولا ذاك!!
فمازالت المخيلة المتورمة ذاتها تطرح صوراً مختلفة للكرد ذاتهم للقصد ذاته.
هل يحتاج الأمر إلى مراجعة وعودة إلى الماضي؟
إذا كان هدف العود إعادة تصحيح المسار.
فهو أحمد ولاشك.
حين كانت الجن حاضرة في الزوايا المعتمة من الأماكن والعقول، وكانت العفاريت والأشباح تطارد البشر وتُقلق راحتهم، أبدعت المخيلة التي لا تتخيل للكرد وجوداً يوازي وجودها ويضارعها، أنساباً يختلط فيها الحقيقي بالوهمي والأسطوري بالخرافي، وتُعد طرفة انتساب الكرد للجن من أولى نتاجات تلك المخيلة، وكي لا أُتهم بالشطط وعقدة الاضطهاد، أقول ربما كان السبب في ذلك أن الجن قوم لا ينتمون إلى هذا العالم، وليست لديهم أرض واقعية يسكنون عليها مثل بقية الأقوام، فأرضهم في مكان آخر غير هذا المكان أو حتى العالم، فمن الطبيعي، والحال هذه، أن يكون الكُرد، مثل أسلافهم الجن، موجودون في الحقيقة وغير موجودين في الواقع!
وحين تغير الزمن وتبدلت الأحوال، وبدأ العالم يفرق بين عزيف الجن ولغة البشر، وبين حكايات الأشباح وفعل التشبيح، بل وحين أصبح الحديث عن الجن غير لائق بكل منتم للحضارة والعصر، وأصبح للشعوب مسكناً اسمه الوطن وليس وادي عبقر أو الموت، وسادت أوطان واُغتصبت أوطان، اجتهدت تلك المخيلة في إيجاد نسب آخر للكرد، بل أنساب، امتدت هذه المرة إلى الخارطة الوراثية وليس التاريخية والجغرافية كما فعلت في زمن مضى، فأبدعت للكُرد أصولاً لا ترجع إلى أرومة واحدة كما حين كانوا أبناءً للجن، وقد جاء ذلك نتيجة، وبالتزامن مع، توزيع بلاد الكُرد كعكة جغرافية على بلاد الطوق الكردي، فكان من الصعب، والحال هذه، على الفائزين بهذه الكعكة أن يقتلعوا منها سكانها المغروزين فيها مثل جبالهم العالية وأنهارهم الغزيرة، فأبدعت مخيلتهم تشريد الاسماء بدلاً من مسمياتها، وذلك بقصد نفي وجود أصحابها؛ اسماء مدناً وقرى وقبائل وأنساباً وبشراً، فأصبحت هوازن، لا بوطان أو برزان مثلاً هي من تناسل عنها كُرد جزء من تلك الكعكة، وأتراك الجبال اسماً للكُرد في جزء آخر، وأبناء عم ضالين في جزء ثالث، وإن من جاؤوا مع تلك الكعكة في جزئها الرابع ليسوا سوى كائنات تدحرجت في غفلة تاريخية من جبال الجزء المتاخم له، ولن نندهش في زمن قادم، حين تتحول فيه قصص الخيال العلمي إلى واقع معيش، ونشاهد سكان كواكب أخرى يتجولون في مدن كوكبنا الأرضي، وشوارع مدننا، لن نندهش حينها من سماع من يتحدث عن الكُرد على أنهم كائنات قادمة من كوكب آخر خارج المجموعة الشمسية، أو مسافرون جاؤوا من زمن منفلت من السيرورة هو زمن غير زمننا هذا!!
وحين مرت السنون وتتالت المراحل وتبدلت المعالم التاريخية، وظل الكُرد كُرداً ولم يصبحوا من قوم هوازن أو عدنان أو أتراك الجبال أو أبناء عم ضالين، أو قوم طارئ على الجغرافيا والتاريخ، وحين أصبح للربيع في هذه المنطقة عربة يجوب بها كل الأوطان التي امتد فيها التصحر من الطبيعة إلى القلوب والعقول، وفي هذا الزمن أيضاً أبدعت المخيلة ذاتها، فيما أبدعت، في هذا الربيع القارس، حيلاً لا حلولاً، تعترف بالكردي كفرد من مجموع مجتمع متعدد، له ما له وعليه ما عليه من واجبات وحقوق، لقيط تاريخي بلا هوية اجتماعية، وغصن مكسور من شجرة انتمائه القومي.
ثم اجتهدت في تقديم اعتراف آخر بالأكراد كمجموعات بشرية لا بالكُرد في مجتمع له خصوصياته وعلاماته الفارقة، البسيطة ولكن الواضحة والمميزة، ثم وفي زمن أصبحت الساعة فيه تسير على عجلات الأحداث المتسارعة، علا صوت من المخيلة ذاتها يعترف بالكُرد شريكاً في الوطن كأقلية قومية وليس كشعب؛ تكون القومية الغالبة فيه سكانياً وليس المتفوقة حضارياً، سيدة لهذه الأقلية ووصية عليها.
ومن آخر نتاجات هذه المخيلة الاعتراف بالكُرد شعباً وليس أقلية أو تجمعاً بشرياً، ولكن ذلك الشعب الضيف على الوجود، السياسي وغير السياسي، لا العضو الدائم كغيره من شعوب هذه القرية الكونية، حتى ممن هو أكثر منها عدداً، وممن هي أحدث منه ولادة أو ظهوراً تاريخاً.
قد لا يكون كل ما سبق من كلام جديداً لمن رأى وسمع عن الكُرد في بلادهم المشطورة إلى أربعة أقسام كقطعة حلوى، فلم يعد الأمر بعد كل هذا الزمن من دوام الحال واستمرار الايهام بحقيقته مثار السخرية ولا الحزن أو حتى التعاطف،
غير أن الجديد دائماً، هو تماهي الكُرد مع مناخات هذه المخيلة وتكرارهم ردَّ الفعل نفسه باستمرار، وبشكل مساو له في القوة والشدة ومعاكس له في الاتجاه.
والمتجاوز له في بعض الأحيان!!
ردّ فعل عاطفي وانفعالي لا فعل عقلي حقيقي.
مشهد تراجيدي لا يكفُّ عن التكرار، وجدل بيزنطي في ماركة محلية.
والنتيجة..
اجترار سياسي، واستنزاف للطاقات والجهود وإضاعة للزمن والفرص.
هنا بالذات يصبح العود أحمد،
عودة لا تكتفي بمراجعة “ابداعات” تلك المخيلة وما تمخض عنها، بل بمراجعة دفاتر يوميات “نخبهم” السياسية والثقافية والفكرية..
والميدانية حالياً، مراجعة تبدأ من الواقع لا من الأوهام، ومن البديهيات والمسلمات لا من الجدل العقيم، والعمل على صياغة الاسئلة المتعلقة بوجودهم ومستقبلهم بعيداً عن مناخات المصائد وطبيعة الفخاخ المنصوبة لهم من قبل هواة ومحترفي رمي الكُرد في المياه العكرة لتسهيل عملية اصطيادهم ومشاركتهم في جعل السهام الموجهة إليهم؛ إلى عقولهم وقلوبهم لا تخطئ هدفها.
حينها فقط سيصبح الحديث عن الفعل لا رد الفعل، وعن فعل التلقي المنتظر، المناسب والفاعل للآخرين، أو حتى رد الفعل الساخر من أوهام ونتاجات مخيلة مريضة، وأيدي غير نظيفة.
ممكناً و منطقياً.
ليس رد الفعل إلا حركة روح محتضرة وفعل آلي.
أما الفعل فهو من خصائص الأحيّاء وصفات الكائنات العاقلة، ذلك الفعل الذي يؤكد أننا فاعلون لأننا بشر أسوياء ولسنا كائنات غافلة أو أدوات طيعة بيد أحد:
أيّ أحد.
a.smail1961@gmail.com