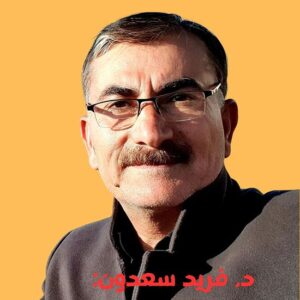هوشنك بروكا
هوشنك بروكامن المعروف أنّ “السلفية” كإصطلاح ديني، هي منهج إسلامي، ماضوي، رجعي(من الرجوع إلى الوراء) يدعو إلى “إسلام النقل” أو ما أسميه ب”إسلام الوراء”، أي إلى فهم القرآن وما حوله من سنة نبوية، من خلال فهم السلف.
عليه فإنّ لا إسلام، حسب سنّة السلفيين، خارج إسلام السلف، ولا فهم فوق فهمه، لأنه “إسلام أصيل”، مؤسس على “الدين الأصل”، و”الله الأصل”، و”النبيّ الأصل”، و”النص الأصل”، و”الفهم الأصل”، و”الروح الأصل”..إلخ.
عليه فإنّ لا إسلام، حسب سنّة السلفيين، خارج إسلام السلف، ولا فهم فوق فهمه، لأنه “إسلام أصيل”، مؤسس على “الدين الأصل”، و”الله الأصل”، و”النبيّ الأصل”، و”النص الأصل”، و”الفهم الأصل”، و”الروح الأصل”..إلخ.
دعاة هذا التيار الإسلامي النصوصي، النقلي، المتشدد، يريدون إعادة العالم، مكاناً وزماناً، إلى “الإسلام السلف”، أي إسلام الرسول وصحابته، الراجع إلى ما قبل 1433 عاماً.
من هنا، تراهم يسعون بكلّ ما أوتوا من قوةٍ، للخروج السلفي من العالم، حاضراً ومستقبلاً، لأجل الدخول النهائي في الماضي، كمستقرٍّ نهائي؛ أي الإستقرار والإستغراق في ماضي الإسلام، وماضي رسوله، وكتبه، وصحابته، بكلّ شروحه وتفاسيره، وكلّ تفاصيل حياته، وقيامه وقعوده.
فالحاضر والمستقبل، بالنسبة لهؤلاء السلفيين الماضويين، لا يساوي شيئاً، لأن الماضي السلف، بحسبهم، هو كلّ شيء، كلّ العالم في كلّ الإسلام، وكلّ الإسلام في كلّ العالم.
فإن أراد العالم أن يكون كلّ الحضارة، وكلّ الثقافة، وكلّ الإجتماع، وكلّ السياسة، وكلّ الأخلاق، وكلّ الفلسفة، وكلّ الدين، فليس أمامه والمقيمين فيه، بحسب دعاة “منهج السلف”، إلا العودة إلى ذاك الإسلام السلف، والدخول فيه، من أول الدنيا إلى آخرها.
المتابع للمشهد الإيزيدي، ثقافةً واجتماعاً وسياسةً، سيرى رغم الإختلاف الكبير بين الإسلام والإيزيدية، زماناً ومكاناً، تاريخاً وجغرافيا، سماءً وأرضاً، أنّه مشهدٌ لا يخلو من “السلفية” و”السلفيين”، وما بينهم من دينٍ ماضٍ، وشريعةٍ ماضية، وحدودٍ وسدودٍ ماضيات.
والغريب في هذا “المنهج السلفي” إيزيدياً، هو انتهاجه من قبل “النخبة المثقفة” وما تحتهم من “مؤسسات ثقافية”، كان من المفترض بها أن تؤسس للثقافة في الأمام، قبل أن تؤسس للدين في الوراء.
لا عتب بالطبع، في ذلك، على رجال الدين.
فهؤلاء معنيون بالدين والبحث عن السعادة في السماء، قبل الدنيا والبحث عن سعادتها على الأرض.
لكنّ العتبَ، هو على “أهل الثقافة” ممّن يلقون علينا، في هذا الفضاء الإنترنتي الحرّ، دروساً في أحدث ما أنتجته الحداثة وما بعدها، من ديمقراطيات وحريات وحقوق، لكنهم يفعلون كما “فعلت الآلهة في الزمان القديم”، على حدّ قول الإسطورة الهندية.
العتبُ أولاً وآخراً، هو على هؤلاء من “جماعة الإخوان المثقفين”، حين يتخذون من الدين، في كونه حلاًّ كليّاً لكلّ الدنيا، ويعتقلون العقل بالنقل، ويسجنون الحاضر والمستقبل في الماضي، ودنيا الإيزيديين في دينهم، ويربطون قانون الطبيعة بقانون الدين، والعلم الوضعي ب”علم شيخادي”، ويصرّون على الدخول في الحداثة وما بعدها، من أوسع أبوابها على “سجادة” شيخادي.
العتبُ، كلّ العتب هو على هؤلاء من “جماعة المثقفين الدينيين”، حين يقسمون المكتوب في دينهم إلى “مكتوب معلوم حلال” و”مكتوب نكرة حرام”، و”يفتون” بهدر دم هذا المكتوب وذاك، ويهددون ب”قطع” كلّ يدٍ كاتبة تطال “الممنوعات” و”المحظورات” التي “أنزلها” الله عليهم، منذ فجر الخليقة، كما يقولون.
العتبُ، كلّ العتب هو على هؤلاء من “جماعة المثقفين المتديّنين” الذين يختزلون الثقافة إلى صومعةٍ للعبادة، والدنيا إلى عربةٍ ليس لها إلا أن تتبع حصان الدين.
من يتحدث في الحداثة وما بعدها، وفي حقوق الإنسان وما حولها من حرياتٍ وديمقراطيات، عليه أن يعلم أنّ الكتابة في الدين ليست ديناً، والبحث في الدين و”علومه”، لا يعني بالضرورة بحثاً عنه وعن آلهته، والدراسة في الدين، ليست تدريساً أو تعليماً لأصوله، ولا ترخيصاً بحلاله أو حرامه.
التخصص في علوم الدين والإلهيات متابعةً ودراسةً وفحصاً وتمحيصاً، لا يعني بالضرورة التخصص في أداء الدين، وما حوله من عقائد وعبادات وفروضٍ، من صلاةٍ وصومٍ وحجٍّ وزكاةٍ وأمرٍ بالمعروف ونهيٍّ عن المنكر، على طريقة الميتين في الدين.
أما التفكير في نقد الدين، فلا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن يكون “تكفيراً”، كما هو حاصل في العموم، ويريد البعض الديني الأكبر لذلك أن يكون.
نقد الدين، ضرورة إنسانية ملحّة، وإلا سيخرج الدين عن الإطار، في كونه ديناً من الإنسان ضد الإنسان.
نقد الدين ضرورة تاريخية، وإلا سيخرج الدين عن التاريخ، ليصير إلى ماضٍ فحسب، بدون حاضرٍ ولا مستقبل.
نقد الدين، ضرورة سوسيولوجية، حياتية، وإلا سيخرج الدين عن حياة البشر، ليصير إلى “هروبٍ مقدس” إلى اللاحياة، أو “مجرد هدف” فوق الحياة، بدلاً من أن يكون وسيلةً من وسائل الإجتماع والألفة والمحبة بين الناس.
نقد الدين ضرورة حضارية، ثقافية، وإلا سيخرج الدين عن ثقافة البشر، ليتحوّل من “ثقافة لأجل الإنسان”، إلى “ثقافة ضد الإنسان”، ومن “ثقافة في الثقافة” إلى “ثقافة خارج أو ضد الثقافة.”
ما نسمعه ونقرأه ونشاهده، هذه الأيام، في المشهد الثقافي الإيزيدي، فيه من التكفير أكثر من التفكير، ومن النقل أكثر من العقل، ومن الفتوى أكثر من القانون، ومن “الضرورة” أكثر من الحرية، ومن “ثقافة الله” أكثر من ثقافة الإنسان، ومن الميتافيزقيا أكثر من الفيزيقيا، من الدين المقفل أكثر من الثقافة المفتوحة.
ما نقرأه ل”جماعة الأخوان المثقفين”(مع حفظ الألقاب واحترامي للكلّ)، هذه الأيام، من حجبٍ ومنعٍ وردعٍ وتكفيرٍ وتحقيرٍ للرأي الآخر المختلف مع طريقة أيمانهم في تفكيرهم، أو طريقة تفكيرهم في إيمانهم، هو مشكلة بحدّ ذاتها، أكثر من أن يكون حلاًّ، إذ فيه من “الضرورة الدينية” أكثر من الحرية.
ما يُكتب وينشر ويهوّل له هذه الأيام، إيزيدياً، تُشتم منه رائحة الفتوى والإرهاب التكفير بحق حرية التفكير.
ليس هناك، في عالم اليوم المفتوح على الحريّة، “مؤمن” و”كافر”، أو “متدين” و”ملحد”، كما يشتهي البعض الإيزيدي، تصنيف الإيزيديين إلى “إيزيديين حلال” و”إيزيديين حرام”، على طريقة أهل السلف وإسلامهم المتشدد، الذين يقسمون العالم إلى “دار السلام”(الإسلام) و”دار الحرب”.
الدينُ رابطة روحية بين الفرد وإلهه.
يدخل فيه من يشاء ويخرج منه من يشاء.
الدين، ليس “بطاقة حسن سلوكٍ”، كما قد يُتصور، كي تمنحها هذه الجهة الدينية أو تلك، لهذا الإنسان أو ذاك.
الدين، ليس “صكأً للغفران”، كما كانت تفعله الكنيسة في عصور أوروبا المظلمة.
الدين، لا يُمنح ولا يُحجب؛ لا يُعطى ولايُؤخذ؛ لايُسمح ولا يُمنع.
وإنما هو علاقة جدّ فردية، طوعية، حرّة، بين العابد والمعبود، ليس من حق أيّ إنسانٍ أيّاً كان، أن يحكم على هذه العلاقة، بإعتباره “ظلاًّ لله”، “وكيلاً” له على الأرض.
من يخاف على دينه، يعني أنه يخاف على الله، ومن يخاف على الله، يعني أنه “يشك” في قدرته، والشك في أن يكون الله قدرته، يعني الشك في أن يكون الله وجوده.
من هنا لا داعي، لهؤلاء من “جماعة الإخوان المثقفين الإيزيديين” الخوف على إيزيديتهم، أو إيمانهم، “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، والله قادرٌ على أن يعطي لكلّ ذي حق حقه، وأن يحاسب “المؤمنٍ” على قدر إيمانه، و”الكافرٍ” على قدر كفره، “فالله أعلم بمن ضلّ سبيله وهو أعلم بالمهتدين”(النحل: 125).
الحرية أكبر من الدين.
هكذا يقول لنا التاريخ؛ تاريخ الدين وتاريخ الدنيا على حدٍّ سواء.
الحرية أعلى من الدين، هكذا تقول لنا دساتير الدول الوضعية المدنية الحديثة، التي تفصل بين “قانون الله” في السماء و”قانون الإنسان” على الأرض، وبين “دين الله” و”دنيا الدولة”، التي لا دين فيها يعلو على دين الإنسان.
ما نشهده من تقدّم معرفي وتكنولوجي هائل، في عالم اليوم المفتوح على أقصى حريته، لم يأتِ بفعل “الضرورات الدينية”، وإنما أتى بفعل الحرّية؛ كلّ الحرية لكلّ البشر، دينيين ولا دينيين، روحانيين ولاروحانيين، مقدسين و”مدنسين”.
ما نشهده اليوم من حداثة وما بعدها، لم يأتينا بفعل “الإنسحاب إلى الوراء”، أو “الإنسحاب من العالم”، أو “الخروج من التاريخ”، كما يريد الدين لأهله دائماً أن يكونوا، وإنما أتانا بفعل الدخول الفاعل والحرّ، في العالم وفي التاريخ.
ما نسمعه اليوم من “تكفيرٍ إيزيدي” من جهة بعضٍ من “الإخوان المثقفين الإيزيديين” لتفكير إيزيديين آخرين من بني جلدتهم، يذكّرني ب”فتاوى” شيوخ الإسلام الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها بمجرّد هبوب بعض ريحٍ ثقافية، ناقدة، على إيمانهم، إذ سرعان ما تراهم يفتون بهدر دماء هذا المثقف والكاتب والناقد وذاك، وإعلانهم ك”شياطين خارجية” يهددون “وجود” الله ومؤمنيه في الداخل المسلم.
طالما الأمر يتعلق بسجن الدنيا في الدين، وبحجب حرية التعبير لضرورة “حرية” الدين، وطالما أنّ الدين هناك يشبه الدين ههنا، والمفتي هناك يكاد يكون ذات المفتي ههنا، سأقتبس بعضاً من مقالٍ، نشرته إيلاف قبل سنوات، انتقدت فيه ذات الفتوى وذات الدين(بإعتبار أنّ “الدين السلف”، أياً كان هذا الدين ولأيٍّ كان، لجهة حجبه للحرية، هو في نظري واحدٌ) للدفاع عن ذات الحرية(حرية التعبير).
لقراءة المقال كاملاً:
http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2007/7/246034.htm?sectionarchive=ElaphWriter
ولأنني أريد أن أكون ذات العقل ضد ذات النقل: نقل “الإسلام السلفي” الخارج على التاريخ هناك، ونقل “السلفية الإيزيدية” ههنا، سأقتبس الآتي:
المشكل الأساس في ثقافة الشرق المسلم، هو أن العالم كله يُفهم ويُنظر إليه، من خلال ثنائية الله/ الشيطان، الله الأكبر/ الشيطان الأكبر، رأس الإيمان/ رأس الكفر، مؤمن/كافر، مسلم/مرتد، أولاد الأصول/ أولاد البدع والقردة والخنازير، معي/ ضدي، دار السلم/دار الحرب، خير أمة/ شرّ أمة، أمة الله/ أمة الشيطان، جنة/ جهنم…الخ.
من هنا، تراهم يسعون بكلّ ما أوتوا من قوةٍ، للخروج السلفي من العالم، حاضراً ومستقبلاً، لأجل الدخول النهائي في الماضي، كمستقرٍّ نهائي؛ أي الإستقرار والإستغراق في ماضي الإسلام، وماضي رسوله، وكتبه، وصحابته، بكلّ شروحه وتفاسيره، وكلّ تفاصيل حياته، وقيامه وقعوده.
فالحاضر والمستقبل، بالنسبة لهؤلاء السلفيين الماضويين، لا يساوي شيئاً، لأن الماضي السلف، بحسبهم، هو كلّ شيء، كلّ العالم في كلّ الإسلام، وكلّ الإسلام في كلّ العالم.
فإن أراد العالم أن يكون كلّ الحضارة، وكلّ الثقافة، وكلّ الإجتماع، وكلّ السياسة، وكلّ الأخلاق، وكلّ الفلسفة، وكلّ الدين، فليس أمامه والمقيمين فيه، بحسب دعاة “منهج السلف”، إلا العودة إلى ذاك الإسلام السلف، والدخول فيه، من أول الدنيا إلى آخرها.
المتابع للمشهد الإيزيدي، ثقافةً واجتماعاً وسياسةً، سيرى رغم الإختلاف الكبير بين الإسلام والإيزيدية، زماناً ومكاناً، تاريخاً وجغرافيا، سماءً وأرضاً، أنّه مشهدٌ لا يخلو من “السلفية” و”السلفيين”، وما بينهم من دينٍ ماضٍ، وشريعةٍ ماضية، وحدودٍ وسدودٍ ماضيات.
والغريب في هذا “المنهج السلفي” إيزيدياً، هو انتهاجه من قبل “النخبة المثقفة” وما تحتهم من “مؤسسات ثقافية”، كان من المفترض بها أن تؤسس للثقافة في الأمام، قبل أن تؤسس للدين في الوراء.
لا عتب بالطبع، في ذلك، على رجال الدين.
فهؤلاء معنيون بالدين والبحث عن السعادة في السماء، قبل الدنيا والبحث عن سعادتها على الأرض.
لكنّ العتبَ، هو على “أهل الثقافة” ممّن يلقون علينا، في هذا الفضاء الإنترنتي الحرّ، دروساً في أحدث ما أنتجته الحداثة وما بعدها، من ديمقراطيات وحريات وحقوق، لكنهم يفعلون كما “فعلت الآلهة في الزمان القديم”، على حدّ قول الإسطورة الهندية.
العتبُ أولاً وآخراً، هو على هؤلاء من “جماعة الإخوان المثقفين”، حين يتخذون من الدين، في كونه حلاًّ كليّاً لكلّ الدنيا، ويعتقلون العقل بالنقل، ويسجنون الحاضر والمستقبل في الماضي، ودنيا الإيزيديين في دينهم، ويربطون قانون الطبيعة بقانون الدين، والعلم الوضعي ب”علم شيخادي”، ويصرّون على الدخول في الحداثة وما بعدها، من أوسع أبوابها على “سجادة” شيخادي.
العتبُ، كلّ العتب هو على هؤلاء من “جماعة المثقفين الدينيين”، حين يقسمون المكتوب في دينهم إلى “مكتوب معلوم حلال” و”مكتوب نكرة حرام”، و”يفتون” بهدر دم هذا المكتوب وذاك، ويهددون ب”قطع” كلّ يدٍ كاتبة تطال “الممنوعات” و”المحظورات” التي “أنزلها” الله عليهم، منذ فجر الخليقة، كما يقولون.
العتبُ، كلّ العتب هو على هؤلاء من “جماعة المثقفين المتديّنين” الذين يختزلون الثقافة إلى صومعةٍ للعبادة، والدنيا إلى عربةٍ ليس لها إلا أن تتبع حصان الدين.
من يتحدث في الحداثة وما بعدها، وفي حقوق الإنسان وما حولها من حرياتٍ وديمقراطيات، عليه أن يعلم أنّ الكتابة في الدين ليست ديناً، والبحث في الدين و”علومه”، لا يعني بالضرورة بحثاً عنه وعن آلهته، والدراسة في الدين، ليست تدريساً أو تعليماً لأصوله، ولا ترخيصاً بحلاله أو حرامه.
التخصص في علوم الدين والإلهيات متابعةً ودراسةً وفحصاً وتمحيصاً، لا يعني بالضرورة التخصص في أداء الدين، وما حوله من عقائد وعبادات وفروضٍ، من صلاةٍ وصومٍ وحجٍّ وزكاةٍ وأمرٍ بالمعروف ونهيٍّ عن المنكر، على طريقة الميتين في الدين.
أما التفكير في نقد الدين، فلا يمكن بأيّ حالٍ من الأحوال أن يكون “تكفيراً”، كما هو حاصل في العموم، ويريد البعض الديني الأكبر لذلك أن يكون.
نقد الدين، ضرورة إنسانية ملحّة، وإلا سيخرج الدين عن الإطار، في كونه ديناً من الإنسان ضد الإنسان.
نقد الدين ضرورة تاريخية، وإلا سيخرج الدين عن التاريخ، ليصير إلى ماضٍ فحسب، بدون حاضرٍ ولا مستقبل.
نقد الدين، ضرورة سوسيولوجية، حياتية، وإلا سيخرج الدين عن حياة البشر، ليصير إلى “هروبٍ مقدس” إلى اللاحياة، أو “مجرد هدف” فوق الحياة، بدلاً من أن يكون وسيلةً من وسائل الإجتماع والألفة والمحبة بين الناس.
نقد الدين ضرورة حضارية، ثقافية، وإلا سيخرج الدين عن ثقافة البشر، ليتحوّل من “ثقافة لأجل الإنسان”، إلى “ثقافة ضد الإنسان”، ومن “ثقافة في الثقافة” إلى “ثقافة خارج أو ضد الثقافة.”
ما نسمعه ونقرأه ونشاهده، هذه الأيام، في المشهد الثقافي الإيزيدي، فيه من التكفير أكثر من التفكير، ومن النقل أكثر من العقل، ومن الفتوى أكثر من القانون، ومن “الضرورة” أكثر من الحرية، ومن “ثقافة الله” أكثر من ثقافة الإنسان، ومن الميتافيزقيا أكثر من الفيزيقيا، من الدين المقفل أكثر من الثقافة المفتوحة.
ما نقرأه ل”جماعة الأخوان المثقفين”(مع حفظ الألقاب واحترامي للكلّ)، هذه الأيام، من حجبٍ ومنعٍ وردعٍ وتكفيرٍ وتحقيرٍ للرأي الآخر المختلف مع طريقة أيمانهم في تفكيرهم، أو طريقة تفكيرهم في إيمانهم، هو مشكلة بحدّ ذاتها، أكثر من أن يكون حلاًّ، إذ فيه من “الضرورة الدينية” أكثر من الحرية.
ما يُكتب وينشر ويهوّل له هذه الأيام، إيزيدياً، تُشتم منه رائحة الفتوى والإرهاب التكفير بحق حرية التفكير.
ليس هناك، في عالم اليوم المفتوح على الحريّة، “مؤمن” و”كافر”، أو “متدين” و”ملحد”، كما يشتهي البعض الإيزيدي، تصنيف الإيزيديين إلى “إيزيديين حلال” و”إيزيديين حرام”، على طريقة أهل السلف وإسلامهم المتشدد، الذين يقسمون العالم إلى “دار السلام”(الإسلام) و”دار الحرب”.
الدينُ رابطة روحية بين الفرد وإلهه.
يدخل فيه من يشاء ويخرج منه من يشاء.
الدين، ليس “بطاقة حسن سلوكٍ”، كما قد يُتصور، كي تمنحها هذه الجهة الدينية أو تلك، لهذا الإنسان أو ذاك.
الدين، ليس “صكأً للغفران”، كما كانت تفعله الكنيسة في عصور أوروبا المظلمة.
الدين، لا يُمنح ولا يُحجب؛ لا يُعطى ولايُؤخذ؛ لايُسمح ولا يُمنع.
وإنما هو علاقة جدّ فردية، طوعية، حرّة، بين العابد والمعبود، ليس من حق أيّ إنسانٍ أيّاً كان، أن يحكم على هذه العلاقة، بإعتباره “ظلاًّ لله”، “وكيلاً” له على الأرض.
من يخاف على دينه، يعني أنه يخاف على الله، ومن يخاف على الله، يعني أنه “يشك” في قدرته، والشك في أن يكون الله قدرته، يعني الشك في أن يكون الله وجوده.
من هنا لا داعي، لهؤلاء من “جماعة الإخوان المثقفين الإيزيديين” الخوف على إيزيديتهم، أو إيمانهم، “فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر”، والله قادرٌ على أن يعطي لكلّ ذي حق حقه، وأن يحاسب “المؤمنٍ” على قدر إيمانه، و”الكافرٍ” على قدر كفره، “فالله أعلم بمن ضلّ سبيله وهو أعلم بالمهتدين”(النحل: 125).
الحرية أكبر من الدين.
هكذا يقول لنا التاريخ؛ تاريخ الدين وتاريخ الدنيا على حدٍّ سواء.
الحرية أعلى من الدين، هكذا تقول لنا دساتير الدول الوضعية المدنية الحديثة، التي تفصل بين “قانون الله” في السماء و”قانون الإنسان” على الأرض، وبين “دين الله” و”دنيا الدولة”، التي لا دين فيها يعلو على دين الإنسان.
ما نشهده من تقدّم معرفي وتكنولوجي هائل، في عالم اليوم المفتوح على أقصى حريته، لم يأتِ بفعل “الضرورات الدينية”، وإنما أتى بفعل الحرّية؛ كلّ الحرية لكلّ البشر، دينيين ولا دينيين، روحانيين ولاروحانيين، مقدسين و”مدنسين”.
ما نشهده اليوم من حداثة وما بعدها، لم يأتينا بفعل “الإنسحاب إلى الوراء”، أو “الإنسحاب من العالم”، أو “الخروج من التاريخ”، كما يريد الدين لأهله دائماً أن يكونوا، وإنما أتانا بفعل الدخول الفاعل والحرّ، في العالم وفي التاريخ.
ما نسمعه اليوم من “تكفيرٍ إيزيدي” من جهة بعضٍ من “الإخوان المثقفين الإيزيديين” لتفكير إيزيديين آخرين من بني جلدتهم، يذكّرني ب”فتاوى” شيوخ الإسلام الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها بمجرّد هبوب بعض ريحٍ ثقافية، ناقدة، على إيمانهم، إذ سرعان ما تراهم يفتون بهدر دماء هذا المثقف والكاتب والناقد وذاك، وإعلانهم ك”شياطين خارجية” يهددون “وجود” الله ومؤمنيه في الداخل المسلم.
طالما الأمر يتعلق بسجن الدنيا في الدين، وبحجب حرية التعبير لضرورة “حرية” الدين، وطالما أنّ الدين هناك يشبه الدين ههنا، والمفتي هناك يكاد يكون ذات المفتي ههنا، سأقتبس بعضاً من مقالٍ، نشرته إيلاف قبل سنوات، انتقدت فيه ذات الفتوى وذات الدين(بإعتبار أنّ “الدين السلف”، أياً كان هذا الدين ولأيٍّ كان، لجهة حجبه للحرية، هو في نظري واحدٌ) للدفاع عن ذات الحرية(حرية التعبير).
لقراءة المقال كاملاً:
http://www.elaph.com/Web/ElaphWriter/2007/7/246034.htm?sectionarchive=ElaphWriter
ولأنني أريد أن أكون ذات العقل ضد ذات النقل: نقل “الإسلام السلفي” الخارج على التاريخ هناك، ونقل “السلفية الإيزيدية” ههنا، سأقتبس الآتي:
المشكل الأساس في ثقافة الشرق المسلم، هو أن العالم كله يُفهم ويُنظر إليه، من خلال ثنائية الله/ الشيطان، الله الأكبر/ الشيطان الأكبر، رأس الإيمان/ رأس الكفر، مؤمن/كافر، مسلم/مرتد، أولاد الأصول/ أولاد البدع والقردة والخنازير، معي/ ضدي، دار السلم/دار الحرب، خير أمة/ شرّ أمة، أمة الله/ أمة الشيطان، جنة/ جهنم…الخ.
مشكلة الشرق المسلم، هو أن الدين يشرّع، ويحكم، ويحرّض الجمهور، ويسخِّن الشارع، ويحمّي الرؤوس، ويجند النصوص، ويدافع عن الله نيابةً عنه، ويكفّر من يشاء، ويشيطن من يشاء، ويفصّل الحاضر على مقاس الماضي، أنى وأين يشاء.
الشرق المشكل، في بعضه، هو الشرق الممنوع من التعبير، والممنوع من الإختلاف، والممنوع من التغريد خارج السرب، والممنوع من الخروج على القطيع.
الشرق المشكل، في بعضه، هو الشرق الممنوع من التعبير، والممنوع من الإختلاف، والممنوع من التغريد خارج السرب، والممنوع من الخروج على القطيع.
على خلفية الرسوم الكاريكاتورية للفنان الدانماركي “مارتين روزينكارد كنودسين” التي نُشرت في صحيفة “يولاندس بوستن” الدانماركية، قامت الدنيا ولم تُقعد، سحبت بعض الدول سفاراتها من دولة الدانمارك وقوطعت منتجاتها، دخلت أوربا في حالة استنفار قصوى، جدد المجاهدون وأمراء حروبهم ويلهم وثبورهم،بالثأر لشرف النبي، وذلك بضرب “الصليبيين الكفار” و”المتحالفين مع الشيطانين الأكبر والأصغر”، في عقر دارهم…الخ.
ولكن، من سمع من هذا الشرق المسلم، الغيور على الله ونبيه، بالفنان البولندي دوروتا نيزنالسكا Dorota Nieznalska في 2003 الذي رسم صورة العضو الذكري على الصليب؟
ماذا يعني ركوب العضو الذكري على الصليب، بالنسبة للمؤمن المسيحي؟
أليس الصليب هو الرمز الأقدس، لتحيين المسيح ومعاناته؟
أليس الصليب هو بعضٌ من تحضير الله رمزياً، لإعتقاد أتباعه، بأن يسوع هو الإبن النوراني لله؟
ثم مَن من أتباع الصليب ويسوعه، أصدر فرماناً من الكنيسة، بضرورة قتل هذا الفنان أو التعرض لحياته بأذى أو مكروه؟
مَن من القائمين على شئون الكنيسة، في عموم العالم المسيحي، حاول القفز على القانون المدني والدولة، لصك قانون ديني كنيسي، بهدف حكم الفنان(الذي عَبَر صليبهم بعضوٍ ذكري) أو إدانته به؟
ماذا يعني ركوب العضو الذكري على الصليب، بالنسبة للمؤمن المسيحي؟
أليس الصليب هو الرمز الأقدس، لتحيين المسيح ومعاناته؟
أليس الصليب هو بعضٌ من تحضير الله رمزياً، لإعتقاد أتباعه، بأن يسوع هو الإبن النوراني لله؟
ثم مَن من أتباع الصليب ويسوعه، أصدر فرماناً من الكنيسة، بضرورة قتل هذا الفنان أو التعرض لحياته بأذى أو مكروه؟
مَن من القائمين على شئون الكنيسة، في عموم العالم المسيحي، حاول القفز على القانون المدني والدولة، لصك قانون ديني كنيسي، بهدف حكم الفنان(الذي عَبَر صليبهم بعضوٍ ذكري) أو إدانته به؟
ألم يسيء الصحفي جيرزي أوروبان، سنة 2005، إلى البابا يوحنا بولس الثاني، بإعتباره رأساً للكنيسة الكاثوليكية في العالم؟
ماذا كان رد فعل البابا والعالم المسيحي، عليه، آنذاك؟
من كان الحَكَم آنذاك، القانون أم الكنيسة، عالم القانون أم عالم الدين/اللاهوت؟
ماذا كان رد فعل البابا والعالم المسيحي، عليه، آنذاك؟
من كان الحَكَم آنذاك، القانون أم الكنيسة، عالم القانون أم عالم الدين/اللاهوت؟
عام 1960 طبعت رواية “آخر وسوسة للمسيح The Last Temptation of Christ” للمؤلف اليوناني نيكوس كازانتزاكس (1883 – 1957) وتحولت الرواية فيما بعد إلى فيلم سينمائي في عام 1988 وفيه يصور المسيح كنجار يصنع الصليب الذي كان الرومانيون يستعملونه لإنزال العقاب بالمخالفين للقوانين.
ويصور أيضا شخصية المسيح كإنسان عادي، عاش بشراً ومات.
وفي النهاية، يتزوج المسيح من مريم المجدلية بدلا من صلبه، كما هو معهود، حسب العهد الجديد.
صحيح أن الزعماء الدينيين في بعض الكنائس الغربية، قد شنّوا حملةً واسعةً ضد الفيلم، إلا أن القانون، كان له، في النهاية، الكلمة الفصل.
وأثارت القضية، في حينه، جدلاً فكرياً وفلسفياً كبيراً.
ويصور أيضا شخصية المسيح كإنسان عادي، عاش بشراً ومات.
وفي النهاية، يتزوج المسيح من مريم المجدلية بدلا من صلبه، كما هو معهود، حسب العهد الجديد.
صحيح أن الزعماء الدينيين في بعض الكنائس الغربية، قد شنّوا حملةً واسعةً ضد الفيلم، إلا أن القانون، كان له، في النهاية، الكلمة الفصل.
وأثارت القضية، في حينه، جدلاً فكرياً وفلسفياً كبيراً.
الفنان الأمريكي “اندريس سيررانو Andres Serrano” في عام 1987 بال على لوحةٍ له سماها ب”البول على المسيح Piss Christ” واللوحة هي عبارة عن صورة للمسيح المصلوب، مغموسة في بول الفنان، حسب النقاد والمختصين في الشأن.
أحدثت لوحة “المسيح المغموس في البول” هذه، آنذاك، جدلا كبيرا بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن كل الجدال حُسم آخر المطاف والأخذ والرد، في حدود “حرية التعبير”، و”الرأي والرأي الآخر”.
أحدثت لوحة “المسيح المغموس في البول” هذه، آنذاك، جدلا كبيرا بين أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، ولكن كل الجدال حُسم آخر المطاف والأخذ والرد، في حدود “حرية التعبير”، و”الرأي والرأي الآخر”.
كل هؤلاء كانوا مواطنين من بلادٍ مسيحية، وعبّروا عن آرائهم في حدود ثقافة زمانهم ومكانهم، “ضد” أو مخالفين للمسيح، وصليبه، وللكتاب المقدس وقصصه، وللمسيحيين المؤمنين ومعتقداتهم.
ولكن كنيسةً واحدةً لم “تحلل” دم هؤلاء “المخالفين” لهم ولدينهم.
ولكن كنيسةً واحدةً لم “تحلل” دم هؤلاء “المخالفين” لهم ولدينهم.
هل يعلم الذين هللوا لهدر دم سلمان رشدي، أن فيلم “حياة برايان Life of Brian” الذي يروي قصة برايان/ المسيح بصورة كوميدية ساخرة، قد اختير عام 2000 (رغم إسلوبه النقدي اللاذع لشخصية المسيح) من قبل المجلة الفنية البريطانية Total Film كأحسن فيلم كوميدي بريطاني في التاريخ.
والحال، أليست بريطانيا التي سمحت، في حدود قوانينها، وأعرافها، وتقاليدها، وحرياتها، لصالاتها السينمائية بعرض ذاك الفيلم الذي “يبهدل” المسيح” كوميدياً، هي ذات بريطانيا التي كرّمت رشدي، بمنحه لقب “فارس”؟
ثم أيهما أخطر على الله وعلى البشر، على حدٍّ سواء، حدود حرية التعبير والتمثيل، أم حدود حرية القتل والتنكيل؟
أي طريقٍ هو أقرب للوصول إلى الله: طريق الكتاب، أم طريق الإرهاب؟
ألم يأمر الله عباده، بالقراءة لأنها أول الرسالة، وأول الكتاب، وأول الله؟
لماذا كل هذا الخوف من القراءة، والله ذكر في كتابه: “إقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
إقرأ وربك الأكرم.(العلق:1ـ3)
والحال، أليست بريطانيا التي سمحت، في حدود قوانينها، وأعرافها، وتقاليدها، وحرياتها، لصالاتها السينمائية بعرض ذاك الفيلم الذي “يبهدل” المسيح” كوميدياً، هي ذات بريطانيا التي كرّمت رشدي، بمنحه لقب “فارس”؟
ثم أيهما أخطر على الله وعلى البشر، على حدٍّ سواء، حدود حرية التعبير والتمثيل، أم حدود حرية القتل والتنكيل؟
أي طريقٍ هو أقرب للوصول إلى الله: طريق الكتاب، أم طريق الإرهاب؟
ألم يأمر الله عباده، بالقراءة لأنها أول الرسالة، وأول الكتاب، وأول الله؟
لماذا كل هذا الخوف من القراءة، والله ذكر في كتابه: “إقرأ باسم ربك الذي خلق.
خلق الإنسان من علق.
إقرأ وربك الأكرم.(العلق:1ـ3)
أخيراً، أقول أن لسلمان رشدي، ولكل من يسعى إلى التعبير أو “التنفيس” عن رأيه، حدود قصوى هي الكتاب، ولكن هل من حدودٍ للإرهاب؟
انتهى الإقتباس.
ما أشبه “السلفية” الإيزيدية بالسلفية الإسلامية، وما أشبه المفتي هنا بالمفتي هناك!
ما أشبه أهل تكفير التفكير هنا، بأهل ذات التكفير لذات التفكير هناك!
ما أشبه تراجيديا “أهل الآيات الإيزيدية” هنا، بتراجيديا “أهل الآيات الشيطانية” هناك.
بتراجيديا
ما أشبه “عقل النقل” هنا ب”عقل النقل” هناك!
وما أشبه اعتقال العقل هنا، بإعتقال العقل هناك!
عيشوا في الدين وما ورائه كما تريدون، واتركوا الآخرين في دنياهم يعيشون.
دعوا التفكير لأهله وادخلوا إيمانكم كما تؤمنون!
دعوا العقل يعيش ليفكّر، وموتوا في دينكم كما تشتهون!
دعوا العقل لحريته، واقفلوا الدين عليكم كما تشاؤون!