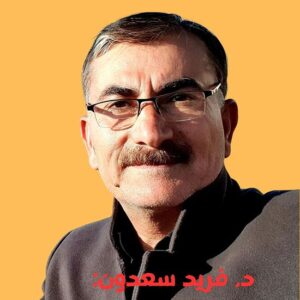حيدر عمر
حيدر عمرربما كان من المتفق عليه أن ما سُمِّي بثورات الربيع العربي في كل من تونس و مصر و ليبيا و اليمن و سوريا قد فاجأت الأنظمة في الدول الخمس مثلما فاجأت جميع قوى المعارضة فيها بالقدر نفسه، و أن الجماهير الشعبية استجابت لنداء الثورة قبل قوى المعارضة التي لم تستطع أن تتوحد حول ما بعد إسقاط تلك الأنظمة، و ما نراه من عدم الاستقرار في الدول التي انتصرت فيها الثورة يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك بأن قوى المعارضة قبل و أثناء الثورة لم تكن قد اتفقت على رؤية واضحة تحظى بالقبول لدى جميعها حول ما بعد السقوط.
وقد تغفر هذه المفاجأة لقوى المعارضة عدم وضوح رؤاها فيما يخص النظام الذي سوف تتباه بعد انتصار الثورة و الحلول الشافية لكل الأمراض التي خلفتها تلك الأنظمة.
ولكن أن تظل قوى المعارضة السورية في الدوامة نفسها رغم مرور ما يزيد على ستة و عشرين شهراً و الشهداء يتساقطون بالمئات كل يوم، و التدمير يطال كل مرافق الحياة في سوريا، و المدن السورية تفرغ من ساكنيها هرباً من الموت الذي يُلقى عليهم براً و جواً.
فإن الأمر لا يدعو إلى التفاؤل، و الحال هذه تصب في مصلحة النظام، و تصطف إلى جانب اللامبالاة الدولية في إطالة عمر النظام.
من المعروف أن للثورات برامجها، و المفاجأة التي أشرنا إليها لم تعد، بعد مرور كل هذه المدة و آلاف الضحايا و ملايين النازحين و اللاجئين إلى دول الجوار و غيرها،سبباً مقبولاً في افتقار الثورة و قوى المعارضة السورية إلى برنامج و رؤية واضحة لسوريا المستقبل، سوريا التي تضم فسيفساءً جميلاً من مكونات عرقية و طائفية متعددة و مشارب سياسية و فكرية مختلفة.
هذا التعدد الذي تتفق نحوه كل أطياف المعارضة كما هو واضح و جلي في خطابها، و تؤكده في جميع مؤتمراتها،، و لهذا لا تنفك تعيد إلى الأذهان سعيها إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على أنقاض الدولة الأمنية.
و لعل اسم الدولة يقف في قمة متطلبات هذا التعدد الاثني و الفكري و هذا التوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، مما يجعل تغيير اسم الدولة الحالي (الجمهورية العربية السورية) أمراً لا بد منه استجابة للواقع الذي تقره جميع أطياف المعارضة، و الهدف الذي ترنو إليه، بعيداً عن التشبث بالأغلبية معياراً، و تعبيراً عن ترجمة القول فعلاً، و هي ترجمة تشكِّل محكاً لصدق الطروحات النظرية.
فمثلما لا تشكِّل الأغلبية و الأقلية البرلمانية ضماناً لحقوق المواطنين دون دستور مدني يحدد سلطات كلا الجانبين في إطار الحق الكامل للمواطنة، وأن حكم الأكثرية لا يعني حرمان الأقلية في صنع القرار، بل يجب أن تساهم الأقلية أيضاً في صنع القرار في الدولة الديمقراطية الليبرالية، و أن الديمراطية التي تحكمها الأغلبية و لا تقوم على أساس ليبرالي تعرقل تحرر الأفراد و المجتمعات و تضيِّع حقوق الأقليات القومية و الدينية، لأن الديمقراطية الليبرالية تتطلب بناء المؤسسات الدستورية و القضائية قبل إجراء الانتخابات.
كذلك لا تعتبر الأغلبية معياراً في تسمية الدولة، لأن في ذلك تغييباً للأقليات التي تتضافر في النسيج الاجتماعي و الاثني للدولة، و تناقضاً بين ما تهدف إليه الدولة نظراً وما تبنيه عملاً.
و هل ستكون سوريا في اتخاذها اسم (الجمهورية السورية) شاذة بين دول الجامعة العربية؟ ألا يخلو أسماء كل من لبنان و الكويت و السودان و الجزائر و المغرب وموريتانيا و غغيرها من صفة (العربية)؟ أليست الأغلبية في تلك الدول عربية؟ لماذا لم تتشبث تلك الدول بهذه الصفة؟ هل قلل ذلك من قيمة مواطنيها من العرب؟
ثم إن ثمة تناقضاً بين ما تتشبث به المعارضة السورية بشقيها الديمقراطي و الإسلامي من رفض لتغيير اسم الدولة من (الجمهورية العربية السورية) إلى (الجمهورية السورية) و بين ما تسير عليه في الواقع.
فقد رفضت الثورة علم النظام، و رفعت عالياً علم الاستقلال، و استظلت و لا تزال جميع مؤتمرات و ملتقيات المعارضة بعلم الاستقلال، و يعلقه رموز المعارضة على صدورهم من جهة القلب، و هو العلم نفسه الذي استظلت به الدولة في معارك التحرير من الاستعمار و صنع الاستقلال، و كانت سوريا في ظلال هذا العلم (جمهورية سورية)، ولم يُسقط هذا العلمَ إلا المد القومي العربي الشوفيني الذي رافق تأسيس حزب البعث و الوحدة السورية المصرية في أواخر خمسينيات القرن المنصرم.
إن اتخاذ الثورة علم الاستقلال و(الجمهورية السورية) راية لها، و تمَسُّكَ المعارضة بالتسمية التي أقيم تحتها نظام الحزب الواحد و العرق الواحد و اللون الواحد، و القائد الواحد، و بُنيت في ظلالها الدولة الأمنية التي أهدرت كرامة الشعب، و سلبته حريته، أمران لا يتآلفان، و القول بغير هذا إنما هو تعبير عن ازداجية ليس في التفكير وحده، بل في العمل أيضاً، و كيل بأكثر من مكيال.
و على هذا الأساس إذا كان تمسك الديمقراطيين من المعارضين السوريين بصفة (العربية) لسوريا مغيِّبين المكونات القومية الأخرى في سوريا مثل الكورد و الأرمن و الآشوريين و الكلدان و التركمان و غيرهم، نقطة سوداء في فكرهم الديمقراطي، فما بالك بالإسلاميين؟
إن الإصرار على وحدة العرق و اللون و اللسان اعتداء على إرادة الله، ذلك لأن الاختلاف و التنوع و التعدد من سنن الله الفطرية التي خلق الناس عليها.
و قد جاءت في القرآن الكريم أيات كثيرة تؤكد هذا التنوع و التعدد و الاختلاف، مثلما نجد في الآية 13 من سورة الحجرات “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم…..” و أعتقد أن معنى الآية الكريمة واضح، و لسنا بحاجة لأن نحيل الآخرين إلى كتب التفسير.
ثمة آيات أخرى وردت في القرآن الكريم، لا أعتقد أن الإسلاميين يجهلونها، من مثل قوله تعالى في الآية 22 من سورة الروم “و من آياته خَلقُ السماء و الأرض و اختلافُ ألسنتكم و ألوانكم…..”.
لقد خلق الله الناس شعوباً و قبائل ليتعارفوا لا ليتقاتلوا، ليتحاببوا لا ليتنافروا، ليتآلفوا لا ليتنابزوا و جعل اختلاف اللغات و الألوان آية من آياته.
أليس الإصرار على اللغة الواحدة و اللون الواحد اعتداءً على إرادته سبحانه و تعالى؟ إن الله تعالى شاء أن يجعل الناس أمماً و شعوباً و قبائل، ” و لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة” (سورة هود، الآية 18).
و قد كرر هذا القول في الآية 48 من سورة المائدة ” لكلٍ جعلنا شرعةً و منهاجاً و لوشاء ربك لجعلكم أمة واحدة“.فهل يجوز، بعد ذلك، أن يسعى العبد المؤمن إلى فرض لغته و صفاته القومية على الآخرين من خلق الله؟.
لم تقف إرادة الله على ذلك فحسب، بل أشار الله في الآية 11 من سورة الحجرات إلى أن التفاخر على الآخرين اثم لا يجوز للمسلم أن يرتكبه “يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيراً منهم”.
وهذه جميعاً آيات غير منسوخة، و أحكامها الشرعية مازالت، و ستبقى سائرة.
لا أعتقد أن هذه الأحكام غائبة عن وعي رموز المعارضة الإسلامية، كما أن كثيرين من المفكرين الإسلاميين قد أشاروا إلى ذلك في ثنايا أبحاثهم و دراساتهم.
يقول جمال البنا “إذا كان القرآن الكريم قد وصف أمة المسلمين أنها واحدة، فهذا يعني أنها واحدة في عقيدتها، و لكنه لا ينفي عناصر التميُّز و الاختلاف و التنوع بين شعوب هذه الأمة داخل الإطار الفسيح للعقيدة الواحدة”.
و لعل الكتور محمد عمارة أكثر وضوحاً، و أكثر تحديداً لمعنى الاختلاف حين يقول ” إن التعددية مورست عملياً حتى في بداية نشأة المجتمع الإسلامي، و تم التأكيد عليها رسمياً بالصحيفة أو ما يسمَّى حديثاً بالدستور الذي نظَّم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي حينذاك على تنوُّعه من مهاجرين و أنصار و يهود”(شرعية الاختلاف ص273).
ولكن أن تظل قوى المعارضة السورية في الدوامة نفسها رغم مرور ما يزيد على ستة و عشرين شهراً و الشهداء يتساقطون بالمئات كل يوم، و التدمير يطال كل مرافق الحياة في سوريا، و المدن السورية تفرغ من ساكنيها هرباً من الموت الذي يُلقى عليهم براً و جواً.
فإن الأمر لا يدعو إلى التفاؤل، و الحال هذه تصب في مصلحة النظام، و تصطف إلى جانب اللامبالاة الدولية في إطالة عمر النظام.
من المعروف أن للثورات برامجها، و المفاجأة التي أشرنا إليها لم تعد، بعد مرور كل هذه المدة و آلاف الضحايا و ملايين النازحين و اللاجئين إلى دول الجوار و غيرها،سبباً مقبولاً في افتقار الثورة و قوى المعارضة السورية إلى برنامج و رؤية واضحة لسوريا المستقبل، سوريا التي تضم فسيفساءً جميلاً من مكونات عرقية و طائفية متعددة و مشارب سياسية و فكرية مختلفة.
هذا التعدد الذي تتفق نحوه كل أطياف المعارضة كما هو واضح و جلي في خطابها، و تؤكده في جميع مؤتمراتها،، و لهذا لا تنفك تعيد إلى الأذهان سعيها إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية على أنقاض الدولة الأمنية.
و لعل اسم الدولة يقف في قمة متطلبات هذا التعدد الاثني و الفكري و هذا التوجه نحو بناء الدولة المدنية الديمقراطية، مما يجعل تغيير اسم الدولة الحالي (الجمهورية العربية السورية) أمراً لا بد منه استجابة للواقع الذي تقره جميع أطياف المعارضة، و الهدف الذي ترنو إليه، بعيداً عن التشبث بالأغلبية معياراً، و تعبيراً عن ترجمة القول فعلاً، و هي ترجمة تشكِّل محكاً لصدق الطروحات النظرية.
فمثلما لا تشكِّل الأغلبية و الأقلية البرلمانية ضماناً لحقوق المواطنين دون دستور مدني يحدد سلطات كلا الجانبين في إطار الحق الكامل للمواطنة، وأن حكم الأكثرية لا يعني حرمان الأقلية في صنع القرار، بل يجب أن تساهم الأقلية أيضاً في صنع القرار في الدولة الديمقراطية الليبرالية، و أن الديمراطية التي تحكمها الأغلبية و لا تقوم على أساس ليبرالي تعرقل تحرر الأفراد و المجتمعات و تضيِّع حقوق الأقليات القومية و الدينية، لأن الديمقراطية الليبرالية تتطلب بناء المؤسسات الدستورية و القضائية قبل إجراء الانتخابات.
كذلك لا تعتبر الأغلبية معياراً في تسمية الدولة، لأن في ذلك تغييباً للأقليات التي تتضافر في النسيج الاجتماعي و الاثني للدولة، و تناقضاً بين ما تهدف إليه الدولة نظراً وما تبنيه عملاً.
و هل ستكون سوريا في اتخاذها اسم (الجمهورية السورية) شاذة بين دول الجامعة العربية؟ ألا يخلو أسماء كل من لبنان و الكويت و السودان و الجزائر و المغرب وموريتانيا و غغيرها من صفة (العربية)؟ أليست الأغلبية في تلك الدول عربية؟ لماذا لم تتشبث تلك الدول بهذه الصفة؟ هل قلل ذلك من قيمة مواطنيها من العرب؟
ثم إن ثمة تناقضاً بين ما تتشبث به المعارضة السورية بشقيها الديمقراطي و الإسلامي من رفض لتغيير اسم الدولة من (الجمهورية العربية السورية) إلى (الجمهورية السورية) و بين ما تسير عليه في الواقع.
فقد رفضت الثورة علم النظام، و رفعت عالياً علم الاستقلال، و استظلت و لا تزال جميع مؤتمرات و ملتقيات المعارضة بعلم الاستقلال، و يعلقه رموز المعارضة على صدورهم من جهة القلب، و هو العلم نفسه الذي استظلت به الدولة في معارك التحرير من الاستعمار و صنع الاستقلال، و كانت سوريا في ظلال هذا العلم (جمهورية سورية)، ولم يُسقط هذا العلمَ إلا المد القومي العربي الشوفيني الذي رافق تأسيس حزب البعث و الوحدة السورية المصرية في أواخر خمسينيات القرن المنصرم.
إن اتخاذ الثورة علم الاستقلال و(الجمهورية السورية) راية لها، و تمَسُّكَ المعارضة بالتسمية التي أقيم تحتها نظام الحزب الواحد و العرق الواحد و اللون الواحد، و القائد الواحد، و بُنيت في ظلالها الدولة الأمنية التي أهدرت كرامة الشعب، و سلبته حريته، أمران لا يتآلفان، و القول بغير هذا إنما هو تعبير عن ازداجية ليس في التفكير وحده، بل في العمل أيضاً، و كيل بأكثر من مكيال.
و على هذا الأساس إذا كان تمسك الديمقراطيين من المعارضين السوريين بصفة (العربية) لسوريا مغيِّبين المكونات القومية الأخرى في سوريا مثل الكورد و الأرمن و الآشوريين و الكلدان و التركمان و غيرهم، نقطة سوداء في فكرهم الديمقراطي، فما بالك بالإسلاميين؟
إن الإصرار على وحدة العرق و اللون و اللسان اعتداء على إرادة الله، ذلك لأن الاختلاف و التنوع و التعدد من سنن الله الفطرية التي خلق الناس عليها.
و قد جاءت في القرآن الكريم أيات كثيرة تؤكد هذا التنوع و التعدد و الاختلاف، مثلما نجد في الآية 13 من سورة الحجرات “يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكم شعوباً و قبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم…..” و أعتقد أن معنى الآية الكريمة واضح، و لسنا بحاجة لأن نحيل الآخرين إلى كتب التفسير.
ثمة آيات أخرى وردت في القرآن الكريم، لا أعتقد أن الإسلاميين يجهلونها، من مثل قوله تعالى في الآية 22 من سورة الروم “و من آياته خَلقُ السماء و الأرض و اختلافُ ألسنتكم و ألوانكم…..”.
لقد خلق الله الناس شعوباً و قبائل ليتعارفوا لا ليتقاتلوا، ليتحاببوا لا ليتنافروا، ليتآلفوا لا ليتنابزوا و جعل اختلاف اللغات و الألوان آية من آياته.
أليس الإصرار على اللغة الواحدة و اللون الواحد اعتداءً على إرادته سبحانه و تعالى؟ إن الله تعالى شاء أن يجعل الناس أمماً و شعوباً و قبائل، ” و لو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة” (سورة هود، الآية 18).
و قد كرر هذا القول في الآية 48 من سورة المائدة ” لكلٍ جعلنا شرعةً و منهاجاً و لوشاء ربك لجعلكم أمة واحدة“.فهل يجوز، بعد ذلك، أن يسعى العبد المؤمن إلى فرض لغته و صفاته القومية على الآخرين من خلق الله؟.
لم تقف إرادة الله على ذلك فحسب، بل أشار الله في الآية 11 من سورة الحجرات إلى أن التفاخر على الآخرين اثم لا يجوز للمسلم أن يرتكبه “يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قومٌ من قومٍ عسى أن يكونوا خيراً منهم”.
وهذه جميعاً آيات غير منسوخة، و أحكامها الشرعية مازالت، و ستبقى سائرة.
لا أعتقد أن هذه الأحكام غائبة عن وعي رموز المعارضة الإسلامية، كما أن كثيرين من المفكرين الإسلاميين قد أشاروا إلى ذلك في ثنايا أبحاثهم و دراساتهم.
يقول جمال البنا “إذا كان القرآن الكريم قد وصف أمة المسلمين أنها واحدة، فهذا يعني أنها واحدة في عقيدتها، و لكنه لا ينفي عناصر التميُّز و الاختلاف و التنوع بين شعوب هذه الأمة داخل الإطار الفسيح للعقيدة الواحدة”.
و لعل الكتور محمد عمارة أكثر وضوحاً، و أكثر تحديداً لمعنى الاختلاف حين يقول ” إن التعددية مورست عملياً حتى في بداية نشأة المجتمع الإسلامي، و تم التأكيد عليها رسمياً بالصحيفة أو ما يسمَّى حديثاً بالدستور الذي نظَّم العلاقة بين أفراد المجتمع الإسلامي حينذاك على تنوُّعه من مهاجرين و أنصار و يهود”(شرعية الاختلاف ص273).
نخلص في نهاية هذا المقال إلى أنه لا ثقافة الديمقراطيين و لا شريعة الإسلاميين، كلتاهما لا تجيز لمعتنقيها القفز على واقع التعدد والاختلاف و التنوع الذي عليه سوريا، و إذا كانت الأولى تذهب إلى أن هذا التنوع إنما هو إغناء و مصدر قوة للبلد، فإن الثانية تعتبره سُنَّة من سنن الله التي خلق الناس عليها.