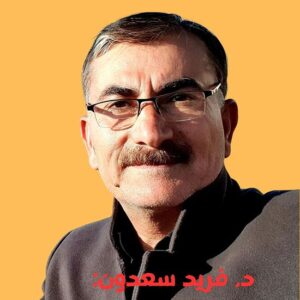إبراهيم اليوسف
إبراهيم اليوسفكلما استُعرض دور الكردي في خدمة سواه، في المنطقة، حضرتني تلك القصة التي سمعتها في طفولتي من أبي، عن حجر سنمار، الأعجمي، الذي بنى قصر الخورنق للملك النعمان بن المنذر بن امرىء القيس اللخمي، وهو يرويها في سياق آخر، غير السياق الذي رحت أستخلصه، بعد قراءاتي لبعض المراجع التي تناولته. وشخصية النعمان غارقة في إشكاليتها فهو بدوره قاتل كثيرين ومنهم شعراء- في يوم بؤسه، الموازي ليوم فأله أو سعده، إنها شخصية جديرة بالقراءة، المعمقة. كما أن هذا الرجل الأعجمي ما إن انتهى من عمارة قصر الملك النعمان، بعد عشرين سنة، وربما أكثر، بحسب بعض الروايات، حتى راح يسارره أن في البناء حجراً، ما إن تتم إزالته حتى يتهدم البناء عن بكرة روعته، وبهائه، وهو تحفة المكان، بل أنه قادر أن يشيد مبنى أرسخ، وأجمل، وأحسن منه، يتابع حركة دوران الشمس، على امتداد ساعات الضوء..!.
لم يشفع لسنمار، المعماري، الأعجمي، الماهر، ذلك الجزء النفيس من عمره الذي كرسه من أجل خدمة الملك النعمان، حتى يبني له مأثرة لا يد له فيها، بل إنه خان العهد الذي كان بينه والرجل في إعطائه أجره الذي يستحق، بعد أن ترك أثراً في المكان، أو علامة، هي الأجمل في سيرته، كامرىء فصامي مريض، كارثي، ناكر للجميل، معاد للإبداع، متورم الأنا، وقاتل لصانع الجمال، من خلال إقدامه على مقتلة هذا المعماري الفذ بعد أن أمر أزلامه برميه من أعلى المبنى، كي يتخلص من سرِّ إمكان هدم هاتيك المعجزة المعمارية معه، عبر سعار الشك بالآخر، بالتآمر عليه، أو إمكان إشادة عمارة أخرى بمواصفات فنية أرقى من التحفة التي أنجزت له.
لست-هنا- في موقع سنمارية الكردي الذي يشير سجله البياني في المنطقة إلى الدور/الأثر الكبير الذي لعبه، ولما يزل يلعبه على مسرح التاريخ، والجغرافيا، بيد أنه دور بات يسلب منه، بل أنه مهما ارتفع شأنه- كما حالة عمارة المليك النعمان- فهو يشكل خطورة أشد َّعليه، وهو دور مشهود له كأحد أهم فرسان الشرق- بحسب توصيف الأرمني- أبوفيان، ناهيك عن أعطيات عقله، من خلال رموزه الذين أعطوا، وسجل إبداعهم في خانات أخرى، بل ذابت عقول أخرى لما تزل تعطي في مثل تلك الخانات، نتيجة إخلاصه لمشروعه الذي انخرط فيه، بعكس من حوله، وهو مشروع: الدِّين، بعيداً عن أي تقويم له…!.
أجل، مشروع الدين الذي آمن به، والذي تحول من قبل شركائه فيه، شركائه في المكان، إلى نطع لجزِّ عنق حلمه فوقه، بل لجزِّ رأس وجوده، بينما تم توظيفه هذا المشروع، في نطاقه غير المشروع، ليغدو عنوان أضلولة سنمار الكردي، باعتبار أن شركاءه هؤلاء، جعلوا منه أدوات لتحقيق خصوصياتهم الوطنية، أو القومية، بعد أن تم التنكر له، والتنكر من شراكته في هذا المشروع، خيانة العهد الذي التقوا فيه عليه، في الأصل، واعتباره دخيلاً، متآمراً، أنى قال: وماذا عني أنا الآخر؟، وكأن هذا الدين ليس إلا محل” سوبرماركت” بملكية بعضهم، دون سواهم..!.
مشكلة سنمار الكردي، الذي خذله شركاؤه، وبات أكثر من ضحية، في البازار القومي، أن النظارة الذين راحوا يراقبون المشهد، وكانوا يتربصون أن يتحولوا إلى ممثلين، بنصوص خاصة بهم، وسيناريوهات خاصة بهم، بل وعبر مخرجين خاصين بهم-وما سايكس وبيكو إلا عبارة عن مخرجين تنفيذيين فحسب ضمن أكاديمية رسمت لهما مسارهما فأديا دورهما، نظرياً، كي تأتي هاتيك الأكاديمية لتؤدي دورها الحاسم، وتكون النهاية المدوية: إنك بلا وطن، وخارج ألوان لوحة المخرجين التنفيذيين..!؟.
لم يأت الأمر اعتباطاً البتة، فثمة مخطط -إذاً- وراء ما تم، فقد كان للكردي، على الدوام، صوته، في هذا المحفل الدولي، أو ذاك، بل كان له مكماهونه، أو شهيده المعلق على عود مشنقة الحرية، أو في محرقة هذا المحتل، وكانت له انتفاضته، وثورته. أية جريرة، أدهى من جرائر شركائه، استوقفت الغربي، حتى جعلته-دريئة- لطلقات مسدسه، يحاول التدخل لإنهاء دوره؟، مادام أن حال شركائه لم تكن بأفضل، فمقابل نخبة غيره، كانت له نخبته-وإن المحددة- بل ومقابل تضحيات سواه في الحرية، أو التسيد، أو الاستفراد، كانت له تضحياته واضحة الملمح، في نشدان الحرية فوق ترابه…!.
إن إقامة دولة الكردي- كردستان الكبرى- ليست الآن شأنا كردياً صرفاً، فهي قضية شركاء الكرد، في الدوائر المتداخلة كلها، صغيرها، المتاخم، وبعيدها، المعني، الفاعل، أو المعطل، وهي بهذا المعنى شأن: الفارسي، وشأن العربي، وشأن التركي- وهنا نحن في حضرة أحرار مشخصين مفترضين، كما هو شأن الروسي الذي شارك في وضع-أثافي- الاتفاقية، وانسحب بعيد ثورته، من دون أن تكون له توصياته في ما يخص الكردي، بما يجعله في حالته المستجدة نفسها شريك هؤلاء، في مخططهم، لأن أثر بصماته دامغة، حتى وإن خلا عن نص الاتفاق حبر توقيعه، كما هو شأن الغربي غير الفاعل، آنذاك، وباتت قوته تظهر- وهنا فالمعني هو الأمريكي- حيث تكون مسؤولية كل طرف-الآن- من خلال مقدار حضور قوته، فلا براءة لأحد من المسؤولية البتة، كما أن ثمة مجرمين-هما القائمان على الأمر: الفرنسي والبريطاني- أعني حكومتي فرنسا، وبريطانيا، المملكلة المتحدة، هما في موقع حمل إرث الجريمة، الجريمة التي لا تموت بالتقادم، القانوني، في انتظار رفعها، ليس من خلال إحقاق الحق، وهو الوقوف إلى جانب الكردي من أجل تحرير “وطنه” كردستانه- فحسب- وإنما من أجل البعد ين الرجعي، والمستقبلي، بما يعني رفع الحيف، والإسهام في بناء الوطن، باعتبار أن في ذمم كل هؤلاء، مئة عام من عبودية الكردي على أيدي سواه، إنها جريرة الفرنسسن، والإنكليز، بل والغربيين عموماً، كما هي جريرة المسلمين، ليكون مطلب تحرير كردستان على رأس أية قائمة إسلامية: قبل القدس- أو فلسطين، لأن جريمة استلاب كردستان أقدم منها تاريخياً، ناهيك عن الكثير خلاف ذلك…!.
دم سنمار الكردي، لايزال على رقعة المسرح، المجزأ، إلى أربعة أقسام، تفوح رائحته، يصفع مشهد حاله أعين النظارة، بينما لا جريرة له، في ما آل إليه. من هنا، إن مجرد رمي تبعات الجريمة على شخصين أحدهما باسم: فرانسوا جورج بيكو ومارك سايكس، إنما هو تماه في دواعي الجريمة، نصرة لها، تضييعاً للقضية، كي تقيض ضد مجهولين، ناهيك عن أن كشف السوفييتي في العام 1917، عن المخطط الذي صادق عليه أسلافه، لا يبرىء-جانبه- أمام السؤال الصاعق: وماذا فعلت للكردي، لاسيما أن المحطة المهابادية 1946، رغم كل مرافعاته، المخففة، أي مرافعات: الروسي، تجعله شريكاً متواطئاً، ساكتاً، عن الجريمة، وما أكثر الوقائع، مادام أنه ظل ينطلق المحيط، والعالم، من خلال بوصلة منفعيته الصرفة..!.
بعد مئة سنة، على اتفاقية سايكس بيكو، علينا أن ننسى اسمي الرجلين: الفرنسي والبريطاني، وأن نخاطب الغربيين-بمجملهم- عن آباء مجرمين، محولين بذلك المحاكمة من مجالها الفضفاض، المضلل، إلى مجالها الواقعي، كي يشير أبناء سنمار الكردي الذين اغترب عنهم أبوهم، طوال كل هذا الزمن الميت، إلى منجزه، قائلين: هذا ما قدمه والدنا لهذه الرقعة التي تتشرب بدمه، وعرقه، ورائحة خطاه، وهم يستعيدون ميراثهم من تلك التركة العظيمة..!؟.
يتبع……
* سنمار معماري رومي