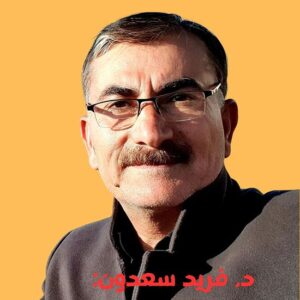دهام حسن
دهام حسنيقال أن الإغريق، هم أول من انداروا إلى طبيعة الإنسان، لمعرفة ماهيتها، وبالتالي تفسير السلوك البشري، ورغم هذا الجهد عند الإغريق، فقد ظل هذا التناول قاصرا، فيما يبدو… فقد نظر هؤلاء بداية إلى الإنسان، كذات مستقلة، دون ربط ما يبدر منه، من سلوك وتصرف، بالظروف أو البيئة أو العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، ومثل هذا الفهم وجدناه لاحقا عند هيغل، فرغم إيمانه بحركة التاريخ إلى الأمام، لكنه كان دائما يبحث عن أسباب الحركة خارج نطاق البشر، فقد كان ينظر إلى الأفكار على أنها تسبح في فضاء، خارج، أو بمعزل عن العلاقات الاجتماعية؛ في حين أن ماركس الذي جاء بعد هيغل، كان يرى أن الأفكار هي انعكاس للواقع المعيش
علما أن ماركس لاسيما رفيق دربه إنجلز تنبه لدور الأفكار، وبأنها تتمتع باستقلالية نسبية، ولها الدور والتأثير في التغيير والتطوير، بعد أن تستحوذ على عقول الناس، لهذا كان على رجل السياسة، أن ينفتح على منتجات الفكر، ويهتدي بها، لينفتح أمامه الطريق، المفضي بالتالي، إلى المعرفة الأكيدة لتطوير فكره السياسي…
مما لا شك فيه؛ إن الظروف السيئة التي تحيط بالإنسان، لا بد أن تزعجه، وبالتالي، أن تثيره، ليأتي الرد منه؛ سواء وافقنا على هكذا ردّ أم لم نوافق عليه؛ وما يؤخذ على إنساننا اليوم من مواقف ربما قد تكون سلبية، في منحى النضال السياسي، فهذا يعود إلى الأنظمة الشمولية الاستبدادية، لأنها تفسد كل المؤسسات، تفقدها هويتها، واستقلاليتها وتجعلها تابعة؛ وإنساننا بالتالي يتأثر بكل هذا، فهو نتاج هذه المؤسسات، يقول هولباخ : (ليست الطبيعة هي التي تخلق الأشرار، وإنما مؤسساتنا هي التي تجعلهم أشرارا)؛ فالتكوين النفسي يتكون ويتولد من ظروف الحياة المعيشة، وبتغيير الظروف، يتغير هذا التكوين النفسي عند الإنسان، فالسلطة عندما تظلم، وتجور، وتتحكم بالناس، سيأتي الرد، وتتوجه إرادة هؤلاء المقهورين، ضد السلطة في كفاح مستميت من أجل الحرية، ودفع الحيف عليهم، وقد يصل الأمر بهؤلاء حتى الإطاحة بالحكام الطغاة، طالما الإرشاد والنصيحة لم يؤت ثمرها..
وبالمقابل، لن يسكت الذين هم في هرم السلطة، من إزعاج الآخرين لهم، فسوف يلجؤون من جانبهم، إلى تصفية ( المتمردين ) الثائرين، أو زجهم في السجون، والتضييق على الثقافة والمثقفين، وقمع الداعين إلى الحرية بشكل عام، ليعيش جل هؤلاء في محنة التسلط، سواء اتخذت السلطة الصبغة الدينية كما في أيران، أم اتخذت الطابع الاقتصادي أو السياسي، كما في سائر الأنظمة الشمولية في المنطقة؛ دون أن نغفل، من أن السياسات الاقتصادية الجائرة، وتمريرها بقسوة مفرطة من قبل السلطة، لا بد بالتالي أن تؤدي إلى تفجير صمامات الأمان الاجتماعية؛ فالتخلف والبؤس والتعسف والقهر والتوترات الدولية، كلها تفضي إلى استنبات بذرة تنمو وتتقوى وتتفرع لتصبح صالحة للتغيير الأكيد، كما لا يخفى أن قوة السلطة الحقيقية لا تتحقق بالعسكر كأداة للقمع والإسكات، وإنما ذلك يتحقق، في حالة واحدة، وهي ازدهار أوضاع المواطنين؛ لهذا يبقى الإنسان في صراع دائم مع السلطة المتحكمة، حتى ينتزع حريته ويتحرر من أسر العبودية..
أما الإنسان الذي يتودد لهكذا نظم، ويتزلف بذل واستخذاء لها، فبينه وبين نفسه لا بد أن يداخله شعور بالانكسار، وهو يعلم أن الآخرين ينظرون إليه باحتقار، أما هو فربما تصنّع الرضي، واحتال الأعذار ليبرر للسلطة التجاوزات، وما هو واقع، وربما استساغ الإهانة بمضي الزمن كما يقول المتنبي:
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام
وفي الاتجاه نفسه، فالإنسان الذي يعتمد على نصوص جامدة، ويراها خير معلم ، لا يطولها الشك، حتى لو برزت وقائع جديدة، على الحياة المعيشة، يبقى ينشد ذاك النشيد، الذي لم يعد تشنف له أذن، مثل هذا الإنسان حري به أن يلازم صومعته، ويسكت، ذلك خير له من أن يسوق الأعذار والمبررات، يسوّغ الخطأ، ويبرر للجاني ما يفعله، رغم أن كل هذا لن يعفيه من التنصل عن مسؤولياته تجاه ما آلت إليه الأوضاع ، وتجاه شعب بلده، لا سيما إذا كان يعمل داخل تنظيم سياسي، له ماض لا غبار عليه، أما الآن فلن ينجو من سياط الناس، ولذع الألسنة، كما لن يشفع له ماضيه، حتى لو كان هذا الماضي ناصع البياض، ومحط اعتماد ورجاء الناس في نضالهم السياسي في فترة من الفترات؛ فمعلم الأمس ليس بالضرورة أن يكون معلم اليوم، والتغيير الذي يحدث في الواقع، لا بد أن ينعكس على العقول والسلوك ويكون بالتالي للإنسان الموجه والمرشد، والثقافة القديمة والتقليدية التي تبقى تستبد بعقول الناس، فلسوف تتنحى أمام الجديد، فالجديد لا بد أن يزجي القديم، وتعوّدنا للأسف، القبول بما ترسبت في أذهاننا من العلوم النقلية، دون جهد منا لغربلة ذاك الركام، والسعي لاستكشاف حقول معرفية جديدة؛لا بد للتغيير أن يتم كنتيجة حتمية جراء التراكمات والتفاعلات من الأحداث والوقائع والأفكار..
لتفضي بالتالي وبالضرورة إلى التغيير الأكيد، رغم أن بعض الميول والنوازع التقليدية، تتشبث بالإنسان وتشده نحو الماضي، لكن رحاب الحالة الجديدة يروق له، بما يغري من وعود، فيمضي إليها مختارا وبحماس…
إن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وهذه المقولة المتداولة عندنا كثيرا، هي حقيقة لا يمكن دحضها؛ ومن هنا علينا أن نعي، أن ما تحقق في الغرب من مكتسبات، تعود لنضال سائر الطبقات، وكانت وقود المعارك، فقراء الناس، من أبناء الطبقات الدنيا، ولم تكن منحة من أي سلطة، فقد كان حق التصويت حكرا على الأغنياء والمالكين وحدهم في البدايات، فانتزع هذا الحق لاحقا، وفي وقت متأخر؛ ومن المعلوم أن أية سلطة لا تقوم بإصلاحات، إلا إذا وعت حقا بأنها مستهدفة بالتنحية، واستشعرت بالتالي قوة ( العدو الداخلي )؛ فما تتحقق من إصلاحات هي نتيجة تنازلات مضطرة عليها الطبقة الحاكمة، وليست منحة بسبب رقة قلب الرأسمالي،أو تتضمنها طبيعة الرأسمالية، كما أسلفنا…
من المعلوم أن النظم الاستبدادية، تحبذ ممارسة العنف، وتعمد إلى بث الخوف بين الناس الذين تقودهم، وتدأب لجعلهم مطواعين، وإخضاعهم لنيرهم، وإذا ما انزلق بعض هؤلاء نحو الانحراف، فالسلطة هي الملامة أولا، فكلما حصرت الدولة بأيديها وحدها كل المهام، وهيمنت على المجتمع بشكل تام، واستحكمت بكل مفاصل الدولة، حينها تفقد كل المؤسسات مضامينها، وتستحيل إلى هيئات شكلية، وتغدو بالتالي عقيمة، لا حول لها ولا قوة، حينها لا بد أن تبرز أصوات تنادي بحقوق الإنسان، وتدعو للحد من هيمنة الدولة، ووجوب فصل السلطات الثلاث، وتدعو لخلق أجواء، تتمتع كل المؤسسات، والتنظيمات، والحركات، التي ينشئها الناس، بشخصيتها الاعتبارية، وتنادي بمناخات من الحريات العامة..
ومن هنا نكون قد أحيينا تلك المؤسسات بروح ودينامية جديدة….
في بلد مثل سوريا، لم يسد بالتمام النمط الرأسمالي في الاقتصاد، فهو مزيج من العلاقات المختلفة، وبسبب هذا الضعف في العلاقات الرأسمالية، وقصورها على النمو، فهي عاجزة بالتالي على الهيمنة السياسية والاقتصادية، لهذا فهي تلجأ إلى العنف، لتمرير تلك السياسات الخاطئة، وحتى تنفرد بالسلطة، فمن المؤكد أن المواطن يلاحظ أن التنمية غير محسوسة، وأن الطبقة العاملة المنتجة مؤطرة بإدارة، وتمثيل حزبي سياسي، وضعف في النضج، كقوة وكوعي لديها، ولا يفسح لها المجال للتعبير عن نفسها في نضال سياسي إلا إذا صبت حركتها ونشاطها في خدمة السلطة، هذا القمع هو سبب العقم الاجتماعي من خلال مجتمعات هشة، لا تتكامل عناصرها في تحديث الدولة؛ فعلى دولة مثل سوريا، السعي لكسب المجتمع، وملاقاة تطلعاته، بمعالجة قضاياه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وعلى حزب البعث أن يستمد قوته من نضال أعضائه ونشاطهم ومواكبتهم للتحولات، وتعبئة الناس وإقناعهم بنضال الحزب السياسي، وبتوجهاته العملية المترجمة على صعيد الواقع في أعمال وممارسات، فالناس بالتالي هم شهود على كل شيء… فعلى الحزب ألا يتدجج بعصا السلطة، وألا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أو يعطي أوامر ونواهي، ويكون دوره، دور المسيّر؛ فبدون أخذ كل هذا بالحسبان، فلا تقدم ولا تحديث ولا حتى استقرار؛ والمجتمع الذي لا يستطيع تجاوز تناقضاته، فهو حتما سيواجه الدمار بتعبير أحد كبار المفكرين ..
فعلى القائمين على السلطة أن يتحسسوا ذلك، ويبادروا إلى تلافي هذا الدمار، بحزمة من الإصلاحات، فليس كل دمار، هو خلاق لحالة جديدة، أو نهضة جديدة، فقد يعصف بالبلد والمجتمع إلى متاهات، لا صحو بعدها، إلا بضريبة مكلفة، ومكلفة جدا ؛ فهل نحن منتبهون…!؟
مما لا شك فيه؛ إن الظروف السيئة التي تحيط بالإنسان، لا بد أن تزعجه، وبالتالي، أن تثيره، ليأتي الرد منه؛ سواء وافقنا على هكذا ردّ أم لم نوافق عليه؛ وما يؤخذ على إنساننا اليوم من مواقف ربما قد تكون سلبية، في منحى النضال السياسي، فهذا يعود إلى الأنظمة الشمولية الاستبدادية، لأنها تفسد كل المؤسسات، تفقدها هويتها، واستقلاليتها وتجعلها تابعة؛ وإنساننا بالتالي يتأثر بكل هذا، فهو نتاج هذه المؤسسات، يقول هولباخ : (ليست الطبيعة هي التي تخلق الأشرار، وإنما مؤسساتنا هي التي تجعلهم أشرارا)؛ فالتكوين النفسي يتكون ويتولد من ظروف الحياة المعيشة، وبتغيير الظروف، يتغير هذا التكوين النفسي عند الإنسان، فالسلطة عندما تظلم، وتجور، وتتحكم بالناس، سيأتي الرد، وتتوجه إرادة هؤلاء المقهورين، ضد السلطة في كفاح مستميت من أجل الحرية، ودفع الحيف عليهم، وقد يصل الأمر بهؤلاء حتى الإطاحة بالحكام الطغاة، طالما الإرشاد والنصيحة لم يؤت ثمرها..
وبالمقابل، لن يسكت الذين هم في هرم السلطة، من إزعاج الآخرين لهم، فسوف يلجؤون من جانبهم، إلى تصفية ( المتمردين ) الثائرين، أو زجهم في السجون، والتضييق على الثقافة والمثقفين، وقمع الداعين إلى الحرية بشكل عام، ليعيش جل هؤلاء في محنة التسلط، سواء اتخذت السلطة الصبغة الدينية كما في أيران، أم اتخذت الطابع الاقتصادي أو السياسي، كما في سائر الأنظمة الشمولية في المنطقة؛ دون أن نغفل، من أن السياسات الاقتصادية الجائرة، وتمريرها بقسوة مفرطة من قبل السلطة، لا بد بالتالي أن تؤدي إلى تفجير صمامات الأمان الاجتماعية؛ فالتخلف والبؤس والتعسف والقهر والتوترات الدولية، كلها تفضي إلى استنبات بذرة تنمو وتتقوى وتتفرع لتصبح صالحة للتغيير الأكيد، كما لا يخفى أن قوة السلطة الحقيقية لا تتحقق بالعسكر كأداة للقمع والإسكات، وإنما ذلك يتحقق، في حالة واحدة، وهي ازدهار أوضاع المواطنين؛ لهذا يبقى الإنسان في صراع دائم مع السلطة المتحكمة، حتى ينتزع حريته ويتحرر من أسر العبودية..
أما الإنسان الذي يتودد لهكذا نظم، ويتزلف بذل واستخذاء لها، فبينه وبين نفسه لا بد أن يداخله شعور بالانكسار، وهو يعلم أن الآخرين ينظرون إليه باحتقار، أما هو فربما تصنّع الرضي، واحتال الأعذار ليبرر للسلطة التجاوزات، وما هو واقع، وربما استساغ الإهانة بمضي الزمن كما يقول المتنبي:
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت إيلام
وفي الاتجاه نفسه، فالإنسان الذي يعتمد على نصوص جامدة، ويراها خير معلم ، لا يطولها الشك، حتى لو برزت وقائع جديدة، على الحياة المعيشة، يبقى ينشد ذاك النشيد، الذي لم يعد تشنف له أذن، مثل هذا الإنسان حري به أن يلازم صومعته، ويسكت، ذلك خير له من أن يسوق الأعذار والمبررات، يسوّغ الخطأ، ويبرر للجاني ما يفعله، رغم أن كل هذا لن يعفيه من التنصل عن مسؤولياته تجاه ما آلت إليه الأوضاع ، وتجاه شعب بلده، لا سيما إذا كان يعمل داخل تنظيم سياسي، له ماض لا غبار عليه، أما الآن فلن ينجو من سياط الناس، ولذع الألسنة، كما لن يشفع له ماضيه، حتى لو كان هذا الماضي ناصع البياض، ومحط اعتماد ورجاء الناس في نضالهم السياسي في فترة من الفترات؛ فمعلم الأمس ليس بالضرورة أن يكون معلم اليوم، والتغيير الذي يحدث في الواقع، لا بد أن ينعكس على العقول والسلوك ويكون بالتالي للإنسان الموجه والمرشد، والثقافة القديمة والتقليدية التي تبقى تستبد بعقول الناس، فلسوف تتنحى أمام الجديد، فالجديد لا بد أن يزجي القديم، وتعوّدنا للأسف، القبول بما ترسبت في أذهاننا من العلوم النقلية، دون جهد منا لغربلة ذاك الركام، والسعي لاستكشاف حقول معرفية جديدة؛لا بد للتغيير أن يتم كنتيجة حتمية جراء التراكمات والتفاعلات من الأحداث والوقائع والأفكار..
لتفضي بالتالي وبالضرورة إلى التغيير الأكيد، رغم أن بعض الميول والنوازع التقليدية، تتشبث بالإنسان وتشده نحو الماضي، لكن رحاب الحالة الجديدة يروق له، بما يغري من وعود، فيمضي إليها مختارا وبحماس…
إن الحرية تؤخذ ولا تعطى، وهذه المقولة المتداولة عندنا كثيرا، هي حقيقة لا يمكن دحضها؛ ومن هنا علينا أن نعي، أن ما تحقق في الغرب من مكتسبات، تعود لنضال سائر الطبقات، وكانت وقود المعارك، فقراء الناس، من أبناء الطبقات الدنيا، ولم تكن منحة من أي سلطة، فقد كان حق التصويت حكرا على الأغنياء والمالكين وحدهم في البدايات، فانتزع هذا الحق لاحقا، وفي وقت متأخر؛ ومن المعلوم أن أية سلطة لا تقوم بإصلاحات، إلا إذا وعت حقا بأنها مستهدفة بالتنحية، واستشعرت بالتالي قوة ( العدو الداخلي )؛ فما تتحقق من إصلاحات هي نتيجة تنازلات مضطرة عليها الطبقة الحاكمة، وليست منحة بسبب رقة قلب الرأسمالي،أو تتضمنها طبيعة الرأسمالية، كما أسلفنا…
من المعلوم أن النظم الاستبدادية، تحبذ ممارسة العنف، وتعمد إلى بث الخوف بين الناس الذين تقودهم، وتدأب لجعلهم مطواعين، وإخضاعهم لنيرهم، وإذا ما انزلق بعض هؤلاء نحو الانحراف، فالسلطة هي الملامة أولا، فكلما حصرت الدولة بأيديها وحدها كل المهام، وهيمنت على المجتمع بشكل تام، واستحكمت بكل مفاصل الدولة، حينها تفقد كل المؤسسات مضامينها، وتستحيل إلى هيئات شكلية، وتغدو بالتالي عقيمة، لا حول لها ولا قوة، حينها لا بد أن تبرز أصوات تنادي بحقوق الإنسان، وتدعو للحد من هيمنة الدولة، ووجوب فصل السلطات الثلاث، وتدعو لخلق أجواء، تتمتع كل المؤسسات، والتنظيمات، والحركات، التي ينشئها الناس، بشخصيتها الاعتبارية، وتنادي بمناخات من الحريات العامة..
ومن هنا نكون قد أحيينا تلك المؤسسات بروح ودينامية جديدة….
في بلد مثل سوريا، لم يسد بالتمام النمط الرأسمالي في الاقتصاد، فهو مزيج من العلاقات المختلفة، وبسبب هذا الضعف في العلاقات الرأسمالية، وقصورها على النمو، فهي عاجزة بالتالي على الهيمنة السياسية والاقتصادية، لهذا فهي تلجأ إلى العنف، لتمرير تلك السياسات الخاطئة، وحتى تنفرد بالسلطة، فمن المؤكد أن المواطن يلاحظ أن التنمية غير محسوسة، وأن الطبقة العاملة المنتجة مؤطرة بإدارة، وتمثيل حزبي سياسي، وضعف في النضج، كقوة وكوعي لديها، ولا يفسح لها المجال للتعبير عن نفسها في نضال سياسي إلا إذا صبت حركتها ونشاطها في خدمة السلطة، هذا القمع هو سبب العقم الاجتماعي من خلال مجتمعات هشة، لا تتكامل عناصرها في تحديث الدولة؛ فعلى دولة مثل سوريا، السعي لكسب المجتمع، وملاقاة تطلعاته، بمعالجة قضاياه الاجتماعية والسياسية والاقتصادية؛ وعلى حزب البعث أن يستمد قوته من نضال أعضائه ونشاطهم ومواكبتهم للتحولات، وتعبئة الناس وإقناعهم بنضال الحزب السياسي، وبتوجهاته العملية المترجمة على صعيد الواقع في أعمال وممارسات، فالناس بالتالي هم شهود على كل شيء… فعلى الحزب ألا يتدجج بعصا السلطة، وألا يتدخل في كل صغيرة وكبيرة، أو يعطي أوامر ونواهي، ويكون دوره، دور المسيّر؛ فبدون أخذ كل هذا بالحسبان، فلا تقدم ولا تحديث ولا حتى استقرار؛ والمجتمع الذي لا يستطيع تجاوز تناقضاته، فهو حتما سيواجه الدمار بتعبير أحد كبار المفكرين ..
فعلى القائمين على السلطة أن يتحسسوا ذلك، ويبادروا إلى تلافي هذا الدمار، بحزمة من الإصلاحات، فليس كل دمار، هو خلاق لحالة جديدة، أو نهضة جديدة، فقد يعصف بالبلد والمجتمع إلى متاهات، لا صحو بعدها، إلا بضريبة مكلفة، ومكلفة جدا ؛ فهل نحن منتبهون…!؟