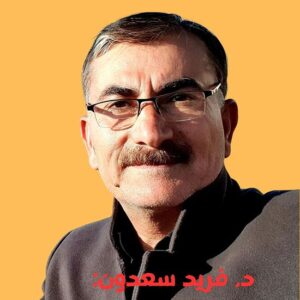إبراهيم اليوسف
إبراهيم اليوسف كما أن عامل المنفعة نفسه، يشكل دفعاً لمن يتبنى خطاب الآخرين، من حوله، وإن كان في مثل هذه الممارسة، يتم إلغاء المنفعة الذاتية، الآنية، المفترضة، عند هذا الأنموذج، بأخرى، هي منفعة الجماهير العريضة، الأبقى، وهي في جوهرها أسُّ أيِّ خطاب غيري، يعدُّ الأبقى، على الدوام، لأن صاحبه يترفع عن الخضوع لسطوة غواية المغريات، الخاوية، التي طالما استخدمت لحرف المثقف، عن أداء واجبه، وإيقاعه في فخ فقدان المصداقية .
وفي المقابل، نجد أن الأنموذج الذي يقف في وسط المعمعة، ولا يجرؤ بحكم بنيته أن يحسم أمره، في اتخاذ الموقف، الصائب أو الخاطىء، موهماً بالتواشج مع النقيضين، في آن واحد، وهذا ما لايمكن أن يكون صائباً، إزاء القضايا الكبرى التي تتعلق بالحكم الأخلاقي على ثنائية: القاتل والضحية، إذ لابد من إبداء حكم واحد، لا ثاني له، لاسيما عندما يكون القاتل مستبداً، والقتيل طالب حرية .
إن مواقف مثل هذه النماذج الثلاثة، هي التي تحدد القيمة الأخلاقية، لكل منهم، على حدة، وإذا كان الأنموذج المستأثر بمنفعته الضيقة، يجني على نفسه، عبر سلوكه، إلا أنه يبقى- في المحصلة- واضحاً، للوهلة الأولى، ولا داعي لبذل المزيد من الجهد للكشف عنه، كما هو حال المتفاني، المنحاز للآخرين، مهما كانت ضريبة ذلك، ليبقى الأنموذج الأكثر شذوذاً، وانحرافاً، وضبابية، هو الأنموذج غير القادر على التقاط الموقف المطلوب، حتى وإن أبدع آلاف النظريات التسويغية، التي تجعله غير فاعل، متربصاً، واقفاً على الرصيف، لينخرط في أي اتجاه يسجل النصر، ولا فرق في عرفه بين السارق والمسروق، والظالم والمظلوم، ما دامت بوصلته هي المنفعة، وهذا هو الأنموذج الأخطر .