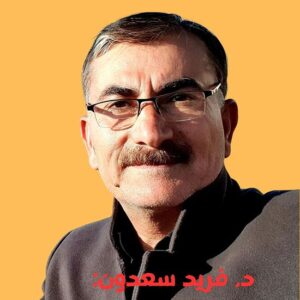لقد دخلنا نطاق وثنية جديدة، تأهَّلنا لها، لا بل استعيدت وثنية قديمة وهي لم تنقطع عن التاريخ بطرق شتى مدرَكة من جهة المعنيين بها بوجوهها الكثيرة، إذ تكون الآلهة الأرضية معروفة بأسمائها، بينما السماء تكون مرجعاً لها عند اللزوم، دون أن يكون هناك شأن يُذكر- واقعاً- للمقيم في السماء بقدر ما يتقرر مصيره على الأرض!
فالآلهة القديمة التي كانت تمثل قوى طبيعية ولها طابع إنساني، لم تكن تنفصل عما هو جار في الواقع، إنما ارتبطت بمواقع الأفراد ومقاماتهم ودرجة نفوذهم، فالأكثر قوة ونفاذ سلطة، كانت استجابة آلهة معينة أسرع، وتبعاً للمتغيرات أو المتحولات في الزمان والمكان،
ربما ما كان يجري فيما بعد، إثر ظهور الأديان، لم يغيّر في العنف كمبدأ فاعل في التاريخ، إنما في طرق التعبير ووسائل تنفيذه، كما يقول تاريخ الأديان والعنف الدموي الذي رافق الأديان هذه.
إنه عنف متحول لم يتوقف بقدر ما تنامى واكتسب صيغاً جديداً في التعبير وأساليب القتل، بوجود ضحايا من البشر تحت مسمَّيات شتى.
إنه نوع من عكس التاريخ مع سبق الإصرار والتعمد، بصحبة أعداد لا تتوقف من القرابين البشرية تعبيراً عن حقيقة هذه الوثنية المسيَّسة، باعتبارها التمثيل الحرفي للدين السائد، وإزاحة ما كان ديناً سابقاً، رغم كل الحديث المشير إلى لائحة أماكن عبادته من جوامع وكنائس.
باختصار: إننا نعيش تحت إمرة مقرَّرة من الآلهة الجدد!
أعني بذلك حين نمعن النظر في مشاهد عنف مصورة ومتلفزة، تمثّل عنفاً متعدد المقامات في الشارع السوري اعتماداً على قوى منظمة من قبل النظام بالذات، وهي لا تدخر جهداً في تعزيز حقيقة هذا التأليه وإلزام المقبوض عليهم أو الجاري التحكم بهم بضرورة الخضوع لهذا القانون المرئي ومن يؤلَّه باسمه في الهرم الأعلى للنظام ومن يليه مرتبة، أو من يجد لنفسه فرصة تأليه نفسه بمزيد من إركاع الآخرين، وهي عبودية مستحدثة، وإخلاص للوثنية القديمة تلك، وتحويلهم بالجملة إلى رعايا تحت الطلب في نطاق تهم جاهزة، استجابة لمبدأ الإله الوثني الذي يَسأل ولا يُسأل، وأدوات تنفيذ عنفه وهي توجَّه القانون القائم باسمها: قانون الإله المشخص تماماً، حيث إن انتشار التماثيل والصور بأحجام وقياسات مختلفة تعبير عن هذا التوجه، إلا أن اللافت هو أن العلاقة مع هذا المعبود المدعَّم سلطوياً يتظلل بتدعيم ديني موجه، إذ يكون رب الأرباب: الله، الحارس المعيَّن له ما بقي نفوذُه.
إن تأليه الرئيس حرفياً، أو أياً كان، يترجَم من خلال تاريخ لم ينفصل عن ذاكرتنا الجمعية، تاريخ العقاب الجماعي، مراعاة للسلطة الأحادية في واقع أمرها، وهو العقاب الذي يبحث عن الخطأ أو الخلل أو الإثم وفق مسوّغات مقرَّرة من خلال المسافة الفاصلة بين الحاكم والمحكوم.
إن الإله لا يخطىء، ووقوع خلل ما، يشير بوصفه مقدمة لاضطراب أو تعكير صفو الحاكم الأوحد ومن يتحرك في ظله أو باسمه، إلى عنف كامن على أرض الواقع: الشعب: الرعية، ونوع العقاب يتوقف على نوعية التصرف القائم، كما هو الممكن النظر فيه في الشارع السوري من خلال القوى المرعبة وهي ممثلة النظام بعُدتها وعتادها وأجهزة إعلامها ودعاياتها.
إنه واقع كارثي مشهود له بين جهتين، لا يبدو أن هناك تقارباً بينهما، طالما أن الوثنية المستجدة هذه تلغي ما عداها، حيث التجرد مما يقبل المقارنة بالذات غير مجدٍ: لأن التأليه، يخرج ممثله مما هو بشري فيه، وهذا يمنحه صلاحيات غير محدودة، وفي ضوء هذه الامتيازات يكون القتل والعنف والترويع على قدم وساق، بينما الرعية وقد جرّدت من خاصيتها البشرية محوَّلة إلى ما هو حيواني، فيعني الدفع بها إلى المسلخ أو إبقاءها على عتبته، كما لو أن الدم المسفوك في مشاهد حية، يلخص العلاقة هذه، وأن ليس من وعد قريب بالكف عنه.
في منظور النظام، وكما هو مقروء في سجله السياسي اليومي، وحتى كتابة هذه الكلمة، يكون الخطأ دائماً خطأ المتحرك على الأرض: الشعب في جملته! إن الدم دمه، والموت موته، والخراب خرابه.
لا بل يظهر في قراءة سريعة لطريقة تعامل الجلاد في تنوع أسمائه، مع الضحية: الشعب، الرعية، أن ثمة عبأ يتحمله الجلاد، يكلفه جهداً، جرَّاء انشغاله بـأحداث جارية في الشارع من” عصيان- وتمرد- وانتفاضة- وثورة..”، ليكون العنف الدموي مرجوعاً إلى الضحية، بقدر ما يكون تلبية لرغبة الجلاد في اشتهائه للقتل كلما شعر أن هناك ما يقلقه أو يتهدد مقام ألوهيته، لكأن وجود الضحية سبب كاف وقسري لظهور الجلاد الاضطراي، وأن الإجهاز على الضحية هو نوع من تطهيرها مما هو دنسٌ فيها: عنفها، بينما يكون الجلاد مرتبطاً في عُرف معلمه أو من يوجهه باعتباره الإله، بعنف يبرَّأ منه في منطق وثنيته المركَّبة، ليكون القاتل معفى من المحاسبة لأنه لسان قضاء هنا.
وباستعادة أولية لمنطق الأسطورة القديم، يكون الإله ممثل النور والحياة السرمدية، جلي الأبعاد من خلال معاينة دورية لقطع الكهرباء وأجهزة الاتصال والمياه، ليكون هناك الظلام وصمت القبر والتحضير للموت، والعملية ليست أكثر من إنذار مستمر بالعقاب الجماعي حيث مفتاحه بيد المتنفذ الأول: الجاري تأليهه ومن معه طبعاً!
كأن الحل الوحيد حتى اللحظة، هوأن تستغفر الضحية جلادها، وبالمقابل أن يسعى أهل الضحايا أو من يريدون سلوك طريقها ولم تتم تصفيتهم بعد، أن يسعوا إلى طلب العفو من الجلاد، وهذا بدوره يتلقى الأذن بالتوقف عن سفك الدماء، من الإله الأرضي وهو مرئي هنا وهناك، كما هو المتردد على ألسنة أعوانه وحفظ نظامه..
إن عذاب الضحايا مرتبط بأمل لا يقاوَم حتى وهم يُقتَلون، بينما متعة الجلاد فهي مرتبطة برعب نهايته الوخيمة!