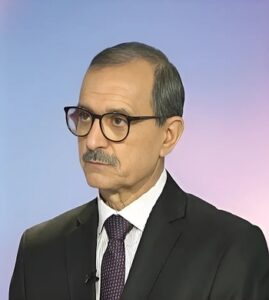ماجد ع محمد
بما أنَّ الكتلة البشرية الأعظم المشاركة في الثورة ما تزال مشغولة فقط بإسقاط الظالم وليس الظُّلم، وهدم الطاغي والاحتفاظ بركائز الطغيان، فهذا يعني بأن ثورات هذه المنطقة ما تزال على السطح، ومعنية بإزالة الغلاف مع عدم التركيز على الطبقات التي أفرزت تلك القشور. والدليل المرئي على ذلك أننا شهدنا تحطيم تماثيل بشار الأسد، ولكننا رأينا كيف أن الذين يُدمِّرون تماثيل الطاغي الصغير ويمزِّقون صوره، هم في الوقت ذاته يُزيِّنون عرباتهم بصور دكتاتور كبير على مستوى الوطن العربي.
كما أن المجتمعات التي لم تغرس في تربتها عميقاً قواعد العدل والحق والموضوعية ستبقى أسيرة الهوى، وتميل على الدوام إلى مَن يداعب مشاعرها حتى وإن كان الذي يُناغيها متخلِّفاً، منافقاً، مُضلِّلاً أو مُحتالاً. لذا، فمن يغنّي خارج السرب الهائج سرعان ما يتم قدحه، تخوينه أو الدوس عليه، حتى وإن كان في الأمس القريب محبوباً من قِبل أفراد السرب نفسه. فأن تتكلم في لحظة ما بكلمة حق تخالف تصوّرات المهتاجين، توقّع بأن يُحكم عليك بالإبعاد في عُجالة غير متوقعة منك، وربما تحل عليك اللعنة في لمح البصر، طالما أن الحكم عليك سيأتي سريعاً من قِبل أناس يُبصرون أمامهم، ولكنهم من فيض التشحُّن والاحتقان حُرموا من نعمة البصيرة.
وحيال من لا يجد له مكاناً بين الفرقاء عندما يُصرّ على قول ما يخالف ظنونهم، ذكر مغنّي الملاحم الكردية عبدالرحمن عمر (Bavê Selah) يوماً، أنه إبان مرحلة الشباب سمع قصة طريفة عن تبعات النطق بكلمة الحق، وكان ملعبها الرئيس بين فريقين من الفتية في إحدى قرى منطقة عفرين، حيث كان شباب تلك القرية منقسمين، وكل واحد منهم كان يميل إلى الفريق الذي يشبهه ويتآلف معه ويندمج فيه بكل هواجسه، إلا شاباً واحداً كان يشعر بالوحدة ولا يجد له موطئ قدم بين أي فريق منهما. فقالت له والدته يوماً: يا بني لماذا كل شباب القرية يجدون أناساً مثلهم، يتسامرون معهم، ويرتاحون إليهم، إلا أنت لم تستطع إلى الآن أن تنسجم مع أي جهة منهم؟ فقال الابن: أمي، أتريدين الصراحة؟ قالت: نعم. فقال: لأني أقول الحق بدون رتوش وبدون مجاملة أحد، فلا يقبلون بي، لذا أراني غريباً عن الفريقين ولا أجد نفسي مع أي رهط منهما. فقالت الوالدة: ليس معقولاً أن يكون كلام الحق وحده هو السبب في بقائك خارج الفريقين، لا بد أن العلّة بك أنت، وأن ثمة سبباً آخر تُخفيه عني. قال لها: صدقيني يا أمي، هذا هو السبب، وما من سبب آخر غيره. وقال لها: والدليل حتى أنتِ، فإذا ما نطقتُ بكلمة الحق فقد تعملين مثلهم. فقالت له: هات الذي عندك لأعرف إن كنتَ صادقاً أم كاذباً. فقال لها: أمي، بعد أن مات أبي بستة أشهر، ذهبتِ إلى الطبيب لسبب يتعلق بأمراض النساء، وقال لكِ الطبيب وقتها: مبروك، أنتِ حامل في الشهر الثالث. فمن هو يا ترى والد الولد الذي في بطنك إذن، طالما أن والدي مات قبلها بستة؟ فقامت الأم على الفور ورفعت الكلاش لتضربه به، وهمّت بطرده من المنزل. فقال لها الابن وهو يهرول نحو الباب: أرأيتِ يا أمي، فحتى أنتِ أيضاً طردتِني لأني جاهرتُ بكلمة الحق.
وفي سوريا الراهنة، خاصة في ظل انتشار ثقافة الفزعات العشائرية وغياب كل ما له علاقة بالعقل والعدل والإنصاف، سواء على مستوى الشارع المهتاج، أم على مستوى نماذج قميئة من النشطاء والإعلاميين الذين يبثون الأحقاد ويتكفّلون بتسخين صفيح الاحتراب، فمن الصعب عليهم تقدير موقفك المناهض للعدوان من قِبل أي طرف كان، وبالتالي فهمك بشكل صحيح، ألا وهو أن تكون مع المظلوم وضد الظلم لا يعني البتة بأنك ستبقى إلى الأبد مع المظلوم الذي سرعان ما يتبوّأ مقام الظالم ويبدأ بمحاكاته. إنما طالما أن العدل والإنصاف هما المعيار الأقوم لديك، فهذا يعني بأن معيارك باقٍ ولو تغيّرت أدوار الظُّلام والمظلومين. وبديهي أن حالك ها هنا سيكون كحال الولد الذي بقي منبوذاً من الفريقين ومطارَداً حتى من أمه، وبأنك في هذه الحالة ستكون مكروهاً في المرحلتين، بداية في المرحلة التي دافعتَ فيها عن المظلوم ضد مرتكب الظلم، وفي المرحلة الثانية تغدو مبغوضاً من قبل المظلوم الذي أخذ دور الظالم ولم يكن أفضل منه سلوكاً.
فهذا الموقف الذي اتخذتَه من الظالم والمظلوم أياً كان، ومن المعتدي والمعتدى عليه في أي مرحلة كانت، سيدفعك إلى مقصورة الممقوتين، ليس لفعل قبيح ارتكبته، ولا لموقف عدواني اتخذته، إنما تمسُّكك بمعيار العدل نفسه هو سبب كراهيتهم لك من قبل الطرفين، لأن من كان يودّك عندما دافعت عنه حين كان مقهوراً، اليوم يبغضك لأنك تمسكت بمعيار الحق وفضّلته على من كنت تحبه، على طريقة الفيلسوف اليوناني أرسطو الذي كان يود معلمه أفلاطون جداً، ولكنه أميل إلى الحق والإنصاف من أفلاطون إبان الاختلاف.
ومن هؤلاء الذين تم التناوب على كراهيتهم من قبل طرفين من الحشود البشرية في سوريا، نخبة من الكتّاب والمثقفين والنشطاء الكرد، حيث إن تلك النخبة بقيت لسنوات غير قليلة تنتقد عيوب الإدارة الذاتية المتحكَّم بها من قِبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD)، وكانت لها مآخذها جمّة على قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وكانت تلك الأصوات تقف بالضد من سياسة حزب العمال الكردستاني (PKK) القائمة على سلب قرار الكرد السوريين من خلال كوادره وروافده التنظيمية في سوريا. وللعلم، فإبان انتقاد تلك النخبة لممارسات كوادر العمال الكردستاني وأتباعهم، واستهزائهم المتواصل بالطريقة البدائية لإدارة تلك المناطق من قِبل PYD، كان خطابهم يلقى القبول من الأطراف السورية المناهضة لسلطة الأسد، وظل خطابهم موضع ترحيب وإشادة من قِبل النشطاء والحشد البشري المحسوب على المعارضة السورية، ولكنهم في الوقت نفسه كانوا مكروهين ومتَّهمين بالعمالة والتواطؤ مع الغريب ضد القريب من قِبل أنصار وكوادر وحشد العمال الكردستاني وروافده.
بينما وقت أن بدأت طبول الحرب ضد مكونات المجتمع السوري تُقرَع هنا وهناك، ويوم بدأت شيطنة قوات (قسد) من قِبل قنوات مثل الجزيرة والعربية والعربية الحدث، إلى جانب الإعلام التركي والسوري، وصارت قسد هي الشماعة لضرب كل ما هو كردي بحجتها، فإن النشطاء والكتّاب والمثقفين الكرد الذين كانوا بالأصل مناهضين لسياسة PYD وPKK وقسد وينتقدونها باستمرار، شعروا بالخطر المحدق بمجتمعهم ككل، إذ أدركوا بأن الماكينة الإعلامية المذكورة تحقن الشارع العربي ككل، وتشحن أدوات السلطة السورية ضد الكرد أجمعين. وقتها توقفت تلك النخبة عن انتقاد قوات قسد، لأن المنطق يقول إن إنقاذ الناس من الهلاك في منطقة ما أبدى من موضوع تصويب أخطاء من يدير تلك المنطقة، بل واضطروا وقتها حتى للدفاع عن تلك الإدارة بسبب حجم التلفيق والتضليل والتدليس الإعلامي المتواصل. إذ لاحظوا بأن انتقاد الأداء المتخلّف للإدارة الذاتية أو أداء قوات قسد لا يفيد وقت يبدأ الآخر بسن سيوفه وسكاكينه التي سيتوجّه بها إلى الأهل والأقارب والمعارف، لأن التجارب السابقة أثبتت بأنه عند العدوان الهمجي لن يفصل المهاجم وقت اجتياحه الإنسان الجيد عن الإنسان السيء، بل إن الوقائع الميدانية أكدت بأنه إبان الغزوات وفي لحظات الهجمات الوحشية من قِبل فئة بشرية على أخرى، فالأبرياء هم المستهدفون بالدرجة الأولى، وهم أولى الضحايا، كما حدث في الساحل السوري مع العلويين، وكما جرى في السويداء مع الدروز، وما حصل فعلياً للعوائل الكردية في الرقة والطبقة وريف كوباني (عين العرب).
لذا فإنَّ وقوف تلك النخبة الكردية من المثقفين والكتّاب والنشطاء مع المظلومين من أبناء الطائفة العلوية بداية، ومن ثم مع الأبرياء من الموحّدين الدروز من بعدهم، ومن ثم اصطفافهم مع شعبهم في الظروف الحسّاسة، دفع الحشد الذي كان يُعجب بكتاباتهم ومواقفهم في الأمس إلى أن يكنّ الحقد والكراهية لهم اليوم. وهذا بالتحديد هو الذي دفعنا إلى تقدير جهود تلك النخبة، بل وما زاد من احترامنا لهم، على ما بدر منهم وصدر عنهم، هو لأنهم بقوا على إنسانيتهم، ولم ينجرفوا مع أي تيار عدواني شرس ضد الآخر، وظلوا متمسكين بقيمهم التي آمنوا بها في السلم وعملوا عليها في الحرب، ولم يتخلّوا عن معيار الحق والعدل والموضوعية في مختلف المراحل.