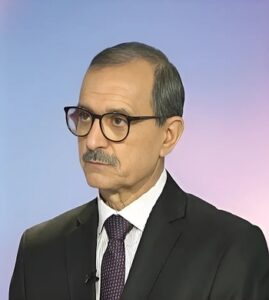آخين ولات
سأتناول هنا التعريب كمثالٍ للدراسة والتحليل، عن هذه المنظومة القمعية كوني أنحدر من غربي كردستان وعانيت شخصياً من كل ما سآتي على ذكره تالياً. لم يكن التعريب في غربي كردستان مجرد سياسةٍ لغوية، بل كان مشروعاً لإعادة صياغة الإنسان والمكان معاً. فاللغة، في يد السلطة، تحولت إلى أداةٍ لإعادة تشكيل الوعي، وإلى معيارٍ للانتماء، وإلى شرطٍ للوجود القانوني والاجتماعي. لم يكن الهدف أن يتعلم الكرد العربية، بل أن ينسوا الكردية. لم يكن الهدف أن يتواصلوا، بل أن ينقطعوا عن جذورهم، ولهذا كانت الفطرة السليمة للكردي ترفض وبشكلٍ قطعي كل هذا القمع الذي كان يُماَرَس على اللاوعي الكردي.
لقد فُرضت العربية على المدارس، والدوائر الرسمية، والمحاكم، واللافتات، وحتى على أسماء اأطفالنا. كان الاسم الكردي يُعامل كجريمةٍ، وكأن الهوية الكردية تهديدٌ يجب محوه قبل أن يكبر. هذه الممارسات لم تكن عشوائيةً، بل كانت جزءاً من هندسةٍ اجتماعيةٍ تهدف إلى خلق “كرديٍ منزوع الهوية”، كرديٍ يتحدث لغةّ غير لغته، ويحمل اسماً لا يشبهه، ويعيش في وطنٍ لا يُسمح له بتسميته باسمه الحقيقي.
الدين كأداةٍ للضبط لا كملاذٍ روحي
استُخدم الدين أيضاً كوسيلةٍ للهيمنة على الشخصية الكردية. إذ لم يكن الهدف تعزيز الأخوة بين المسلمين، بل تعزيز الطاعة السياسية. كانت السلطة ترفع شعار “الأخوة الإسلامية” حين تريد من الكرد أن يذوبوا في مشروعها، لكنها كانت ولا زالت تُسقط هذا الشعار حين يتعلق الأمر بحقوقهم أو مشاركتهم المتساوية. لم يُقبل الكردي إماماً، حتى لو كان أعلم من الجميع، لأن المشكلة لم تكن في الدين، بل في العقلية الفاشية التي احتكرته.
لقد تحوّل الدين إلى غطاءٍ لسياساتٍ قومية، وإلى وسيلةٍ لإنتاج مواطنٍ ” مطيعٍ صالحٍ” بمعايير السلطة، لا بمعايير الأخلاق والإيمان. وهكذا، وجد الكرد أنفسهم أمام منظومةٍ تريد منهم أن يكونوا “عرباً في الدين”، و”عرباً في اللغة”، و”عرباً في الثقافة”، بينما تُبقيهم في الواقع خارج دائرة الاعتراف.
التهجير: حين يُنتزع الإنسان من ذاكرته
لم يكن التعريب وحده كافياً، فكان التهجير. اقتُلعت قرىً بأكملها، ونُقل سكانها قسراً، واستُبدلت جغرافيتها البشرية بأخرى مصطنعة. لم يكن الهدف فقط تغيير التركيبة السكانية، بل تغيير التاريخ نفسه. فالسلطة التي تغيّر سكان الأرض تغيّر روايتها، وتعيد كتابة الماضي بما يخدم مستقبلها.
لكن التهجير ليس مجرد حركةٍ جسدية. إنه اقتلاعٌ للذاكرة. الإنسان الذي يُنتزع من أرضه يفقد جزءاً من ذاته. إذ أنّ الأرض بالنسبة للكردي ليست ملكيةً بقدر ما هي علاقة. علاقةٌ عميقةٌ عمق الجذور الضاربة في العمق. هذه العلاقة التي لن يفهمها من لا جذور له في هذه الجغرافيا. حين يُهجّر الكردي من قريته، لا يفقد بيته فقط، بل يفقد أسماء الجبال، ورائحة التراب، وصوت الينابيع، وكل تلك التفاصيل التي تشكل ذاكرةً جماعيةً لا تُشترى ولا تُستبدل.
الأثر النفسي: أجيالٌ تربّت على القلق والاغتراب
أجيالٌ كاملةٌ من الكرد، نشأت وهي تشعر بأن هويتها موضع شك. الطفل الذي يُمنع من تعلم لغته، أو من كتابة اسمه، أو من الاحتفال بثقافته، ينشأ وهو يحمل شعوراً عميقاً بأن ذاته غير مرغوبة. هذا النوع من القمع لا يختفي بانتهاء القانون، بل يترسخ في اللاوعي الجمعي.
لقد أنتجت سياسات التعريب والتهجير ثلاثة أنواعٍ من الجروح النفسية:
أولاً: جرح الهوية
حيث يشعر الفرد بأنّ عليه أن يخفي جزءاً من ذاته كي يعيش بسلام.
ثانياً: جرح الذاكرة
حيث تُقطع الصلة بين الأجيال، فلا يعرف الطفل تاريخ قريته، ولا يسمع أغاني جدته بلغتها الأصلية.
ثالثاً: جرح الحلم
حيث يُمنع الكردي من تخيّل مستقبل يشبهه، لأن الحلم نفسه كان مراقباً ومقموعاً.
هذه الجروح لا تُشفى بسهولة، لأنها ليست فردية، بل جماعية، تنتقل من جيلٍ إلى جيل، وتتحول إلى جزء من الوعي القومي.
الكرد اليوم: من الضحية إلى الفاعل
لكن ما لم تدركه تلك الأنظمة هو أن القمع لا يقتل الهوية، بل يقوّيها. الكرد اليوم ليسوا الكرد الذين أرادتهم مشاريع التعريب والتتريك والتفريس. لم يعودوا قابلين للذوبان، ولا مستعدين للانخداع بخطابات الأخوة الزائفة. لقد أدركوا أن التحرر يبدأ من الداخل: من استعادة اللغة، واستعادة الذاكرة، واستعادة القدرة على الحلم.
مشروع التحرر الكردي اليوم ليس مشروعاً انتقامياً، بل مشروع استعادة. استعادة الكرامة قبل الأرض، والذاكرة قبل الحدود، والإنسان قبل الجغرافيا. إنه مشروعٌ يرفض الفاشية بكل أشكالها، ويرفض الشوفينية بكل وجوهها، ويؤمن بأن الشعوب لا تُبنى بالقمع، بل بالعدالةِ والاعتراف المتبادل.
نحو مستقبل لا يُعاد فيه إنتاج الماضي
إن نقد سياسات التعريب هنا ليس مجرد استعادةٍ للماضي، بل هو شرطٌ لبناء مستقبلٍ مختلف. فالشعوب التي لا تواجه جراحها تبقى أسيرةً لها. والكرد، اليوم، يواجهون تلك الجراح بوعيٍ جديد، وبإصرارٍ على ألا يُعاد إنتاج الماضي من جديد.