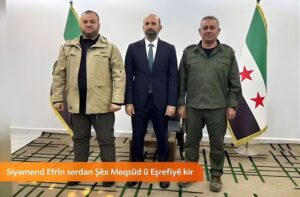خاشع رشيد
كنا ستة أصدقاء خرجنا من جامعة تشرين في اللاذقية، تحملنا الطرقات نحو دمشق كما يحمل القلب خطوة إلى المجهول. كانت المشاعر مختلطة؛ فلم نكن يَكِيتيين، بل قوميين ووطنيين، نبحث عن مكان لنا وسط صمتٍ خانق.
في تلك السنوات لم يكن الخوف قد استوطن أرواحنا، أو لعلنا كنا أصغر من أن ندرك ثقله.
خرجنا فجراً إلى الكاراج، فركبنا الباص ومعنا أحلام طلابٍ وطالباتٍ كُثر، تلمع في عيونهم رغبة خجولة للانتماء إلى لحظة أكبر من أعمارهم.
وحين وصلنا إلى الساحة قبل الموعد، مشينا اثنين اثنين، متفرقين قليلاً ومتقاربين كثيراً. هناك التقينا سكرتير حزب يكيتي، الأستاذ عبد الباقي اليوسف، الذي كان يراقب المكان بهدوء، كان يعرف أن شرارة صغيرة قد تتحول إلى حريق.
لم نكن نعرف من سيشارك معنا. كنا نجهل كل شيء تقريباً، سوى أن بعض قيادات يكيتي ستكون هناك.
لكن الدقائق التالية حملت ما لم نتوقعه؛ فبشكل عفوي ومفاجئ، وفي تمام الموعد، وجدنا أنفسنا نتجمع من كل زاوية في الساحة، كأننا خيط واحد عاد ليلتحم. رُفعت اللافتات، وبدأت خطانا تشق الشارع المزدحم. وما هي إلا لحظات حتى انطلقت حناجرنا بالنشيد القومي “أي رقيب”، ثم شعارات وحدة الشعب الكردي، وهتافات بالكردية والعربية تطالب بالحرية والحقوق، تتداخل مع أغاني شفان برور التي ما زالت ذاكرتي تحفظ منها ظلالاً.
لا أعرف كم مشينا. ربما مئة وخمسين أو مئتي متر. لكنني أعرف جيداً كيف وقفنا أمام مبنى مجلس الشعب، وكيف حاصرتنا قوى الأمن من كل اتجاه، وكيف بدا الشارع كلحظة توقف فيها الزمن برمّته.
كان معنا بيان للمظاهرة، ورقة واحدة فقط، يحملها أحد القياديين، ربما الأستاذ حسن صالح أو الأستاذ مروان عثمان.
ومن بعيد كنت أرى على وجوه الناس خوفاً وحيرة، كأنهم يراقبون مصيرهم من خلف زجاجٍ غير مرئي. وفي تلك اللحظة، وبدافع حدس لا أعرف مصدره، قررت أنا وصديقٌ لي أن نفعل شيئاً.
أخذنا البيان، اجتزنا رجال الأمن بخطوات ثابتة، وبدأنا نبحث في الشارع عن مكتبة. وجدنا واحدة، ودخلنا ونحن نرجو أن يفهم صاحبها حاجتنا. سألنا:
“كم نسخة؟”
فأجبنا:
“كل الأوراق التي لديك.”
ابتسم وقال: “تكرموا.”
طبعنا المئات. تركنا له نسخة، وعدنا نوزعها للناس في الطريق، وننثر الكلمات كمن ينثر بذوراً في أرضٍ طالها الجفاف.
تواصل رجال الأمن مع المتظاهرين، فطلبنا لقاء رئيس مجلس الشعب لنقل مطالب الشعب عبر المتظاهرين. وبعد أخذٍ وردٍّ طويلين، تقرّر أن يدخل ممثلان عن المتظاهرين. دخل الرجلان ( حسن صالح ومروان عثمان )، وظلت أصواتنا تهتف خارج المبنى، لا تهدأ.
وبعد ساعة تقريباً خرجا، فصفقنا لهما بحرارة، وارتفعت الشعارات الكردية من جديد. شرحا لنا ما جرى في اللقاء، وأنهما عرضا مطالب الشعب الكردي بوضوح، وأن المسؤولين وعدوا بإيصالها إلى رئاسة الجمهورية.
كانت لحظات الغبطة تلك عفوية وصادقة؛ كان المتظاهرون يعانقون بعضهم بعضاً، ويبتسمون رغم الخوف العالق تحت الجلد.
ثم بدأنا بالافتراق بحذر، مجموعات صغيرة متباعدة. أما نحن الأصدقاء الستة فعدنا إلى الكاراج، فرحين وخائفين في آن واحد، مستعدين لكل ما قد يحدث في طريق العودة إلى جامعتنا.
مما استخلصته يومها:
• كان الانقسام واضحاً داخل قيادة يكيتي؛ طرف يفضّل الهدوء، وآخر يُصرّ على الحراك، وقد انتصر الثاني تلك المرة.
• لم تكن المشكلة في الشباب الكردي، بل في الأحزاب التي لم تعرف كيف تكون مع شعبها. ورغم عدم الإعلان عن المظاهرة، ورغم خطورتها الكبيرة، فإن مشاركة الشباب المستقلين والدعم الشعبي اللاحق أثبتا أن الناس كانوا جاهزين للحظة التغيير. وكانت انتفاضة 2004 الشاهد الأكبر.
• لا أعرف إن كان غيرنا من المشاركين قد تعرض لضغوط أمنية، باستثناء القياديين حسن ومروان. لكنني أدركت يومها أن النظام كان أقل بطشاً حين يرى أمامه شخصاً واضحاً، سلمياً، مكشوفاً، ذا وعيٍ معقول بالنسبة لسنّه.
فلم يُسأل أحد منا بعدها مباشرة.
لكنني اعتُقلت لاحقاً مع مجموعة كبيرة من طلاب جامعة تشرين خلال ندوة سياسية للحزب الديمقراطي التقدمي الكردي.
وفي التحقيق، قال لي الضابط، وهو برتبة مقدّم:
“نحن نعرفك جيداً. نعلم أنك شاركت في تلك المظاهرة، وأنكم شكّلتم لجنة طلابية كردية تجمع كل الأحزاب والمستقلين. ونعلم بنشاطاتكم الثقافية والاحتفالية والرحلات، وبأن لديكم أول مكتبة تضم مئات الكتب، ونعرف أين هي. ونعلم أيضاً بمجلتكم الطلابية الأولى (مجلة آر).”
سأكتب يوماً عن تلك اللجنة ونشاطاتها وكيف تأسست.
تحية لكل من وقف في تلك المظاهرة، ولكل من حمل شعلةً صغيرة في وجه الظلام، وأخصّ بالذكر نحن الأصدقاءَ الستّة من جامعة تشرين.