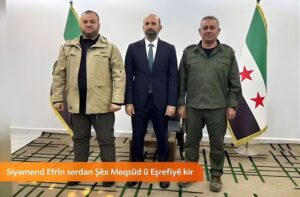صبحي دقوري
لم تعد الهوية الكوردية، في زمن العولمة والذكاء الاصطناعي، مجرد رواية تُروى أو انتماء يُعلَن. لقد تحوّلَت إلى ساحة صراع بين قوى لا تُرى، وإلى مختبر تُعاد فيه صياغة المعنى والوجود، وإلى مرآة تنعكس عليها توترات العالم كله. فالهوية لم تعُد تلك البنية التي تُسافر عبر الأجيال محافظةً على صلابتها الأولى؛ إنها، اليوم، كائنٌ حيّ، ينبض، يتألم، يتشظّى، ويتجدّد. إنّها، بتعبير فوكوي، نقطة التقاء بين قوى تُريد الإمساك بها وقوى تسعى إلى الإفلات منها، بين خطاب يُعِدّها للاستهلاك وخطاب يُعيد لها سرّها وعمقها.
لقد كشفت العولمة هشاشة الحدود وصيرورتها التاريخية. لم تعد الجغرافيا ضمانةً للهوية، كما لم تعد الدولة القومية قادرة على إخفاء جروح الشعوب التي قمعتها. فجأةً وجد الكورد أنفسهم في فضاء كوني مفتوح، يُسمَع فيه الصوت الذي صودِر طويلاً، وتظهر فيه الملامح التي سُوِّيت بالأرض عقوداً. لكنها حرية لا تخلو من فخاخها؛ إذ قد تتحول الهوية، إن لم تُنقِذ نفسها، إلى صورة متحف، أو إلى رقصة فولكلورية تُعرض على الشاشات، أو إلى علامة تجارية تنتمي لاقتصاد لا يعترف إلا بما يمكن بيعه وتدويره.
العولمة، إذن، قوّة مزدوجة: تُعرّي وتُزيّف، تكشف وتُخفي، تفتح الباب وتدفع بالداخلين إليه نحو فقدان الجذور. فهي تمنح الكورد حضوراً لم يعرفوه من قبل، لكنها في الوقت ذاته تُحاصر هذا الحضور بلغة مركزية تريد أن تُعيد كتابة كل شيء، بما في ذلك التاريخ نفسه. وفي هذه العملية المزدوجة، وُضِعت الهوية الكوردية أمام سؤال لم يكن ممكناً طرحه سابقاً: كيف نحافظ على المعنى بينما ينفرط كل شيء حولنا؟ وكيف نحمي الذات من أن تتحول إلى نسخة رقمية من ذاتٍ لم تعد موجودة؟
ثم جاء الذكاء الاصطناعي، ليس باعتباره أداة، بل باعتباره شكلاً جديداً من السيادة، وسلطةً لا تُشبه أي سلطة أخرى. إنه، كما يصفه دريدا، كتابة جديدة لا تُنتج الذاكرة فقط، بل تُنتج شروط الذاكرة. كتابةٌ بلا مؤلف، قادرة على إعادة تشكيل الوجود عبر الخوارزمية، وإعادة تصنيف البشر واللغات والثقافات وفق معايير لا يضعها الإنسان العادي، بل تُقرّرها أنظمةٌ رقمية تتغذّى على ما يُتاح لها من بيانات.
وهنا تكمن خطورة اللحظة:
إذا دخلت اللغة الكوردية إلى هذه المنظومات ضعيفة تمثيلاً، ناقصة الحضور، مجتزأة النصوص، فإنّ الذكاء الاصطناعي قد يُعيد إنتاج تهميشها لقرون أخرى. فالنماذج التي لا تجد ما يكفي من المواد تتجاهل ما لا تفهمه، وتُسطِّح ما لا تستطيع الإمساك بعمقه. فيصبح الكوردي، في عين الخوارزمية، مجرّد “أقلية لغوية” أو “متغير ثقافي”، لا شعباً ذا تاريخ ورغبة وصوت
لكن الوجه الآخر لهذا الزمن لا يقلّ إشراقاً. فالذكاء الاصطناعي، إذا استُخدم بوعي وبصيرة، قادر على حماية الهوية أكثر ممّا فعلت الجغرافيا، وعلى منحها استمرارية قد لا تطيقها حتى الدول. فبإمكانه أن يخلق أرشيفاً كورديّاً لا يُمكن إبادته، وأن يُحيي لغةً حوربت قروناً طويلة، وأن يجعل من الطفل الكوردي في المنفى قادراً على تعلّم لغته كما لو كان في قريته الأولى. ويمكن للخوارزمية أن تصبح، لأول مرة، حليفاً للكورد: تُنشر القصيدة، تُصان الذاكرة، يُوثّق المنفى، تُسرد الأسطورة، ويظهر الشعب الذي أرادت الأنظمة أن يبقى “غير موجود”.
وفي قلب هذا التوتر بين الافتراس الرقمي والإمكان التحرّري، تقف الهوية الكوردية أمام سؤال أساسي:
هل هي هوية تريد أن تُحافَظ كما هي، أم هوية تمتلك الشجاعة لتُخترَع من جديد؟
هنا يحضر نيتشه: الهوية ليست ما ورثناه، بل ما نصنعه من هذا الإرث. وهي ليست ما نتمسك به خوفاً، بل ما نُعيد تأويله بإرادة وقوة. ليست القداسة في الماضي، بل في الطاقة التي يُحرّكها داخلنا.
وهكذا تصبح الهوية الكوردية مشروعاً مفتوحاً: مشروع مقاومة، ومشروع كتابة جديدة، ومشروع تفكيك للصور التي صُنعت عنها طوال قرن، ومشروع حضور يتجاوز الخرائط التي قسّمتها السياسات. إن العولمة والذكاء الاصطناعي، بما يملكانه من سطوة وسطوع، ليسا تهديداً إلا إذا تخلّى الكورد عن حقّهم في تفسير أنفسهم. وهما ليسا خلاصاً إلا إذا امتلكوا شجاعة الصعود إلى مستوى هذا الزمن، وجعل التقنية حليفاً، والخطاب سلاحاً