إبراهيم اليوسف
“لا تأتي الطاعة بطلب استجداء عاطفي أوفرضي ممن يتنطّع لسلطةٍ ما، بل تأتي حصيلة تفويضٍ صريح، ومساءلةٍ قائمة، والتزامٍ فعليٍّ بالقانون الذي يحاكم الحاكم قبل المحكوم”
أحدهم
منبرٌ ومنبر يطلب ما لم يؤسس له!!!
ألقى السيد أحمد الشرع في صلاة فجر يوم الجمعة ٦ كانون الأوّل ٢٠٢٤، خطبة في المسجد الأموي، تضمّنت دعوةً مفاجئة صريحة، غير مؤسسة على التسويغ من قبله، إلى طاعته. أجل، هكذا طاعته- من الباب إلى الطاقة- ما دام أنه” يطيع الله”- وما أدرانا!؟، موجِّهاً هذه الدعوة إلى السوريين في لحظة انتقالية شديدة الحساسية بعد سنوات طويلة من الاقتتال والانقسام والتشظّي الاجتماعي والسياسي. إن اللافت في هذه الخطبة لا يتعلق بالمكان ولا بالتوقيت وحدهما، بل بالفكرة التي أُدخلت إلى المجال العام لأول مرة بهذه الصراحة: “تحويل الطاعة من شأن ديني شخصي باطني إلى طلب سياسي موجّه إلى مجتمع كامل”، وفي سوريا: الملايين الذين يرون أنفسهم يطيعون الله- أكثر منه- وهم الأبعد عن إلحاق الأذى بالآخرين أكثر منه، والأكثر نضالاً وطنياً أكثر منه، بل والأكثر تضحية منه، لاسيما أمام السؤال:
ما الذي خسره السيد أحمد الشرع وهو في سوريا من أجل السوريين؟ ولن نقول: ما الذي ربحه على غير استحقاق وهو في سوريا؟
وإذ تُطرَح الطاعة العمياء- كما هي حقيقة الطلب- بهذه الصيغة، فهي تتعكز على افتراض توافر الإيمان الفردي الذي لا يخضع للمراقبة ، ولا للفحص ولا للمساءلة، ولا لمعيار: الإقرار أو الرفض أو الشك، لأنه يربط بين أمرين: افتراض بل فرض الطاعة الشرعية السياسية، وهنا تبدأ الأزمة الفعلية للخطاب. “الشرعية في أي نظام حديث لا تُستمد من خطاب ديني ولا من موقع منبري”، بل من تفويض عام، ومن مشاركة سياسية حقيقية، ومن خضوع دائم للمحاسبة. أما الطاعة الدينية فهي علاقة داخلية بين الإنسان وما يؤمن به، ولا يمكن نقلها إلى حيّز الدولة دون أن تتحول إلى أداة هيمنة وتسلّط وطغيان.
وحقيقة، فإن سوريا ليست مجتمعاً أحاديّاً، بل هي بلد متعدّد دينياً ومذهبياً وفكرياً وثقافياً. فيها المسلم والمسيحي والإيزيدي واليهودي وغيرهم، وفيها من يتبع هذه الطائفة الإسلامية أو تلك، بعيداً عن تقويم إحداها، وفيها من يؤمن وفيها من لا ينطلق من سمة الدين- أي دين كان- في تنظيم حياته. من هنا فإن أي خطاب يطلب طاعةً موحّدة بصيغة دينية يصطدم مباشرة بواقع بنية وتركيب المجتمع، ويحوّل شريحة واسعة من السوريين إلى غرباء داخل المعادلة الوطنية، لا لأنهم خارج الدولة، بل لأنهم خارج صيغة الطاعة المعروضة.
وتزداد الإشكالية حين يصدر هذا الخطاب من موقع يسعى إلى الإمساك بالسلطة السياسية، بل تمسك بها، عبر مصادفة، أو من دون توافر أي من شروطها، إذ يصبح السؤال مباشراً: على أي أساس يُطلب من السوريين طاعة شخص بعينه وهو لايملك مشروعية الإقرار برئاسته خارج تعصب فئة سرعان ما قبلت به وسرعان ما ستتخلى عنه بعد أي تغيير جديد، فيما إذا تم، وذلك على ضوء تجارب تاريخية منذ بداية تأسيس سوريا وحتى الآن؟، فمن المعروف أن سوريا لم تُستنزَف بأفعال فرد واحد، ولم تُحفر تضحياتها على يد جهة بعينها، لأن الواقع يؤكد أن ملايين السوريين ناضلوا، وسُجنوا، وسقطوا، وتشردوا، وخسروا بيوتهم وأعمالهم وأبناءهم، ولعل السيد أحمد الشرع الأقل من بين كل هؤلاء دفعاً لفاتورة النضال- السوري- وأحدد- هنا- نوع هذه الفاتورة. من هنا فإن تحويل شخص واحد إلى مركز للطاعة يفصل بين التضحيات الجماعية ومصير السلطة، ويعيد إنتاج فكرة الحاكم بوصفه أعلى من المجتمع لا ممثلاً عنه.
فكرة الطاعة التي طُرحها السيد الشرع بعد أن قال فيما قبل” أنا خادمكم” جاء على إيقاع بعد هوسات وهلوسات الولاء والمسيرات المسيرة التي أكدت عدم امتلاكها- عبر التاريخ- أي رصيد مستقبلي، فهي تصطدم مباشرة بذاكرة سورية مطعونة مفتوحة على دماء و خسارات لم تُغلق بعد. إذ كيف يُطلب الامتثال وقد نام لياليهم – في زمن الحرب-في هذا الوطن آلاف آلاف الأطفال على أصوات القصف بدل الحكايات، وفي المخيمات بدلاً عن البيوت الآمنة، إن لم نتحدث عمن قتلوا وأبيدوا تحت وابل القصف والبراميل، وكيف يُطلب الانقياد والخنوع وقد تيتم آلاف آلاف بعد أن قُتل آباؤهم، وكيف تُرفع الطاعة بوصفها قيمة أخلاقية فيما واقع الدولة يحتفظ في صفحاته بمسبيّات ومهجّرات ومعتقلين لم تعد ولن تعود “أجسادهم” إلى ذويها.
مشروع سؤال الطاعة العمياء- هنا- لا يقف عند هذه الجملة المنطوقة بدثار ارتباكها وارتجاليتها وإن في صيغة الثقة. إنه يدخل في جوهر المسؤولية، لأن من يطلب طاعة عامة يضع نفسه تلقائياً في موقع المحاسبة العامة لا في موقع الوعظ الذي لا شأن له بمهمة من يصل الجامع في شكل- رئيس- أو مترئس، مفروض، لايمكنه أن يكتسب الشرعية حتى لو نال أصوات كل السوريين، مستقبلاً، بعد تشبثه بكرسي السلطة واستقراره في القصر الجمهوري، من دون جواز سفر شرعي- شافع- إلى هذه المهمة، لاسيما إن لاوقع لكخطابه في مصل مقابل في: كنيسة أو كنيس أو بيت إيزيدي أو أي معبد غير إسلامي. حيث ثمة جدار فاصل بين المهمتين: “الرئيس الحاكم والخليفة”، وهما لا تلتقيان إلا في مخيال هذا الفتي القادم من- عالم الجهاد محدد الرؤية- بعد أن تولدت لدى السوريين القناعة أن مكان المقاتل- آمراً ومأموراً وليس متآمراً- الثكنة تحت أمرة السياسي الوطني المحايد، بعد كل ما ألحقه المجاهد الفصائلي وجيش النظام، ومن حولهما من الطرفين: القاتل الأجنبي، بالسوريين، من الويلات والمآسي والكوارث.
إن واقع الدولة لا يُمحى بخطبة ولا بنداء. لقد التهم الاقتتال المجتمع من داخله، كما إن الفزعات التي جرت باسم العشائر ضد هذه الطائفة أو تلك عمّقت الشقوق بدل ردمها، وبات الوقوف إلى جانب هذا الطرف أو ذاك موقفاً غير محايد، وهو ما لم يتم إلا بأمر من الرئيس ذاته المسؤول عن كل نقطة دم سوري أريقت ظلماً، ليكون كل ما تم انخراطاً في منطق الاستقطاب الذي حوّل السوري إلى عدو لسوري آخر، وكان للفصائل المنفلتة لاسيما جميعها: التابعة للنظام أو التابعة للجهات الدخيلة جميعها دور كبير فيها. إن أية طاعة تُطرَح في سياق كهذا تتحول من فكرة دينية إلى مطلب سياسي يفتقر إلى الأساس التعاقدي مع طرف هو الأساس في المعادلة، من قبل آخر لا يمتلك أدوات الشرعية القانونية، لأن التعاقد لا يُبنى فوق قبور مفتوحة ولا فوق جراح لم تُعالج، بل فوق اعتراف كامل بما جرى، وفوق مساءلة واضحة لكل موقع مشاركة في هذا المضمار الأليم..
أجل، إن هذا الخطاب الذي ظهر على نحو غير مدروس- نتيجة نوازع الهوس بالسلطة- لا يقف عند حدود دعوة أخلاقية، بل يقترب في عمقه من بنية فكرية تستدعي (نموذج الوالي أو الأمير)، حيث تُطلَب الطاعة قبل النقاش، ويُعرَّف الصواب من موقع السلطة لا من موقع التعاقد الوطني. هذا النموذج الخطابي ذي البعد النرجسي المتضخم يتناقض مع فكرة الخروج من الحرب، لأن المجتمعات التي خرجت من الاقتتال لا تُعاد صياغتها بالأوامر ولا بالامتثال، بل بـ(عقد سياسي جديد) يقوم على التعدّد، وعلى توزيع السلطات، وعلى الاعتراف بالحقوق المتساوية.
إن من يقول: إن الطاعة لله، يُغفل أن هذا القول لا يصلح أن يكون معياراً سياسياً، لأن الطاعة في معناها الديني لا تُقاس في السلوك العام ولا تُمتحن عبر المؤسسات. وقد قدمت التجربة السورية نفسها أدلة قاسية على أن من رفعوا شعارات الطاعة تورّط كثير منهم في القتل، والفساد، والتحريض، واستباحة الدم. ولهذا فإن الربط بين الادّعاء الديني والسلوك السياسي لم يمنع الجريمة، ولم يحمِ الضحايا، بل استُخدم مراراً لتسويغ العنف.
هنا يظهر لنا جلياً جوهر الاعتراض، ألا وهو: إن “الدولة لا تُدار بمزاعم أو مقومات الإيمان وأنا أعدني مؤمناً بل بالقانون”. كما إن الرئاسة ليست مقاماً روحياً، دينياً، سماوياً، بل وظيفة أرضية عامة تُستمد من التفويض الجماهيري العام وفق تكوين كل بلد، وتُضبط بالدستور الذي يكتبه أبناء البلد جميعهم، لا مجرد أدوات سلطة وأنفار مجندين، ممالئين، أتباع للمنفعة الذاتية والسلطة، وتُراقَب بالمحاسبة، فهي تعنى بكل الطيف السوري الذي لا يمثل مصلو فجر الجامع الأموي إلا جزءاً منهم، ولربما قد جيء بهم، بعد اختيار ودراسة، لا على شكل عفوي، لاسيما إن إيمانية الرجل ومقوماتها بدءاً من الوضوء وانتهاء بتاريخ الطاعة غيرالجهادي غير مشهود لها من قبل المصلين العفويين أو المجندين حضوراً. ولهذا، فإن من يريد أن يؤسس- لسوريا لكل السوريين- فهو لا يبدأ من الرهان على امتحان عقائدهم، ولا من تصنيف طاعاتهم، بل من ضمان حقوقهم، ومن احترام اختلافهم، ومن صون حريتهم في الإيمان أو عدمه.
ما ورد في الخطبة العصماء- خطبة الفجر- أو خطبة منام الليلة الفائتة، لا يمكن التعامل معه كمجرد زلّة لفظية عابرة- تتطلب الاعتذار عنها- بل من خلال اعتباره مؤشراً على اتجاه فكري يحتاج إلى تصحيح علني، من قبل مدعيه، أو رفض علني من قبل كل مواطن معني ذي رأي حر. لاسيما إن المطلوب هنا ليس سجالاً دينياً، بل مراجعة سياسية دنيوية واضحة، لأن من شأن استمرار هذا المنطق أن يفتح الباب أمام تحويل الدولة من إطار جامع إلى سلطة أخلاقية فوق المجتمع، وهذا هو المدخل التقليدي لكل أشكال الاستبداد.
وأخيراً، لابد من معرفة أن المسألة لا تتعلّق بنوايا مضمرة، بل بعقد جد ضروري دفع السوريون ثمناً كبيراً لتأمين أدواته، بما لا تتسع له أهواء أي خطيب عابر أو فحوى خطبة تتكىء على ما هو روحاني، غير مخْبري الاستقصاء والنتائح. لأن كل مشروع قيادي وطني يتأسس و يبدأ ويفرض ثقافة طلب الطاعة العمياء قبل بناء التعاقد، ويضع شرط الانقياد أو الخضوع والامتثال للذات الدنيوية الفردية المطلقة – بكل أهوائها لاسيما بعد اكتشاف نوازعها عبر التهافت على بريق العرش- قبل سن شروط ومقومات واقع ومستقبل الشراكة، ينتهي غالباً إلى رامة إعادة إنتاج الصراع لا إلى إنهائه. ومن الضروري الإقرار بأن دحض هذا الطرح ليس خصومة شخصية البتة، بل هو دفاع عن مشروعية مستقبل الدولة باعتبارها ملكاً عاماً، لا ملكيةً موروثة أو مكتسبة أو سبية لشخص أو جهة. ويقيناً، إن أية دولة تُبنى على أس< الطاعة العمياء يعاد فيها إنتاج أسباب الانفجار، وفي المقابل إن أية دولة تُبنى على (أسس الحق والمساءلة) تفتح الباب أمام خروج فعلي من زمن الاقتتال، وتدفعنا للتوجه إلى بناء وطننا” التشاركي”” وطننا جميعاً”. وطننا المنشود، بعيداً عن غوايات ونوازع بريق وهالة دولة الخلافة، ولا دولة الإمارة، أو السلطنة، أو المملكة كحلم مضمر مدغدغ، فيما تم تجاهل حلم شعب عظيم بكل مكوناته وأشكال فسيفسائه.




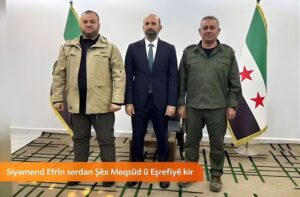


هو عم يخاطب جمهور السنة اللذين يرتاحون المساجد فقط و من المسجد وبعد الصلاة
وقال لهم اطيعونا يعني له وللحكومة
ما اطعنا يعني الحكومة وهو
الله فيكم يعني جمهور السنة اللذين يرتادون المساجد.
لما بدو يخاطب بقية أطياف المجتمع السوري فيخاطبهم من خارج المسجد من القصر الجمهوري و دوائر الدوله الأخرى
بلغة أخرى تتماشى مع كونه رئيس لكل السوريين. من المعلوم ان نوعية الخطاب وشكله يختلف باختلاف الجمهور و المناسبة