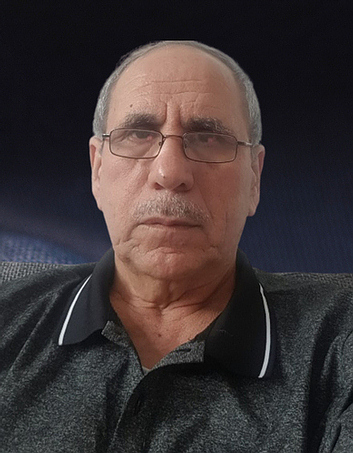خالد بهلوي
للأسف الشديد تغيّرت النفوس، وانتشرت مشاعر الحقد والكراهية والحسد والغيرة، وغلب التفكير بالثأر والانتقام الأعمى، خاصة بعد سنوات من القتل والتدمير الذي مارسته فصائل مسلّحة كانت تنفّذ عمليات القتل خدمةً لأجندات ومصالح دول وحكّام مستبدّين.
فترسّخت فكرة الانتقام الطائفي والمذهبي في عقلية من يعتبر نفسه ضحية، فينتقم عشوائيًا من دون معرفة القاتل الحقيقي. ومع انعدام الرادع الأخلاقي والإنساني، أصبح القتل ثقافةً عامة. وفي ظل غياب القانون والمحاسبة، يبقى المجرم حرًّا طليقًا يواصل جرائمه. وتزداد أعمال الثأر في الحالات الفردية ضمن هذه الثقافة، حتى بات قتل الأخ لأخيه، أو القريب لقريبه، أمرًا ممكنًا في لحظة غضب.
ومع انتشار ملايين قطع السلاح بين المدنيين والجماعات المسلحة، أصبح أي خلاف شخصي أو عائلي قابلاً لأن يتطوّر إلى جريمة قتل بسهولة. ومع انعدام الإنسانية في قلوب بعض البشر، صارت مشاهد الخطف والسرقة وحرق السيارات والمنازل، بل حتى الغابات، أحداثًا يومية يتابعها المواطن على شاشات التلفاز.
وهكذا، باتت حالات الثأر الفردي لا تثير اهتمام أحد أمام هول ما جرى في السنوات الماضية وما يزال يجري يوميًا. ومن المؤسف أن يستمر التفكير بالانتقام غير المبرَّر، والثأر والثأر المضاد.
لقد أدّى ما جرى في سورية إلى تدريب وترويض العقل البشري، ولا سيما بين الشباب والناشئة، على القتل بوسائل بعيدة عن القيم الإنسانية، مما جعل ارتكاب الجرائم أكثر سهولة حتى لأسباب تافهة. وأصبح كثيرون على استعداد لارتكاب جريمة في أي لحظة.
يُعدّ الأخذ بالثأر من الظواهر الاجتماعية المعقّدة المتوارثة في بعض المجتمعات، متجاوزًا حدود القانون والشريعة. وهو بمثابة قتلٍ عمدٍ مع سبق الإصرار والترصّد، لأنه يتم التخطيط له ومراقبة الضحية قبل التنفيذ بوقت كافٍ. وأحيانًا يُكلَّف شاب قاصر بتنفيذ الجريمة لتخفيف الحكم بحجة عدم إدراكه للنتائج، تحت شعار “غسل العار” حتى بين أبناء العائلة الواحدة، وذلك بسبب غياب المحاسبة الفعلية.
كما أن عدم تطبيق القانون بشكل صحيح يضاعف من حالات الثأر، خاصة في جرائم ما يُعرف بـ”غسل الشرف”، حيث يُطبَّق القصاص على المرأة أو الفتاة فقط، فيما يمارس الشاب المشارك في الجريمة الجنسية حياته بحرية ويتزوج من أخرى. وهكذا تنتقل فكرة غسل العار والثأر من جيل إلى جيل، من دون التفكير جديًا في وضع حد لهذه الجرائم.
إن الثأر والعنف يؤديان إلى تفكك الأسر وعزلها اجتماعيًا، فتعيش في حالة خوف وقلق مستمرين، وتنعدم الثقة وتزداد العداوة بين الأفراد والجماعات، مما يؤثر سلبًا على النسيج الاجتماعي، ويسبب سلسلة مرعبة من الفعل وردّ الفعل، ليستمر دوّام العنف والخوف من المجهول.
وتتحمّل الدولة مسؤولية أساسية في فرض سيادة القانون وحماية المواطنين من جميع أشكال العنف، بما في ذلك جرائم الثأر، وضمان تطبيق العدالة بشكل فعّال ونزيه. كما يجب تعزيز قيم التسامح ونبذ العنف في المناهج التعليمية ووسائل الإعلام، ودعم المبادرات المجتمعية التي تعمل على فضّ النزاعات قبل تفاقمها، إضافةً إلى تقديم الدعم المالي والاجتماعي للأسر المعرّضة للخطر.
ويمكن للمؤسسات الدينية (الجوامع والكنائس) أن تلعب دورًا توجيهيًا فعّالًا من خلال الخطب والمجالس والدعوة إلى التسامح ونبذ العنف، والتفكير جديًا في إنهاء حالات الثأر والثأر المضاد.
كما تستطيع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني تنظيم حملات توعية مكثّفة، وورش عمل، ولقاءات حوارية لتأصيل قيم التسامح والمصالحة بدلًا من العنف والقصاص الشخصي، خاصة في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة الثأر.
ويجب تثقيف أفراد المجتمع، ولا سيما الشباب، حول الآثار المدمّرة للقتل على النسيج الاجتماعي، وعواقبه الاجتماعية والمعيشية ليس فقط على الجناة، بل على عائلاتهم أيضًا، إذ تتشرّد أسر كاملة وتُجبَر على الهجرة إلى مناطق بعيدة عن أسرة القاتل، تاركةً بيوتها وأرزاقها لتعيش في غربة يطبعها الخوف والرعب من أي شخص قد يُظنّ أنه جاء لينتقم.
قد تكون المصالحات العشائرية وسيلة فعّالة لحل النزاعات ووقف دوامة الانتقام في بعض الحالات، خاصة في قضايا الثأر التي تتورط فيها عائلات بأكملها، لكنها لا تكفي للقضاء على هذه الظاهرة بشكل كامل.