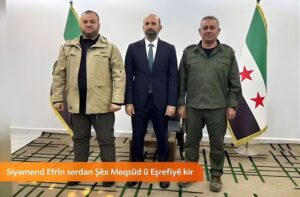صلاح عمر
عن سوريا الجديدة التي تُولد في الخفاء بينما ينظر إليها العالم بعين المصالح لا العدالة
في مشهد مفاجئ أربك التوقعات، أعلن الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب – من قلب المملكة العربية السعودية – قرارًا يقلب معادلات السنوات الماضية: رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، بعد سقوط نظام بشار الأسد وهروبه في أواخر عام 2024، وتسلم فصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام زمام الحكم، وتعيين أحمد الشرع رئيسًا مؤقتًا للبلاد لخمس سنوات، عقب إعلان دستوري مؤقت كان بمثابة محاولة أولى لولادة نظام سياسي جديد.
الخبر انتشر كالنار في هشيم بلد لم تطفئ نيرانه بعد. هل يُفهم من هذا القرار أنه دعمٌ لسوريا جديدة تنبثق من بين الأنقاض؟ أم أنه مجرّد محاولة دولية لتصفية الملف السوري سياسيًا واقتصاديًا لصالح قوى الأمر الواقع؟
ما بعد الأسد… والفراغ المليء بالخوف
لم يكن سقوط نظام الأسد مجرد نهاية لعهد، بل زلزالًا شلّ المفاصل الهشة للدولة السورية، وترك فراغًا سرعان ما ملأته القوى التي كانت تستعد من زمن خلف ستار الفوضى. هيئة تحرير الشام، التي لطالما وُضعت على قوائم الإرهاب، وجدت نفسها فجأة في مقعد السلطة، تفرض دستورًا مؤقتًا، وتنصّب أحمد الشرع رئيسًا.
لكن العالم – وتحديدًا واشنطن – لم يُبدِ تحفظًا واضحًا، بل جاء قرار رفع العقوبات كخطوة توحي، ولو ضمنيًا، باعتراف غير معلن بالسلطة الجديدة. هل هذا يعني أن ملف الثورة السورية قد أُغلق سياسيًا؟ وأن المجتمع الدولي اختار التماهي مع ميزان القوة على الأرض، لا مع تطلعات السوريين للحرية والديمقراطية؟
الاقتصاد… بين الوهم والواقعية القاسية
في بلدٍ دُمّرت فيه البنى التحتية، وشُرّدت نصف ساكنيه، وأُفقرت مناطقه، تبدو أي انفراجة اقتصادية وكأنها “بشارة”. لكن هذا الوهم قد يتحول إلى خيبة إذا لم يكن المال القادم مشروطًا بإعادة بناء الإنسان السوري، لا فقط الطوب والحجر.
فالسلطة القائمة اليوم، رغم إسقاطها للأسد، لا تزال موضع شك شعبي ودولي. وخوف كثير من السوريين أن يتحوّل رفع العقوبات إلى تمويل غير مباشر لقوة عسكرية، لا إلى دعم مشروع وطني جامع، هو خوف مشروع ينبع من تجارب مريرة.
أين الحوار؟ وأين العدالة؟
لقد سقط الأسد، لكن بقي السؤال الأصعب: من يمثل السوريين؟ من يكتب دستورهم؟ من يُنصف شهداءهم؟
أي حوار داخلي لا يتأسس على الاعتراف المتبادل بين جميع المكونات، بما فيهم الكرد الذين عانوا لعقود من التهميش والإنكار، سيكون تكرارًا لتاريخ القهر، وإن بلبوس جديد.
وأي حلّ لا ينطلق من العدالة الانتقالية، وكشف مصير المغيبين، ومحاسبة الجلادين – سواء كانوا من النظام السابق أو من القوى الجديدة – سيبقى هشًا، مؤقتًا، وغير شرعي في ضمير شعب ذاق كل أنواع الخذلان.
الكرد… الخوف من إعادة الإقصاء
حين تُرسم ملامح سوريا جديدة، دون مشاركة الكرد، الذين كانوا عماد الثورة، وحماة مناطقهم، فإن ذلك لا يعدو كونه “سوريا منقوصة”.
الكرد لا يطلبون أكثر من شراكة حقيقية في الوطن، واعتراف رسمي بوجودهم وحقوقهم وهويتهم. أي تجاهل لهذا الحق، سواء من قبل القوى الحاكمة أو من قبل من يعيدون رسم الخارطة الدولية، سيكون بمثابة انتحار سياسي مبكر للدولة الجديدة.
هل خُلق السوريون للموت كل مرة تحت راية جديدة؟
رفع العقوبات اليوم، في سياق ضبابي، يثير المخاوف أكثر مما يبعث الأمل. ليس لأن الناس يعشقون الحصار، بل لأنهم تعبوا من الوعود، من الصفقات، من تكرار الخطأ تحت مسميات شتى.
وإذا لم تتحوّل هذه اللحظة إلى فرصة حقيقية لخلق نظام سياسي ديمقراطي، تعددي، لا مركزي، يعترف بكل أبناء سوريا من دون تمييز، فإن سوريا لن تنهض، بل ستُعاد صناعتها في أقبية المصالح، لا في قلوب مواطنيها.
الخاتمة: سوريا اليوم على طاولة الأمم، لكن من سيجلس باسمها؟
لقد سقط الطاغية، لكن الخوف أن يبقى الاستبداد.
ورُفعت العقوبات، لكن الخوف أن يُرفع معها سقف المحاسبة.
واقتربت الأموال، لكن الخوف أن تذهب لتمويل من يكرر الاستبداد، لا لمن يضمد جراح الضحايا.
فمن يصون الثورة من أن تُختطف بعد موت الطاغية؟ ومن يضمن ألا يعود القهر بوجه آخر؟
الجواب، كما كان دائمًا، عندكم أنتم…
عند الضمير الشعبي… عند القلم الحرّ…
أما صمت العالم، فهو كعادته: موجع، عارٍ من العدالة، وثقيل على قلوبنا.