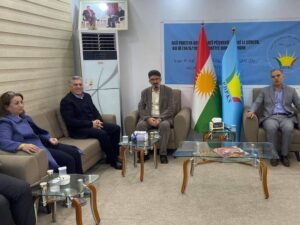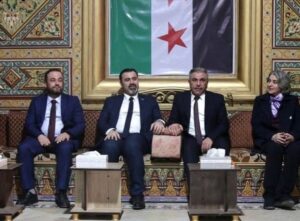محمد قاسم “ابن الجزيرة”
محمد قاسم “ابن الجزيرة”m.qibnjezire@hotmail.com
ومنهم من ينساق إلى هواه فيكتب ما لو لم يكتبه لكان خيرا له ولغيره..
ففي خضم الأحداث والمشكلات والصراعات… تحتاج المجتمعات إلى فكر نقي يستند إلى تجربة عميقة، وقدرة تحليلية؛ تتكئ على الذكاء، والاطلاع، وصدق التفاعل … مع ذلك قد لا تكون المشكلة هنا..
1- هل تصل هذه الأفكار والآراء الناصحة أو الناقدة أو المتفاعلة أو الاقتراحات أو المطالب…الخ.
إلى أنظار ووعي المعنيين من المسؤولين و المؤثرين وأصحاب القرار…؟! يبدو أن هناك شكا في ذلك..
فإذا كان أغلب الذين يكتبون لا يقرؤون، ويتخذون من بعض المقالات الصحفية الورقية أو الإلكترونية… منبع ومرجع أنشطتهم الفكرية في مختلف تجلياتها ومنها الكتابة….
فهل نتوقع من السياسيين في موقع الحكم أو المسؤولية الحزبية… أن يقرؤوا ؟ أغلبهم -في الأصل- ما مارسوا السياسة إلا لكي يكونوا في مراكز الإدارة والحكم وما تجلب من رفاهية بكل المعاني؟! إنهم يمارسون السياسة هوى في النفس قبل أن تكون شعورا بالمسؤولية الأخلاقية والاجتماعية والتاريخية …تجاه شعبهم-أمتهم.
وهذا ما نتلمسه في الخطاب السائد في أدبياتهم، خاصة في بياناتهم وتصريحاتهم ومناقشاتهم بشان توحيد الخطاب السياسي القومي الكوردي والعبور إلى ائتلافات تنسق القوى وتوجهها نحو خدمة القضية المشتركة بآفاق قومية ووطنية تتجاوز الأنانيات الفردية والروح الضيقة حزبيا –تكتليا… لا نريد أن نقع في دائرة حماس البعض -أو ردود الأفعال لدى البعض الآخر… فنتجاهل الأهمية الحزبية كنهج تنظيمي يجمع القوى الكوردية تأسيسا على تجربة مضى عليها زمن –على الرغم من تهالكها إلى درجة مؤلمة… خاصة في حالة الشخصيات التي هيمنت واختزلت الحالة الحزبية في ذاتها بطرق باتت معروفة من أهمها – ربما- استبعاد المعارضين وتربية المصفقين والمتهافتين على موائد رخيصة … من المناصب الخلبية والمتوهمة..
وبعض مصالح ربما تلاشت الآن كالمنح الدراسية وأشياء شبيهة.
ففي النهاية هي- الأحزاب- كيانات قائمة – مهما كان شانها، ولها خبرة في إعاقة العمل النضالي، وزرع الإشكاليات… إذا لم تكن ذات حظ فيه… مثلما هي تتمتع بالخبرة في إدارة مفيدة في حالات الرضا والقبول .
لذا من الخير عدم استبعادها ولكن من الضروري أن تكون مشاركتها وفقا لمعايير وقيم جديدة فيها جذوة العمل الجاد والحيوي والواضح والجريء.
ومثله لا أظن أن اتخاذ مواقف عدائية من الأفكار والتعبيرات المختلفة والمخالفة لمزجتها أو تصوراتها يصب في خانة الإنتاج ايجابيا سواء في مساحة الثقافة وحيوتها أم في مساحة الحرية والديمقراطية وزخم الفعل فيها.
2- التواصل من أهم سمات العمل المنتج منذ بناء التصورات المشتركة ومراحل المرور في تطبيقات تجسدها على أرض الواقع..
واهم وسائل التواصل هو الخطاب…هو لغة التفاهم، واللغة -في النهاية سلوك- أي حصيلة حالة ذهنية وسيكولوجية ، أو يمكن القول حالة ثقافية تمثل حصيلة المعرفة والخبرة المكتسبة “الوعي” والحالة الأخلاقية التي تختزنها الشخصية إضافة لما سبق…ومن عناصرها أيضا، صدق النية والعزيمة والإرادة عموما في الممارسة الحياتية لاسيما فيما يتعلق بالقضايا الكبيرة التي تخص الشعوب -الأمم-.
يقتضي هذا الأمر أن يتدرب الذي يقوم بفعل التواصل –أيا كان وكيف كان…- على توفير أفضل أشكال التجلي التعبيري –شفاها وكتابة… على قاعدة القدرة على ضبط النفس وانفعالاتها، حيال ممارستها لقضايا خلافية بطبيعتها، وتتطلب جهدا أصبح معروفا في طبيعته من خلال تجارب التاريخ البشري كله.
لذا فإن أسلوب الشتيمة والتوصيف السلبي بعبارات شاذة ، والتخوين المباشر بلا حجج ولا أدلة ..
والاعتماد على الانطباعات والاستنتاجات في إطلاق أحكام نهائية، واعتبار الذات مصدر الصواب والغير مصدر الخطأ أو السوء ..الخ.
لم يعد مقبولا في ظل الفرص الكبيرة المتاحة للنشر والقراءة -الاطلاع… وهنا اذكر بنشوء علم الدبلوماسية..
فالغربيون مروا بنفس الظروف التي نمر بها الآن ولكن دور التفكير والمنطق في حياتهم الاجتماعية هداهم إلى نشوء لغة الدبلوماسية..
وذروتها كلمة “سيد ” لجميع الناس المتفقين والمختلفين… والاعتماد على الأسلوب المنطقي في الحوار والنقاش..
وإذا رغب بعضهم في استثمار المواقف لمصالح سياسية ففي إطار المتعارف عليه من اللغة الدبلوماسية الحافظة لحق كل طرف من جهة والمفرزة –او المحفزة- لروح التباري على النجاح عبر قوة اللغة الدبلوماسية الذكية –إذا جاز التعبير- في اقتناص مكاسب في المداولات والحوارات…الخ.
والمثال “أراض ” أو الأراضي ” في إحدى وثائق الأمم المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل أصبحت معروفة.
او ثورة..
او أي مفهوم تجده مناسبا لتوصيف الحالة…عندما تشتد الأحوال فإن سخونتها تلامس النفوس جميعا…وآثارها تنعكس على الجميع في صورة ما…وتصبح الحاجة الى المشاركة –بشكل ما –ضرورة حياتية ومصيرية … هذا لا خلاف عليه -فيما أظن..
أين الخلاف – أو الاختلاف؟ لعله في الموقف والسلوك من هذه الأحداث..! فالتكوين الثقافي – في الشخصية – لدى الناس مختلف، والتكوين الأخلاقي في الشخصية يختلف، وتتحرك النوازع بمحركات مختلفة؛ بعضها شعور بالمسؤولية ،وبعضها اقتناص للظروف لتحقيق مكاسب أنانية، وبعضها استمرار في غيٍّ تاريخي، وبعضها ذات تصورات مشبوهة أو مشوّهة..
وبعضها حالة ارتباك وتخبط…الخ.
هنا يبرز الجوهر الحقيقي لكل مشارك –فردا أم مجموعة ، مهما كانت طبيعتهان إثنية طائفية حزبية…الخ.
وفي تقديري فإن الخير للجميع هو في تغليب التصورات والمفاهيم الايجابية، وبذل الجهود في استكثار أو توسيع مساحة الثقة لكي يكون التشارك منتجا ومحققا لطموحات تاريخية في استقرار الوطن والحياة فيه… وان التمسك بأشياء صغيرة في صيغة مطالب سياسية مستندة على الرغبة او الخوف… أو الطمع….
قد يدفع نحو الغرق للجميع… مكاسب قليلة في لحظة تاريخية يمكن لصيغة الحياة السياسية –الديمقراطية- ان تكثرها وتوسع في مساحتها؛ خير من مكاسب تبدو كثيرة –أو كبيرة ولكنها تتأرجح في عرض البحر ويمكن للسفينة أن تغرق بكل ما فيها-ومن فيها- ومنها هذه المكاسب.
رأي نوجهه لكل المعنيين في الوطن –نظاما أو شعبا معارضة منظمة أو تنسيقيات محتجة في الشارع وطبعا للنظام –المسؤولية الأهم والأكبر في كل تجلياتها.