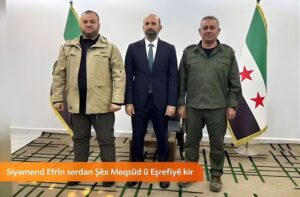وهو في أصله نظام جبان، ولم تتمكن من إيقاف هدير الثورة المستمرة، التي وجدت لنفسها انطلاقة زمانية في كل يوم جمعة، سيظل مكان تقديس لدينا، وكأن الدم السوري أعطى هذا اليوم معنى جديداً و ألقاً خاصاً، فوق ما يحمله من معان ودلالات، ليكون هذا اليوم العظيم بداية “روزنامة” الثورة، من أجل سوريا ديمقراطية، تعددية، تشاركية،علمانية، يتم فيها فصل الدين والإيديولوجيا عن الدولة.
أمام هذه اللوحة،التي لا تتقبل أي احتمال، غير إعلان النظام هزيمته وانتصار الثورة- والنظام في حالة يرثى لها- مادامت كل أساليبه الوحشية لم ترضخ البطل السوري لرفع يديه، مستسلماً، مع أن “شبيحته” المأجورة تمادت في انتهاك كل ما هو محرم، كما يتم في “جسر الشغور”، بحسب، شهادات بعض أبناء المدينة البطلة-وقس على ذلك في المدن، والبلدات، والقرى، الثائرة في كل مكان،فهو يتوسل بعض الدول إلى درجة” تقبيل الأيادي”-كما في حالة تركيا-عندما يجد أن هناك تهديداً فيه “بعض” الجدية-وتركيا إحدى دولتين أخذتا بيد النظام الملوثة بدم الكرد لتحتضنه وتخرجه من العزلة المطبقة، وهو ما تنساه ذاكرة النظام المثقوبة- في الوقت الذي يحرك فيه هذا النظام أوراقه البالية، القديمة، المتجددة،في إثارة الفتن والنعرات، داخل الوطن، وخارجه، مادام أن وسائل إيقاعه” بلا حدود” ، وهو لا يبالي بالضريبة التي يتمّ دفعها، من دماء الناس، ليبقى كرسيه في حرز وديمومة.
والغريب، أن النظام الذي لا يفتأ ينادي بالدعوة إلى الحوار، ليس حرصاً على مستقبل سوريا، ولاعلى دماء السوريين، ولا على التراب السوري، ولا على قواعد الحوار، وتهيئة الأرضية المناسبة له، وليس لوقف نزيف الدم، بل لاستمرارية النّظام، وحده،وليأت من بعده الطوفان…!، فها هو في جمعة” الشيخ صالح العلي” يواصل لغته الوحيدة، لغة القتل، ليستشهد حوالي عشرين شهيداً في دير الزور وحلب ودمشق-حتى الآن- ما خلا الجرحى…، بعد أن امتدت ألسنة لهيب الثورة إلى قلعتين كبريين هما: حلب ودمشق، وسقط في حلب أول شهداء الثورة، لأن القتل كان معبره للوصول إلى هذا الكرسي، منذ أربعة عقود ونيف، مضحياً بأقرب مقربيه، وهو بلغة القتل نفسها يدافع عن كرسيه، وإن كان ثمنه في كل مرة، دماء السوريين الغالية، وقد تواردت الأخبار بأن هناك شهداء في دير الزور، وفي دمشق، بل ولقد صور بعض المدونين الأبطال لقطات لضباط دمويين، يطلق أحدهم الرصاص على مدنيين عزل، يستهدفهم، بل الآلم من كل ذلك وصول أنباء عن مواطنين، صدقا دعوة النظام للنازحين في موسم الهجرة السوري، عن طريق مبعوثه التركماني، وعادا إلى-جسر الشغور- ليتم قتلهما ويكون رصاص النظام في لهما بالمرصاد، ينتظرهما، كما أشرت في مقالي السابق*، إلا أن الرصاص لن يفلح في تعزيز قبضة عصابة متحكّمة، لصوصية -من بين ممثليها الداعي للتو في مؤتمر صحفي للقيام بأعمال الخير والبر وتوزيع الصدقات والهبات على أصحاب هذا المال الحقيقيين المجوعين- والإجهاز على الشعب السوري برمته، وها إن الأمهات السوريات ينجبن حتى في –المخيمات- من سيحملون مشعل “حمزة” و”فرهاد” ليكون هناك في كل يوم ألف مولود جديد، ولقد التقطت العدسات صورة لوزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، وهو يزور مشفى تركياً، فيه مولودان سوريان، جسريان، لتكون هذه المدينة ” جسراً” لانتصار الثورة المؤكد،لا يحتاج من العالم المشغول بمصالحه، ومخططاته، وأهدافه، إلا الكلمة الطيبة، الصادقة، التي لا تصل، حيث نحن أمام تواطؤ دولي، عام- كما يخيل إلي- لا يرتقي إلى مسؤولية إنصاف الدم السوري المراق، منذ أربعة عقود ونيف، وحتى الآن، وإن كانت روسيا، كما يراد تصويرها”رأس حربة” الخيانة مع هذا الدم الطاهر، وتبقى أية عقوبة-لرموز النظام الذي يعلن عبر مفرقعات كاذبة إشرافه على الخلاص من” الأزمة” والثورة يشتد أوارها بأكثر- عبارة عن ” تطييب خاطر”، لأسر نكبت بكرامتها، وأبنائها، ودغدغة للقاتل، وإن أية مفاضلة بين هذا الرمز والآخر في “لعبة القتل”، هي محاولة مفبركة لتلميع صورة طرف، من دون آخر، يجمعهما معاً الإيلاغ في الدم السوري، وهي استعادة للعبة مماثلة، تماماً جرت في ثمانينيات القرن الماضي، وإن العقوبة المناسبة، والرحيمة، لهذا النظام الرجيم، هي في رحيله حالاً، وفق جدول زمني محدد، واضح، لا يخضع للتزوير، وأن يغدو خارج خريطة : السلطة، والقتل، والنهب، والفساد،وهو ما سيشكل عامل أمان في منطقة الشرق الأوسط، برمتها، وإن أية خريطة طريق، لإيقاف الثورة، من دون أن يتم الانتقال السلمي، الحقيقي، للسلطة، إلى أبطال هذه الثورة،كشرط أول، إنما هي خيانة لدماء أبطال الثورة، التي تأتي استمراراً للثورة السورية الأولى التي حررت بلدنا من ربقة الاستعمار،قبل بضعة عقود،وها هو الماضي يتواصل مع الحاضر، من أجل مستقبل سوري لائق بأبنائه بعد كل هذه الضريبة التي لا يزال يدفعها دون إبطاء.
 إبراهيم اليوسف
إبراهيم اليوسف