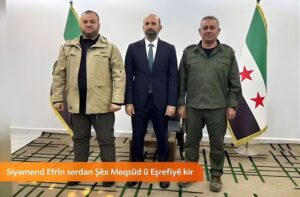هيبت بافي حلبجة
هيبت بافي حلبجةفي مقال سابق ، حول إنتفاضة القامشلي عام 2004 ، ولكي ننفي عنها معرفياُ معطيات مفهوم – الهبة – الذي أعتمده البعض ، وحيثيات مضمون – رد الفعل – الذي أعتمده بعض آخر ، حددنا ، آنئذ ، شروط محتوى الثورة بالآتي ، أولاُ ، أن يشمل فعل الحدث عموم المنطقة الجغرافية ، لإن فحوى الظلم ، هنا ، قسري جوهره اللاأنا هي بالضرورة الأنا ، ثانياُ ، أن يشمل فعل الحدث عموم شرائح المجتمع ، – بأستثناء بنيوية الثورة حسب ماركس ، وثورة سبارتاكوس ، وثورة الزنج في العراق ، وثورة الزنوج في الولايات المتحدة – ، لإن مضمون الظلم ، هنا ، لاأنتقائي ، دالي قمعي ، ثالثاُ ، أن تكون الجماهير اللامنظمة أس وأساس الفعل اللامنضبط في حركة وتفعيل الحدث ، وإلا ، ربما دنونا من مدلولات الإنقلاب أو المؤامرة ، حال الإنقلابات العديدة التي حصلت في سوريا ، وفي مصر عام 1952 ، وفي ليبيا عام 1969 ،
رابعاُ ، أن يتمايز حد الحدث بشيء من العفوية التي هي أهم عنصر في تحديد ماهية الثورة ، خامساُ ، أن يلج مدلول الحدث على الصعيدين ، الفعلي والنظري ، منطقة التابو ( المحظور ) .
إن هذه الشروط ، التي هي ، تحديداُ مقومات صيرورة الحدث كما هي ، لاتبطل ولا تنفي ولاتحدد ، أسباب الثورة ، ولا أهدافها ، ولا نتائجها ، التي هي مستقلة في تفسيرها عن شروط فعل الحدث ، وهذا التداخل مابين هذه الجهات الأربعة ، هو الذي أشكل في ذهن بعض علماء الأجتماع ، أمثال جيروم ديفيس ، كارل مانهايم .
فالأول ، عالم أجتماع أمريكي ( 1891- 1979 ) لخص القضية في أربعة أمور رئيسة .
الأول ، لابد من وجود حراك عيني مادي لدى شريحة عظمى من الأفراد ، أساسه عدم الرضى .
الثاني ، أن يقفز هذا الحراك إلى مستوى التحريض الرفضي ، الداعي إلى التكتل الأولي .
الثالث ، ولامحيص من أن يتجسد ذلك في شعور أجتماعي معين الذي ، سوف يقتضي لاحقاً الضبط والتنظيم وهذا هو جوهر الأمر ( الرابع ) .
هذه الحيثيات ، رغم إننا لانتفق معها ، قد تؤلف في أفضل الأحوال مقدمات للثورة أو أسبابها ، لكنها لاتعني على الإطلاق ، إنها سوف تؤدي إلى الثورة أم لا ، وهي لاتفسر في الأطلاق فعل حدوث الثورة ، ولاصيرورة هذا الحدث ، ثم أن هذه الرؤيا تترك هامشاُ للضبابية ما بين ( الثورة ، المؤامرة ، الأنقلاب ، الإنتفاضة ) .
أما الثاني ، كارل مانهايم ( 1893- 1947 ) الذي بعد أن حدد في مؤلفه – الإيديولوجيا واليوتوبيا – إن الإيديولوجيا هي نسق فكري منظم يعبر عن مصلحة ما ويحدد السلوكين الإجتماعي والسياسي المرادفين ، أضطر إلى القول إن الثورة تصرف عمدي وفعل قصدي ، يلعب اللاشعور دوره في بعض عوامله .
ياترى ألا يلعب ( العمد والقصد ، واللاشعور ) الدور المطلوب في معطيات – المؤامرة ، الأنقلاب ، الإنتفاضة – !.
ثم ياترى هل كل فعل ثوري هو بالضرورة مؤدلج !.
ثم يا ترى هل لعب اللاشعور دوره – في بعض عوامله – في الثورة الأمريكية ( 1775 – 1783 ) ، والثورة الجزائرية ( 1954 – 1962 ) ، والثورة الأوكرانية البرتقالية ( 2004 ) ، وحتى في الثورة الفرنسية ( 1789 ) ، والثورة الروسية ( 1917 ) وغيرها ! .
ولكن ، ألسنا هنا إزاء متعصية عظمى ، إذ كبف نمايز مابين ، مقدمات وأسباب وعوامل الثورة من جهة ، ومقومات فعل الحدث ( كما حددناها سابقاُ ) من جهة أخرى ، وأهدافها من جهة ثالثة ، ونتائجها من جهة رابعة ، أم إن في المسألة إشكالية معرفية لامحيض من إدراك شروطها الخاصة بها ، يقول عبد الكريم غلاب – بعد أن عكس المقدمات الأولية لدى ألبير كامو بصورة خاطئة – لكي لاتكون الثورة هادمة ، ينبغي أن تمتلك البديل الحضاري الجديد للحضاري القديم الذي عليه تثور ، إن هذا القول ليس له أي قيمة معرفية فيما يخص مفهوم الثورة ، وسيتجلى ذلك في طرحنا لمفهوم الثورة لدى كل من ماركس ، وتوماس كوهن .
أولاُ ، لدى ماركس ، قد لانتفق كلياُ مع مفهوم ماركس حول الثورة ، لكن نؤكد على الجانب الذي نكترث له في هذا المقال ، ونلخص ، بما إن البنى التحتية تحدد ، حسب ميكانيزم خاص بها ، مقومات البنى الفوقية ، فإن القوى المنتجة تحدد ، هي الأخرى وبدرجة أقوى ، علاقات الأنتاج المؤتلفة منها وبها .
وهي ، أي قوى الإنتاج ، لا تتطور حسب التقدم العلمي فقط ، إنما تتغاير كلياُ من حيث الطبيعة ومن حيث النوع ، وبالتالي تفرض على المجتمع والفكر والسياسة والسلوك ، بقوة الأمر الواقع ، حيثيات جديدة في المحتوى الموضوعي لعلاقات الأنتاج التي لامحيص إلا الإستجابة لدالتها ، وهذا ما يؤلف حالة من التعارض التناقضي مابين ( القوى المنتجة وعلاقات الأنتاج ) القديمة و ( القوى المنتجة وعلاقات الأنتاج ) الجديدة ، وهذا ما يختزله المفكرون تعسفاُ بالتناقض ما بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وهذه هي ، ما أسميها ، بالنقطة البنيوية لدى ماركس ، إذ لابد من تحطيم علاقات الإنتاج كلياُ ونهائياُ .
ثانياً ، لدى توماس صاموئيل كوهين ، الذي أبدع ، في تجسيد هذه النقطة اكثر من ماركس ، لكن على مستوى الثورات العلمية ، ففي مؤلفه ( بنية الثورات العلمية – 1962 ) يؤكد إن المحور المطلق لكل ثورة علمية هو ما يسميه بالأنموذج – الباراديغم – أي النمط الفكري الذي يفسر جوهر الفرضيات والقوانين العلمية السائدة ولايسمح ، بولوج نمط فكري جديد ، إلا إذا تحطم ، فلكل مرحلة تاريخية علمية نمط فكري – باراديغم – لايوائمه فقط إنما يحدد بالكلي والشمولي سلوكية وذهنية ومستوى الرؤيا العلمية ، لكن هذه الأخيرة – مثل قوى الأنتاج – في ديمومة واعية ( تؤدي دوراُ في ظهور أنواع جديدة من الظواهر ، فلا يندهش أحد للقول بأن وعياُ مماثلاُ وأعمق هو شرط ضروري لكل التغيرات النظرية – ص 144 ) ، وكأن التنازع والتناحر يترآى في إن ( مناصري البراديغمات المتنافسة يزاولون مهنتهم في عوالم مختلفة – ص 256 ) والمسألة لاتظهر إلا إذا تراكمت معضلات حقيقية ( ظواهر علمية ) أمام البراديغم السائد الذي لايبدي فقط عدم قدرته على تفسيرها ، إنما أيضاُ عجزه المطلق البنيوي في إدراكها ، عندها ، وبالضرورة ، نحن إزاء مستويين ، الأول هو ( إن الواقع والنظرية في مجال العلوم ، وكذلك الإكتشاف والإبداع ، ليست متمايزة بصورة دائمة وقطعية ، إنما هما متداخلان بشكل عضوي – ص 145 ) ، والثاني هو إن نمطاُ فكرياُ – باراديغماُ – جديداُ سوف يتمظهر ، لتجاوز مفهوم الأزمة لدى النمط القديم بتحطيمه بنيوياً ، وهذا مايسميه كوهن تحول الباراديغم ومفهوم الدورة في الثورات العلمية ، وهي تمثل النقطة البنيوية لديه ، ونقتنص أمثلة توضيحية ، التحول من فيزياء نيوتون إلى نسبية آينشتاين ، التحول من رؤية بطليموس إلى رؤية كوبرنيكوس .
وهذه النقطة البنيوية – على صعيد السوسيولوجيا العربية الحالية – تبرز الإشكالية من منطلق إن المستقبل العربي يرفض بنيوياُ حاضره ، لإن هذا الأخير عاجز بنفس الدرجة من القفز من مستوى زمني منتهي إلى مستوى زمني جديد ، وهذا العجز يستبان في الأمور التالية .
الأمر الأول : إن العقل العربي في محنة مستعصية الحل لاسيما بعد أن أقر فقدانه أهليته في قيادة ذاته والدولة والمجتمع ، فلقد أستقال من منصبه أو على الأرجح أقيل لعدم كفاءته .
الأمر الثاني : نعتقد إن الفكر العربي نفسه ضجر وسأم من أجترار حالة مستهلكة إلى درجة الأشمئزاز ، حيث التشابك والتداخل ما بين المقدمات والأسباب والعوامل والنتائج والظواهر .
الأمر الثالث : نعتقد إن السوسيولوجيا العربية كرهت مدلولاتها وغدت مستلبة الإرادة في عقرها ، فتمردت على ذاتها ، والعقل ، والفكر ، وأحدث قطيعة في الزمن ، فلكي تعبر هي ونعبر نحن إلى المستقبل لامناص من نقطة بنيوية في السوسيولوجيا الحديثة ….
إن هذه الشروط ، التي هي ، تحديداُ مقومات صيرورة الحدث كما هي ، لاتبطل ولا تنفي ولاتحدد ، أسباب الثورة ، ولا أهدافها ، ولا نتائجها ، التي هي مستقلة في تفسيرها عن شروط فعل الحدث ، وهذا التداخل مابين هذه الجهات الأربعة ، هو الذي أشكل في ذهن بعض علماء الأجتماع ، أمثال جيروم ديفيس ، كارل مانهايم .
فالأول ، عالم أجتماع أمريكي ( 1891- 1979 ) لخص القضية في أربعة أمور رئيسة .
الأول ، لابد من وجود حراك عيني مادي لدى شريحة عظمى من الأفراد ، أساسه عدم الرضى .
الثاني ، أن يقفز هذا الحراك إلى مستوى التحريض الرفضي ، الداعي إلى التكتل الأولي .
الثالث ، ولامحيص من أن يتجسد ذلك في شعور أجتماعي معين الذي ، سوف يقتضي لاحقاً الضبط والتنظيم وهذا هو جوهر الأمر ( الرابع ) .
هذه الحيثيات ، رغم إننا لانتفق معها ، قد تؤلف في أفضل الأحوال مقدمات للثورة أو أسبابها ، لكنها لاتعني على الإطلاق ، إنها سوف تؤدي إلى الثورة أم لا ، وهي لاتفسر في الأطلاق فعل حدوث الثورة ، ولاصيرورة هذا الحدث ، ثم أن هذه الرؤيا تترك هامشاُ للضبابية ما بين ( الثورة ، المؤامرة ، الأنقلاب ، الإنتفاضة ) .
أما الثاني ، كارل مانهايم ( 1893- 1947 ) الذي بعد أن حدد في مؤلفه – الإيديولوجيا واليوتوبيا – إن الإيديولوجيا هي نسق فكري منظم يعبر عن مصلحة ما ويحدد السلوكين الإجتماعي والسياسي المرادفين ، أضطر إلى القول إن الثورة تصرف عمدي وفعل قصدي ، يلعب اللاشعور دوره في بعض عوامله .
ياترى ألا يلعب ( العمد والقصد ، واللاشعور ) الدور المطلوب في معطيات – المؤامرة ، الأنقلاب ، الإنتفاضة – !.
ثم ياترى هل كل فعل ثوري هو بالضرورة مؤدلج !.
ثم يا ترى هل لعب اللاشعور دوره – في بعض عوامله – في الثورة الأمريكية ( 1775 – 1783 ) ، والثورة الجزائرية ( 1954 – 1962 ) ، والثورة الأوكرانية البرتقالية ( 2004 ) ، وحتى في الثورة الفرنسية ( 1789 ) ، والثورة الروسية ( 1917 ) وغيرها ! .
ولكن ، ألسنا هنا إزاء متعصية عظمى ، إذ كبف نمايز مابين ، مقدمات وأسباب وعوامل الثورة من جهة ، ومقومات فعل الحدث ( كما حددناها سابقاُ ) من جهة أخرى ، وأهدافها من جهة ثالثة ، ونتائجها من جهة رابعة ، أم إن في المسألة إشكالية معرفية لامحيض من إدراك شروطها الخاصة بها ، يقول عبد الكريم غلاب – بعد أن عكس المقدمات الأولية لدى ألبير كامو بصورة خاطئة – لكي لاتكون الثورة هادمة ، ينبغي أن تمتلك البديل الحضاري الجديد للحضاري القديم الذي عليه تثور ، إن هذا القول ليس له أي قيمة معرفية فيما يخص مفهوم الثورة ، وسيتجلى ذلك في طرحنا لمفهوم الثورة لدى كل من ماركس ، وتوماس كوهن .
أولاُ ، لدى ماركس ، قد لانتفق كلياُ مع مفهوم ماركس حول الثورة ، لكن نؤكد على الجانب الذي نكترث له في هذا المقال ، ونلخص ، بما إن البنى التحتية تحدد ، حسب ميكانيزم خاص بها ، مقومات البنى الفوقية ، فإن القوى المنتجة تحدد ، هي الأخرى وبدرجة أقوى ، علاقات الأنتاج المؤتلفة منها وبها .
وهي ، أي قوى الإنتاج ، لا تتطور حسب التقدم العلمي فقط ، إنما تتغاير كلياُ من حيث الطبيعة ومن حيث النوع ، وبالتالي تفرض على المجتمع والفكر والسياسة والسلوك ، بقوة الأمر الواقع ، حيثيات جديدة في المحتوى الموضوعي لعلاقات الأنتاج التي لامحيص إلا الإستجابة لدالتها ، وهذا ما يؤلف حالة من التعارض التناقضي مابين ( القوى المنتجة وعلاقات الأنتاج ) القديمة و ( القوى المنتجة وعلاقات الأنتاج ) الجديدة ، وهذا ما يختزله المفكرون تعسفاُ بالتناقض ما بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج ، وهذه هي ، ما أسميها ، بالنقطة البنيوية لدى ماركس ، إذ لابد من تحطيم علاقات الإنتاج كلياُ ونهائياُ .
ثانياً ، لدى توماس صاموئيل كوهين ، الذي أبدع ، في تجسيد هذه النقطة اكثر من ماركس ، لكن على مستوى الثورات العلمية ، ففي مؤلفه ( بنية الثورات العلمية – 1962 ) يؤكد إن المحور المطلق لكل ثورة علمية هو ما يسميه بالأنموذج – الباراديغم – أي النمط الفكري الذي يفسر جوهر الفرضيات والقوانين العلمية السائدة ولايسمح ، بولوج نمط فكري جديد ، إلا إذا تحطم ، فلكل مرحلة تاريخية علمية نمط فكري – باراديغم – لايوائمه فقط إنما يحدد بالكلي والشمولي سلوكية وذهنية ومستوى الرؤيا العلمية ، لكن هذه الأخيرة – مثل قوى الأنتاج – في ديمومة واعية ( تؤدي دوراُ في ظهور أنواع جديدة من الظواهر ، فلا يندهش أحد للقول بأن وعياُ مماثلاُ وأعمق هو شرط ضروري لكل التغيرات النظرية – ص 144 ) ، وكأن التنازع والتناحر يترآى في إن ( مناصري البراديغمات المتنافسة يزاولون مهنتهم في عوالم مختلفة – ص 256 ) والمسألة لاتظهر إلا إذا تراكمت معضلات حقيقية ( ظواهر علمية ) أمام البراديغم السائد الذي لايبدي فقط عدم قدرته على تفسيرها ، إنما أيضاُ عجزه المطلق البنيوي في إدراكها ، عندها ، وبالضرورة ، نحن إزاء مستويين ، الأول هو ( إن الواقع والنظرية في مجال العلوم ، وكذلك الإكتشاف والإبداع ، ليست متمايزة بصورة دائمة وقطعية ، إنما هما متداخلان بشكل عضوي – ص 145 ) ، والثاني هو إن نمطاُ فكرياُ – باراديغماُ – جديداُ سوف يتمظهر ، لتجاوز مفهوم الأزمة لدى النمط القديم بتحطيمه بنيوياً ، وهذا مايسميه كوهن تحول الباراديغم ومفهوم الدورة في الثورات العلمية ، وهي تمثل النقطة البنيوية لديه ، ونقتنص أمثلة توضيحية ، التحول من فيزياء نيوتون إلى نسبية آينشتاين ، التحول من رؤية بطليموس إلى رؤية كوبرنيكوس .
وهذه النقطة البنيوية – على صعيد السوسيولوجيا العربية الحالية – تبرز الإشكالية من منطلق إن المستقبل العربي يرفض بنيوياُ حاضره ، لإن هذا الأخير عاجز بنفس الدرجة من القفز من مستوى زمني منتهي إلى مستوى زمني جديد ، وهذا العجز يستبان في الأمور التالية .
الأمر الأول : إن العقل العربي في محنة مستعصية الحل لاسيما بعد أن أقر فقدانه أهليته في قيادة ذاته والدولة والمجتمع ، فلقد أستقال من منصبه أو على الأرجح أقيل لعدم كفاءته .
الأمر الثاني : نعتقد إن الفكر العربي نفسه ضجر وسأم من أجترار حالة مستهلكة إلى درجة الأشمئزاز ، حيث التشابك والتداخل ما بين المقدمات والأسباب والعوامل والنتائج والظواهر .
الأمر الثالث : نعتقد إن السوسيولوجيا العربية كرهت مدلولاتها وغدت مستلبة الإرادة في عقرها ، فتمردت على ذاتها ، والعقل ، والفكر ، وأحدث قطيعة في الزمن ، فلكي تعبر هي ونعبر نحن إلى المستقبل لامناص من نقطة بنيوية في السوسيولوجيا الحديثة ….
heybat@maktoob.com