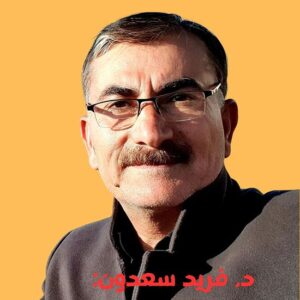دهام حسن
دهام حسننقصد بالإنسان العربي هنا ، ذلك الإنسان الذي يصنف ضمن الجماهير العفوية الأكثر غبنا، الإنسان المقهور ، الإنسان المتخلف كيفما تناولته بالدراسة…الفلاح أمام سيده المالك ، العامل أمام رب عمله، ذل وخنوع ورضوخ…واحتواء من داخله ، الشعور بالدونية ..
كيف نسم إنساننا بالتخلف ؟ ما هي الإشارات الدلالية لهذه السمة أو الدمغة ، يكاد يجمع الباحثون في دائرة الأبحاث حول سمات التخلف… أولا الفقر..
مستوى التعليم..
متوسط دخل الفرد..
ومن المعلوم أن نصيب الفرد من الدخل مضلل في الإشارة إلى متوسط دخله ، جراء عدم التساوي المطلق في التوزيع ، لكن بالمحصلة فإن المؤشرات الثلاثة (الفقر – التعليم – دخل الفرد) وما ينجم أو يتفرع عنها من سوء التغذية..
المرض..
متوسط العمر..
ومما يزيد الواقع سوءا ويأسا وقهرا هو عدم وجود سياسة جادة لتشخيص الحالة ، ومن ثم اتباع سياسة اقتصادية تنموية تمني هذه الجماهير بالفرج والتفاؤل ولو بعد حين..
حيث السكون في الاقتصاد ، والبدائية في التصنيع ، والقصور في كيفية استغلال الثروات ، والكثير من الباحثين يحمّلون مثل هذا البؤس إلى سياسات النظم الشمولية السائدة ، وإلى سياسات الاستيراد والتصدير… تصدير المواد الأولية الخام ، واستيراد المواد المصنعة للاستهلاك.
ولا يفوتنا القول أن هذه الحالة السياسية الاقتصادية التي دلت على بنى التخلف في الواقع العربي ، أنها تؤطر وترسم سيكولوجية الإنسان العربي ، وقيمه الروحية ، بما يتسم من استلاب لإنسانيته ، ودفع للرضوخ والتبعية لعالم السيادة والقهر التسلطي, وهذه الحالة كثيرا ما تؤذن بتفشي ظاهرة العنف ، تسيطر على وعي وعقول الفرد المستلب من كثير من قيمه…
القهر علامة مميزة دامغة في شخصية الإنسان العربي ، وطبع به سلوكه منذ الفطام، فهو مذ كان طفلا فوجئ بأن أبويه يخافان من العسكر ، فيتحسس غريزيا فطريا أن مهمة العسكر هي القمع والإخافة وليست للأمن والطمأنة، وأيضا في الأسرة وفي الشارع وفي المدرسة، يتلقف الأدبيات الغيبية ، والأمثال الشعبية ، والسحر والخرافة والأساطير ، كل هذا يتغلغل في نسيج ذهنيته الفتية ، ويتعشش في لا وعيه ، وكل هذا يتراءى له عندما يشبّ،ويتحكم قليلا أو كثيرا في سلوكه وبعض من تصرفاته، سواء كان هذا التحكم عن عادة أو قناعة، ويسد عليه بالتالي باب المبادرات، عليه أن يتربى على حب هذا وكراهية ذاك، وهذا التوجيه بما يشبه الإلزام وبال على عقله الطفولي ..
هذا القهر الإنساني من قبل السيد المتسلط ، يدعه كالا عاجزا من التحكم أو من السيطرة على مصيره تاركا إياه ذاعنا لقانون الاعتباط والتبعية كقانون ملزم مكتو، ومن هنا تأتي مرحلة الاحتواء، إفراغ الإنسان من داخله من محتواه كإنسان له كينونته الخاصة ، فيتجلى بمظهر جديد فيه الكثير من الدونية ، ويتولد لديه سلوك من الأمعية، يدفعه نحو التزلف من الآخر والاستزلام له، وتغيب عن باله علاقات المساواة الإنسانية ، والاعتراف أو الاحترام المتبادل مع أخيه الإنسان..
بالمقابل فإن الإنسان المسيطر المتسلط لا يرى أي جناح أو رادع في تماديه ، أي عدوان وأي انتهاك مباح له ومبرر..
يستغل ، يقمع ، يقسو،لا حقوق لهؤلاء المستضعفين ، لهذه الكائنات الضعيفة ، لهؤلاء الغوغاء ، عندما أطيح بصدام حسين، ونظامه المستبد، سئلت إحدى المقربات بصلة الرحم منه ،عن ارتكابا ته في قمع انتفاضة عام 1991 فاستهانت بهؤلاء بقولها (أولئك الغوغاء.!) هكذا تصنف الجماهير العفوية التي عانت القهر والغبن والقمع بالغوغاء ..كل هذا ينبت لدى الإنسان المقهور روح الاستكانة ، سكون وهدوء مطبق،لا يتخللها سوى تمردات فردية لا تسفر عن أي تغيير ، أي أن لا ثمرة للمجابهة ، فلا مفر من القبول بالواقع القائم ، عجز أمام قوة السلطة وافتقار إلى الإحساس الذي يمدا لإنسان بالإيمان بالطاقات الخلاقة للجماهير المقهورة ، وامتلاك عنفوان المواجهة..
هذه الحالة من القهر ، لا تحول دون أن يراود تفكير الإنسان المقهور عن إمكانية الوصول إلى الحق بلغة أخرى هي لغة العنف،عندما تسدّ أمامه كل السبل، وكلما اشتدت حالة اليأس ، وتلاشت أو استنفدت الحلول السلمية في تغييرات ضرورية ، اتجهت الأنظار نحو خيار العنف ، ثم أن افتقار هؤلاء إلى الثقافة السياسية ، ربما دفعهم هذا النقص المتجذر باللجوء إلى العنف ، وبشكل اعتباطي عشوائي ،لا سيما إذا استغلوا من قبل مرجعية ما، التي تشيؤهم وفق مخططاتها، وهؤلاء المساكين يركعون أمام إرادة هؤلاء كما ركعوا من قبل أمام السيد المتسلط، ولا ننسى أن هؤلاء تتحدد نظرتهم بمحيطهم الضيق المحدد والمحدود دون آفاق، لا يتجاوزونها مكانيا ، لا نظرة شمولية لا آفاق بعيدة، القصور التام عن التفكير الجدلي ،ذلك التفكير الذي يمد الإنسان بقبوله بحركية دائمة تفضي بالنهاية إلى تغيير أكيد..ويبقى الإنسان المقهور ، في أحد مسارين ..إما التقرب من السلطة والتنكر لجماعته حيث ينتمي ، وإما الابتعاد عن السلطة ومجابهتها، والذوبان في الجماعة التي يحسب عليها للتفكير والتخطيط لحلول أخرى..
وإذا ما تجاوزنا الجماهير العفوية مدار حديثنا سنجد أن مشهد الانكسار والشعور بالدونية يطبع فئات أخرى ، منها الفئة التي تتمتع بالهيمنة والسيطرة ، وتشغل حيزا ملحوظا في مفاصل الدولة، ويحظى بقدر واسع من الامتيازات، كيف يحافظ على ما حققه من إنجازات، وما حصل عليه من امتيازات ؟ قلق دائم يستبد به، لا يستأمن المستقبل ، وما تخبئه له الأيام المقبلة من خفايا، لهذا فهو دائم التوجس، هل ستطوله المحاسبة يوما ما ؟ لأنه تعود أن يعتاش في مراتع الفساد، كما يحس بالانكسار والدونية أمام المجتمعات الغربية، حيث الاستقرار الاجتماعي والسياسي،والأمان في الحاضر والمستقبل والانتخابات الديمقراطية الحرة في اختيار الحاكمين، – والرجل المناسب في المكان المناسب – ربما نفس المشاعر راودت فئات أخرى ، ربطت مصيرها بمصير السلطة بعد أن فقدت قواعدها، وخسرت جماهيريتها، فمن المعلوم أن الذي لا يمتلك جماهير شعبية، أو قواعد مؤازرة يفقد بالتالي هيبته، ومن لا هيبة له، لن يسمع صوته، ولن تحترم كلمته، وبالتالي يكون خياره التماشي مع السائد المسيطر وبروح انتهازية من التزلف بعد أن أخفق في تحقيق مشروعه النضالي تمثلا لقول الشاعر المعري، فبعد أن عانده الدهر في تحقيق مراده ، ما كان منه إلا أن اختار السهل بقوله: (جريت مع الزمان كما أرادا)
هذه الفئة أيضا تشعر بالانكسار والدونية أمام الأعلى المسيطر ، وبينها وبين نفسها، والتواري الخجول أمام من عقد عليها الآمال، بتبريرات ومسوغات لا تنطلي على المتابع الفطن ، بعد أن فقدت كل رصيد اجتماعي..
ولا بأس هنا أن نقتبس حكاية طريفة من التاريخ ذات مغزى ومعنى… عندما أراد سعد زغلول مقابلة المندوب السامي البريطاني في مصر، وفي مكتب سكرتير المندوب السامي ، طلب منه السكرتير أن ينحني أمام الممثل البريطاني احتراما لحكومته ولما يشغله هذا الممثل من منصب سام ، فأومأ إليه سعد بالموافقة..ولما خرج سعد عاتبه السكرتير لأنه لم ينحن أمام ممثل المملكة البريطانية ، فرد عليه سعد يقوله : لقد وددت الانحناء لكني وجدت سبعة عشر مليونا مصريا (عدد سكان مصر آنذاك) يشدونني إلى الخلف فلم أستطع الانحناء، نعم القوي بشعبه لن ينحني أمام العدو، كما أن القوي بجماهيره لن ينحني أمام السلطة…
إذا كانت هذه هي ملامح الإنسان العربي المقهور ، في ظل التخلف والنظم الاستبدادية، فهل هذه الملامح هي قدر الإنسان العربي، وهل هي سرمدية، ترى..
ما الآفاق ؟ بل ما العمل ؟..
لاشك أن الحركة والتحول ملازمان لكل شيء ، وإن تطور المجتمع عملية طبيعية تاريخية، فلا يمكن أن ننزل إلى ماء النهر الواحد مرتين بتعبير أحد الفلاسفة، لأن مياها جديدة ستتدفق، فالقهر والتخلف ليسا قدر الشعوب، ففي سوريا مثلا شهدنا وعشنا في أجواء من الديمقراطية في الفترة التي تلت الاستقلال في عام1946 حتى عام 1949 ومن عام 1954 بعد سقوط الشيشكلي إلى قيام الوحدة المصرية السورية في عام 1958بالرغم أن الجهل كان أعم والتخلف كان أوسع مدى….
واليوم في ظل التغييرات التي تعصف بالعالم، وفي ظل المستحدثات العلمية، والثورة المعلوماتية، وانتشار القنوات الفضائية، وارتفاع مستوى التعليم نسبيا ، ما عاد أحد غافيا دون أن يتحسس ما يدور في هذا العالم، وصار بمقدور أي فرد أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما عاد بين المضطهدين (غوغاء) كما قالته بتعال قريبة صدام، كل إنسان مدرك اليوم ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولن يفرط في حقوقه، سوف يقف عندها رافضا للضيم الذي طال به الأمد، وسيخلع النير هاتفا ، أريد حقوقي، أطلق يديّ، أريد حريتي…..
المرض..
متوسط العمر..
ومما يزيد الواقع سوءا ويأسا وقهرا هو عدم وجود سياسة جادة لتشخيص الحالة ، ومن ثم اتباع سياسة اقتصادية تنموية تمني هذه الجماهير بالفرج والتفاؤل ولو بعد حين..
حيث السكون في الاقتصاد ، والبدائية في التصنيع ، والقصور في كيفية استغلال الثروات ، والكثير من الباحثين يحمّلون مثل هذا البؤس إلى سياسات النظم الشمولية السائدة ، وإلى سياسات الاستيراد والتصدير… تصدير المواد الأولية الخام ، واستيراد المواد المصنعة للاستهلاك.
ولا يفوتنا القول أن هذه الحالة السياسية الاقتصادية التي دلت على بنى التخلف في الواقع العربي ، أنها تؤطر وترسم سيكولوجية الإنسان العربي ، وقيمه الروحية ، بما يتسم من استلاب لإنسانيته ، ودفع للرضوخ والتبعية لعالم السيادة والقهر التسلطي, وهذه الحالة كثيرا ما تؤذن بتفشي ظاهرة العنف ، تسيطر على وعي وعقول الفرد المستلب من كثير من قيمه…
القهر علامة مميزة دامغة في شخصية الإنسان العربي ، وطبع به سلوكه منذ الفطام، فهو مذ كان طفلا فوجئ بأن أبويه يخافان من العسكر ، فيتحسس غريزيا فطريا أن مهمة العسكر هي القمع والإخافة وليست للأمن والطمأنة، وأيضا في الأسرة وفي الشارع وفي المدرسة، يتلقف الأدبيات الغيبية ، والأمثال الشعبية ، والسحر والخرافة والأساطير ، كل هذا يتغلغل في نسيج ذهنيته الفتية ، ويتعشش في لا وعيه ، وكل هذا يتراءى له عندما يشبّ،ويتحكم قليلا أو كثيرا في سلوكه وبعض من تصرفاته، سواء كان هذا التحكم عن عادة أو قناعة، ويسد عليه بالتالي باب المبادرات، عليه أن يتربى على حب هذا وكراهية ذاك، وهذا التوجيه بما يشبه الإلزام وبال على عقله الطفولي ..
هذا القهر الإنساني من قبل السيد المتسلط ، يدعه كالا عاجزا من التحكم أو من السيطرة على مصيره تاركا إياه ذاعنا لقانون الاعتباط والتبعية كقانون ملزم مكتو، ومن هنا تأتي مرحلة الاحتواء، إفراغ الإنسان من داخله من محتواه كإنسان له كينونته الخاصة ، فيتجلى بمظهر جديد فيه الكثير من الدونية ، ويتولد لديه سلوك من الأمعية، يدفعه نحو التزلف من الآخر والاستزلام له، وتغيب عن باله علاقات المساواة الإنسانية ، والاعتراف أو الاحترام المتبادل مع أخيه الإنسان..
بالمقابل فإن الإنسان المسيطر المتسلط لا يرى أي جناح أو رادع في تماديه ، أي عدوان وأي انتهاك مباح له ومبرر..
يستغل ، يقمع ، يقسو،لا حقوق لهؤلاء المستضعفين ، لهذه الكائنات الضعيفة ، لهؤلاء الغوغاء ، عندما أطيح بصدام حسين، ونظامه المستبد، سئلت إحدى المقربات بصلة الرحم منه ،عن ارتكابا ته في قمع انتفاضة عام 1991 فاستهانت بهؤلاء بقولها (أولئك الغوغاء.!) هكذا تصنف الجماهير العفوية التي عانت القهر والغبن والقمع بالغوغاء ..كل هذا ينبت لدى الإنسان المقهور روح الاستكانة ، سكون وهدوء مطبق،لا يتخللها سوى تمردات فردية لا تسفر عن أي تغيير ، أي أن لا ثمرة للمجابهة ، فلا مفر من القبول بالواقع القائم ، عجز أمام قوة السلطة وافتقار إلى الإحساس الذي يمدا لإنسان بالإيمان بالطاقات الخلاقة للجماهير المقهورة ، وامتلاك عنفوان المواجهة..
هذه الحالة من القهر ، لا تحول دون أن يراود تفكير الإنسان المقهور عن إمكانية الوصول إلى الحق بلغة أخرى هي لغة العنف،عندما تسدّ أمامه كل السبل، وكلما اشتدت حالة اليأس ، وتلاشت أو استنفدت الحلول السلمية في تغييرات ضرورية ، اتجهت الأنظار نحو خيار العنف ، ثم أن افتقار هؤلاء إلى الثقافة السياسية ، ربما دفعهم هذا النقص المتجذر باللجوء إلى العنف ، وبشكل اعتباطي عشوائي ،لا سيما إذا استغلوا من قبل مرجعية ما، التي تشيؤهم وفق مخططاتها، وهؤلاء المساكين يركعون أمام إرادة هؤلاء كما ركعوا من قبل أمام السيد المتسلط، ولا ننسى أن هؤلاء تتحدد نظرتهم بمحيطهم الضيق المحدد والمحدود دون آفاق، لا يتجاوزونها مكانيا ، لا نظرة شمولية لا آفاق بعيدة، القصور التام عن التفكير الجدلي ،ذلك التفكير الذي يمد الإنسان بقبوله بحركية دائمة تفضي بالنهاية إلى تغيير أكيد..ويبقى الإنسان المقهور ، في أحد مسارين ..إما التقرب من السلطة والتنكر لجماعته حيث ينتمي ، وإما الابتعاد عن السلطة ومجابهتها، والذوبان في الجماعة التي يحسب عليها للتفكير والتخطيط لحلول أخرى..
وإذا ما تجاوزنا الجماهير العفوية مدار حديثنا سنجد أن مشهد الانكسار والشعور بالدونية يطبع فئات أخرى ، منها الفئة التي تتمتع بالهيمنة والسيطرة ، وتشغل حيزا ملحوظا في مفاصل الدولة، ويحظى بقدر واسع من الامتيازات، كيف يحافظ على ما حققه من إنجازات، وما حصل عليه من امتيازات ؟ قلق دائم يستبد به، لا يستأمن المستقبل ، وما تخبئه له الأيام المقبلة من خفايا، لهذا فهو دائم التوجس، هل ستطوله المحاسبة يوما ما ؟ لأنه تعود أن يعتاش في مراتع الفساد، كما يحس بالانكسار والدونية أمام المجتمعات الغربية، حيث الاستقرار الاجتماعي والسياسي،والأمان في الحاضر والمستقبل والانتخابات الديمقراطية الحرة في اختيار الحاكمين، – والرجل المناسب في المكان المناسب – ربما نفس المشاعر راودت فئات أخرى ، ربطت مصيرها بمصير السلطة بعد أن فقدت قواعدها، وخسرت جماهيريتها، فمن المعلوم أن الذي لا يمتلك جماهير شعبية، أو قواعد مؤازرة يفقد بالتالي هيبته، ومن لا هيبة له، لن يسمع صوته، ولن تحترم كلمته، وبالتالي يكون خياره التماشي مع السائد المسيطر وبروح انتهازية من التزلف بعد أن أخفق في تحقيق مشروعه النضالي تمثلا لقول الشاعر المعري، فبعد أن عانده الدهر في تحقيق مراده ، ما كان منه إلا أن اختار السهل بقوله: (جريت مع الزمان كما أرادا)
هذه الفئة أيضا تشعر بالانكسار والدونية أمام الأعلى المسيطر ، وبينها وبين نفسها، والتواري الخجول أمام من عقد عليها الآمال، بتبريرات ومسوغات لا تنطلي على المتابع الفطن ، بعد أن فقدت كل رصيد اجتماعي..
ولا بأس هنا أن نقتبس حكاية طريفة من التاريخ ذات مغزى ومعنى… عندما أراد سعد زغلول مقابلة المندوب السامي البريطاني في مصر، وفي مكتب سكرتير المندوب السامي ، طلب منه السكرتير أن ينحني أمام الممثل البريطاني احتراما لحكومته ولما يشغله هذا الممثل من منصب سام ، فأومأ إليه سعد بالموافقة..ولما خرج سعد عاتبه السكرتير لأنه لم ينحن أمام ممثل المملكة البريطانية ، فرد عليه سعد يقوله : لقد وددت الانحناء لكني وجدت سبعة عشر مليونا مصريا (عدد سكان مصر آنذاك) يشدونني إلى الخلف فلم أستطع الانحناء، نعم القوي بشعبه لن ينحني أمام العدو، كما أن القوي بجماهيره لن ينحني أمام السلطة…
إذا كانت هذه هي ملامح الإنسان العربي المقهور ، في ظل التخلف والنظم الاستبدادية، فهل هذه الملامح هي قدر الإنسان العربي، وهل هي سرمدية، ترى..
ما الآفاق ؟ بل ما العمل ؟..
لاشك أن الحركة والتحول ملازمان لكل شيء ، وإن تطور المجتمع عملية طبيعية تاريخية، فلا يمكن أن ننزل إلى ماء النهر الواحد مرتين بتعبير أحد الفلاسفة، لأن مياها جديدة ستتدفق، فالقهر والتخلف ليسا قدر الشعوب، ففي سوريا مثلا شهدنا وعشنا في أجواء من الديمقراطية في الفترة التي تلت الاستقلال في عام1946 حتى عام 1949 ومن عام 1954 بعد سقوط الشيشكلي إلى قيام الوحدة المصرية السورية في عام 1958بالرغم أن الجهل كان أعم والتخلف كان أوسع مدى….
واليوم في ظل التغييرات التي تعصف بالعالم، وفي ظل المستحدثات العلمية، والثورة المعلوماتية، وانتشار القنوات الفضائية، وارتفاع مستوى التعليم نسبيا ، ما عاد أحد غافيا دون أن يتحسس ما يدور في هذا العالم، وصار بمقدور أي فرد أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، وما عاد بين المضطهدين (غوغاء) كما قالته بتعال قريبة صدام، كل إنسان مدرك اليوم ما له من حقوق وما عليه من واجبات، ولن يفرط في حقوقه، سوف يقف عندها رافضا للضيم الذي طال به الأمد، وسيخلع النير هاتفا ، أريد حقوقي، أطلق يديّ، أريد حريتي…..