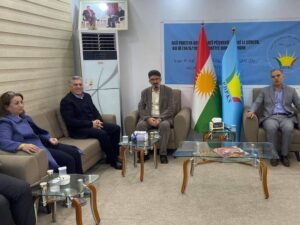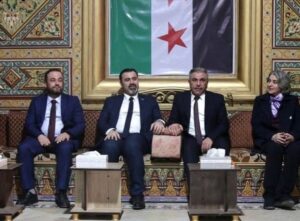ديرك 10/8/2016
المعاني -كما يفترض أن يعرفها الجمي هي تصورات ذهنية (مجردة) نتخيلها (أو نتصورها) بالعقل، وهذا يقتضي تفعيل العقل، والتدرب على التصور التجريدي للمعاني في صور خاصة في الذهن، والتعبير عنها بكلمات(مفاهيم).
ولأن المعاني ليست مادية، فهي متداخلة فيما يشبه، الألوان المتمازجة على سطح الماء (كمثل يقرب إلى الفهم). يقوم الفنان (الخبير) ويعزلها عن بعضها، لكن طبيعتها وسطح الماء المتحرك … تجعلها في حالة متحركة ،ليست ثابتة، مما يعقد عملية الفصل بينهاـ إلا إذا امتلك المرء قوة عقلية فاعلة، تستطيع التخيل المجرد للمعاني، وبأسلوب خاص يتكون نتيجة التجارب والقراءة (الخبرة) يمتلكه –عادة- الفلاسفة والمفكرون والمشغولون بتنمية ثقافتهم المنطقية النظرية، إلى جانب العناصر العملية (الواقعية) في حالة تفاعل بين النظري والعملي (الواقع) يجعل التعاون بين النظري والعملي ، يوفر توازنا ؛ يوصل إلى وضوح الفهم والاستيعاب… فإن لم يتحقق التوازن، زاد جانب على آخر، فإما أن يغلب النظري على العملي أو العكس.
في الحالة الأولى يتجه المرء نحو المبالغة في التصورات النظرية، والبناء عليها. وتسمى هذه الحالة بـ “مثالية”. وان كان المصطلح مشتقا من مُثُل أفلاطون (التخيّلية). نلاحظها لدى الفلاسفة خاصة، ومن في اتجاههم…
ونجد الحالة الثانية لدى علماء الطبيعة الذين تغلب التجربة كمنهج في بحوثهم العلمية مع انهم يستخدمون “الفرضية ” النظرية –التخيلية.
فالعلماء –إذا-يتعاملون مباشرة مع الطبيعة، وهي التي تسمى أيضا (الواقع) أي الموجودات الحسية في الكون كله. ومن هنا انطلق الماركسيون في قولهم ” التحليل الملموس للواقع الملموس” باعتبار الكون جميعا في أصله مكون من ماديات بحتة ولا وجود للروح إلا كانعكاس لحركة المادة. بحسب الأيديولوجية الماركسية، وأساسها المادي الدارويني.
فإذا كنا سنقبل بهذه الفكرة (وهي تصوّر في الحصيلة) لأن إنكار الروح لم يُبن على دليل قطعي، وإنما على فرضية تعتمد على أن عدم معرفة الروح يعني لا وجود مستقل له.
فكيف نقبل الفكرة في الميدان التربوي؟
الواقع هو الحالة الطبيعية القائمة راهنا بمختلف عناصره، وعلى الهيئة التي هي عليها كمنظومة تمثل حالة الواقع كما هو راهنا. وبالتالي لا تراعى فعالية متراكمة اجتماعية؛ شكّلت منظومة ثقافية، تنامت مفاهيمها وروابطها (العلاقات فيها) خلال زمان ممتد، مستندة إلى التراكم التراثي في المنظومة الاجتماعية، التاريخية، القيمية، الأخلاقية، الدينية، العلمية، الفنية، الفولكلورية… والتي تتكثّف جميعا، في مفهوم التاريخ والتراث فيه، أو مفهوم الثقافة في مرحلة –أو مراحل تاريخية معينة-تميز كل مجتمع عن الآخر، وتسمى أيضا الحضارة. وان كن مفهوم الحضارة يغلب فيها البعد المادي بخلاف التراث والثقافة اللتين يغلب فيهما البعد المعنوي، خاصة مفهوم الثقافة.
فعندما نقول: الحضارة يتجه تفكيرنا نحو المنشآت والأوابد والآثار …الخ أكثر من الأفكار والشعر والأدب التي تكون الثقافة أكثر تعبيرا عنها-على الأقل في استعمالاتنا اليومية.
وان كان التراث يشمل العناصر المادية أيضا، إلا إن الأدب والفكر والشعر والمعنويات … ربما اغلب في فهمنا له. لكن المفاهيم الثلاثة: الحضارة، التراث، الثقافة جميعا ذات دلالة واحدة في النهاية، تجمع كل عناصر حياة المجتمع.
إنما محاولة تحديد المعاني بدقة أكثر تجعلنا نبدي هذه الملاحظات.
وبالعودة إلى موضوع المنظور التربوي لهذه المفاهيم والتعامل معها علينا أن نلاحظ أن الواقع ليس شيئا جامدا وثابتا فيما يخص المجتمعات وثقافتها (تراثها –حضارتها). وفيه تراكم ثقافي يجمع تجارب الأسلاف، في حالة تفاعل داخل المجتمع الواحد، ومتأثر بثقافة المجتمعات الأخرى نتيجة احتكاك من نوع ما، تجاري، حروب، تبادل ثقافي، هجرات…الخ.
مما يقتضي أن يؤخذ ذلك في الاعتبار عندما نتباحث (نناقش) قضايا المجتمع الثقافية (العامة). فالحالة الاجتماعية/ الثقافية، حيوية، وذات امتداد في عمق الماضي (التاريخ) ونتائج تفاعلاته التي تشكل المنظومة الثقافية/القيمية. مما يفرض مراعاتها في المنطلقات، والحوارات، والتفاعلات … وبالتالي، ينبغي تجاوز النظرة المادية الوحيدة، والراهنية لمعنى الواقع، الذي يُستغل لمصلحة الاتجاه المادي في التفسير فلسفيا، ولمصلحة الاتجاه الذي يستغل (التباس المعاني) من اجل تمرير أجندات ذات طابع سياسي/اقتصادي… وأدواته التي تستند إلى الخلط في المعاني، وإعلاء شان مفاهيم تثير الغرائز والرغبات والأهواء خدمة لتك الأجندات.