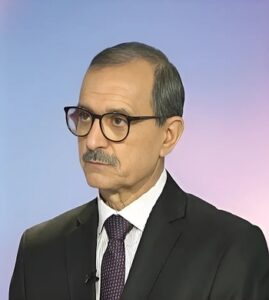ابراهيم محمود
ابراهيم محمود
ما أن يركّز المقيم في إقليم كردستان على أرقام لوحات السيارات وَجهةِ صدور كل منها، كما في : نينوى، الأنبار، بغداد…الخ، ونينوى في الواجهة لسبب يعلَم به كل معني بما يجري، حتى يصبح في صورة الوضع غير المحسود عليه :
هذا الحضور اللافت لهذه السيارات في مدن الإقليم ” في دهوك، كمثال حي “، لا علاقة له البتة طبعاً لا بالسياحة، ولا بالتجارة، أو حتى بالعبور” الترانزيت “، وإلا لكان عليه رؤية أسماء مدن أخرى تحملها لوحات سيارات أخرى، إنما لأن ثمة خللاً أمنياً يقرب من الكارثة أو على تخومها في العراق، يكتوي الإقليم بناره على مستويات مختلفة .
سيارات مصطفة وراء بعضها بعضاً، أو مركونة في ذات الشارع، حيث يتواجد أوتيل أو موتيل أو شقق مفروشة مؤجرة، أو بيوت أهلية مؤجَّرة، تشكل عبئاً كبيراً، غير مسبوق على الإقليم، كما هو الوضع الراهن، عبءٌ لا أظن أن في وسع أي كان التفكير في هذا الانتشار الملحوظ، إلا ويمد بنظره إلى الإقليم من داخله، والتحديات التي يعيشها بصيغ شتى:
إنه وضع عاجل” طارئي ” منذ الغزو الداعشي لموصل، حيث لا أيسر بالمقابل من رؤية تجمعات بشرية، وألسنة تنتسب إلى محافظات عراقية، تجمعات تترجم طبيعة الحراك الشارعي وعلامات الحيرة والقلق وما لا يمكن تحديده في الوجوه، وما يستدعي كل ذلك من تدابير أمنية، وقائية، احترازية، لمواجهة أي طارئ يزيد طين الوضع بلة :
على مستوى التحرك في الشارع، والضغط السكاني، والخدمات المطلوبة، والحساسيات التي لا يمكن تجاهلها، وما لم يألفه الإقليم بالترادف مع نوعية التحديات أو المخاطر والذين يمثلونها، ومضاعفاتها وتداعياتها تأثيراً على الأهلين.
إن ما يتعلق بذاكرات أهل الإقليم الكرد بامتياز، وهي منجرحة، وأي انجراح عضوي ونفسي في تجربة عقود السنوات الماضية، والضحايا الذين يخصونهم: وهم المقربون منهم، ومن الذين كانوا وراء النيل منهم، وصلتهم بالذين احتموا بالإقليم راهناً، لا بد أن يؤخذ بالحسبان، لا بد أن أولي أمر الإقليم ذاته على بينة تامة بحقيقته، والتخوف من انفجار بؤرة توتر هنا أو هناك .
إنها تجربة، وأي تجربة، غير معهودة، كما يعلم أهل المكان الكرد بامتياز والذين عرفوا أنفسهم لزمن طويل رحالة بالإكراه، ومنذورين للترحيل والتهجير والنفي وتذوق الويلات رغم أنوفهم” تحت طائلة التهديد بالموت الزؤام “، استناداً إلى سياسات تصفوية، عنصرية من النظام المستبد طبعاً، ومن كان يجد ضالته من خلالها، تجربة أصبحت معكوسة، حيث بات الإقليم هو نفسه بمثابة ” پاركينغ” لسيارات، وما أكثرها، وهي تقل هاربين من أمصارهم في مفارقات لا يحاط بحقيقتها بسهولة: عرباً وأثوريين أولاً، كما لو أن الإقليم يشهد تمدداً في الداخل وعلى أطرافه مقابل هذا التدافع والبحث عن ملاذات آمنة هرباً من مخاطر مميتة لتكفيريين وغيرهم.
تجربة مسماة، وهي لما تزل قائمة، تراعى من النواحي كافة، ويجب أن تراعى هكذا، من قبل أهل المكان، استناداً إلى حيوات أزهقت أو شوّهت أو اُضطهدت حتى الأمس القريب، وأن هذا المسلسل ” الزحفي ” يثير ردود أفعال، أو لا بد أنه يستثير مشاعر صاخبة ساخطة بالمقابل، من خلال تعكير المناخات النفسية، أو تهيئتها لأن تعيش مشاعر متناقضة، أو لا تدع أصحابها في وضعية استقرار، جرّاء هذه الانعطافة في المعترك السياسي والاجتماعي واليومي.
كل ذلك يعقّد على أهل المكان الكرد بجلاء، بقدر ما يضعهم في مواجهة مواقف محسوبة عليهم، أو اختبار نفسي وثقافي واجتماعي وسياسي، يدفعون إلى معايشته والنجاح فيه أيضاً، لأن ثمة قراراً متخذاً من أعلى سلطة سياسية، بلزوم انفتاح من هذا القبيل، ولكنه الانفتاح الذي لا يقدم ضمانات باستتباب الأمن كما هو متوخى أو مطلوب، لا للمعنيين بأمن الإقليم، ولا حتى بالنسبة إلى الأهالي، كون إيقاع الضغوط لا يخضع لمعيار ضبط محدد .
إنه وضع عاجل” طارئي ” منذ الغزو الداعشي لموصل، حيث لا أيسر بالمقابل من رؤية تجمعات بشرية، وألسنة تنتسب إلى محافظات عراقية، تجمعات تترجم طبيعة الحراك الشارعي وعلامات الحيرة والقلق وما لا يمكن تحديده في الوجوه، وما يستدعي كل ذلك من تدابير أمنية، وقائية، احترازية، لمواجهة أي طارئ يزيد طين الوضع بلة :
على مستوى التحرك في الشارع، والضغط السكاني، والخدمات المطلوبة، والحساسيات التي لا يمكن تجاهلها، وما لم يألفه الإقليم بالترادف مع نوعية التحديات أو المخاطر والذين يمثلونها، ومضاعفاتها وتداعياتها تأثيراً على الأهلين.
إن ما يتعلق بذاكرات أهل الإقليم الكرد بامتياز، وهي منجرحة، وأي انجراح عضوي ونفسي في تجربة عقود السنوات الماضية، والضحايا الذين يخصونهم: وهم المقربون منهم، ومن الذين كانوا وراء النيل منهم، وصلتهم بالذين احتموا بالإقليم راهناً، لا بد أن يؤخذ بالحسبان، لا بد أن أولي أمر الإقليم ذاته على بينة تامة بحقيقته، والتخوف من انفجار بؤرة توتر هنا أو هناك .
إنها تجربة، وأي تجربة، غير معهودة، كما يعلم أهل المكان الكرد بامتياز والذين عرفوا أنفسهم لزمن طويل رحالة بالإكراه، ومنذورين للترحيل والتهجير والنفي وتذوق الويلات رغم أنوفهم” تحت طائلة التهديد بالموت الزؤام “، استناداً إلى سياسات تصفوية، عنصرية من النظام المستبد طبعاً، ومن كان يجد ضالته من خلالها، تجربة أصبحت معكوسة، حيث بات الإقليم هو نفسه بمثابة ” پاركينغ” لسيارات، وما أكثرها، وهي تقل هاربين من أمصارهم في مفارقات لا يحاط بحقيقتها بسهولة: عرباً وأثوريين أولاً، كما لو أن الإقليم يشهد تمدداً في الداخل وعلى أطرافه مقابل هذا التدافع والبحث عن ملاذات آمنة هرباً من مخاطر مميتة لتكفيريين وغيرهم.
تجربة مسماة، وهي لما تزل قائمة، تراعى من النواحي كافة، ويجب أن تراعى هكذا، من قبل أهل المكان، استناداً إلى حيوات أزهقت أو شوّهت أو اُضطهدت حتى الأمس القريب، وأن هذا المسلسل ” الزحفي ” يثير ردود أفعال، أو لا بد أنه يستثير مشاعر صاخبة ساخطة بالمقابل، من خلال تعكير المناخات النفسية، أو تهيئتها لأن تعيش مشاعر متناقضة، أو لا تدع أصحابها في وضعية استقرار، جرّاء هذه الانعطافة في المعترك السياسي والاجتماعي واليومي.
كل ذلك يعقّد على أهل المكان الكرد بجلاء، بقدر ما يضعهم في مواجهة مواقف محسوبة عليهم، أو اختبار نفسي وثقافي واجتماعي وسياسي، يدفعون إلى معايشته والنجاح فيه أيضاً، لأن ثمة قراراً متخذاً من أعلى سلطة سياسية، بلزوم انفتاح من هذا القبيل، ولكنه الانفتاح الذي لا يقدم ضمانات باستتباب الأمن كما هو متوخى أو مطلوب، لا للمعنيين بأمن الإقليم، ولا حتى بالنسبة إلى الأهالي، كون إيقاع الضغوط لا يخضع لمعيار ضبط محدد .
تجربة قاسية، مريرة، مكلفة، تختبر سلطات الإقليم بالذات، وأمام العالم الذي يتلفز ما يجري: صوتاً وصورة، دون نسيان تلك الصورة الضبابية أو المختزلة أو المشوهة التي تتصدر واجهة الأخبار في العالم المحيط بالإقليم وعلى حدوده، وهذا يضاعف حجم التحديات والمخاطر المحتملة، وكأني بالإقليم يعيش هذه التجربة ” الفريدة ” من نوعها، وهو يختبر طاقته في التحمل، إلى جانب التعريف بنفسه عملياً، إنما أكثر من ذلك، في مسعى عميق لأن يفكر المناوئون له أنه جدير بحياة تسمّيه بالأصالة وليس بالوكالة، أو في الحد الأدنى، في أنه يمتلك كل الأدوات التي تمكّنه من أن يكون دار ضيافة مثلى لمن يقدّر …!