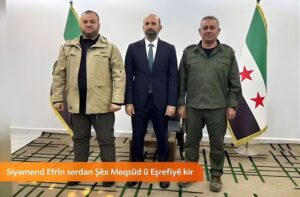هوشنك بروكا
هوشنك بروكا“جينف 2″ أو ما يسمى ب”المؤتمر الدولي للسلام حول سوريا” الذي تمّ اقتراحه على خلفية الإتفاق الأميركي الروسي لإنهاء الأزمة السورية، وحلّها سياسياً عن طريق الحوار والمفاوضات، بات قاب قوسين أو أدنى من الإنعقاد برعاية ومباركة أمميتَين.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أيّد خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المباحثات الروسية الأميركية المشتركة حول عقد هذا المؤتمر، وأبدى استعداده لمساعدة جميع الأطراف لإخراج الأزمة السورية من دائرة الحرب الأهلية، التي حصدت حتى الآن أرواح حوالي 100 ألف قتيل، ودفعها نحو الحل السياسي والسلمي ما أمكن.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أيّد خلال لقائه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف المباحثات الروسية الأميركية المشتركة حول عقد هذا المؤتمر، وأبدى استعداده لمساعدة جميع الأطراف لإخراج الأزمة السورية من دائرة الحرب الأهلية، التي حصدت حتى الآن أرواح حوالي 100 ألف قتيل، ودفعها نحو الحل السياسي والسلمي ما أمكن.
المؤتمر المزمع عقده في أوائل يونيو حزيران القادم لاقى ترحيباً دولياً وعربياً كبيراً، ربما بسبب مراوحة الأزمة السورية مكانها، ودخولها نفقاً مظلماً، وتزايد خطر انزلاق سوريا بالتالي إلى حرب أهلية دموية مدمّرة طويلة الأمد، سيخرج الكلّ منها خاسراً، وسيؤثر سلباً على الأمن والإستقرار الإقليميين، لا سيما على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها إسرائيل، ثم يليها لبنان والعراق.
عودة إميركا و روسيا إلى مربع جنيف الأول، واتفاقهما بالتالي على إحياء اتفاقية “جنيف 1” التي وقعّت عليها الدول الكبرى في يونيو حزيران الماضي، بمشاركة الجامعة العربية، هي إشارة واضحة على يأس العالم من الأزمة السورية، وفشل الخيار العسكري الذي لم يؤدِ سوى إلى المزيد من تدمير سوريا لسوريا، والمزيد من قتل السوريين للسوريين، هذا ناهيك عن امتداد الصراع وتحوّله، رويداً رويداً، من صراع سوري سوري بين نظامٍ وشعبه، إلى صراعٍ طائفي بين سوريتَين، لا بل بين محورين إقليميين.
أميركا توّصلت مع روسيا، على ما يبدو، إلى قناعة شبه أكيدة، بأنّ سلوك الخيار العسكري، في ظلّ توازن الرعب الحاصل بين الجيشين “النظامي” و”الحر”، لن يؤدي سوى إلى المزيد من “إسقاط” الشعب السوري، وربما شعوب المنطقة برمتها أيضاً في حروبٍ طائفية طاحنة، بدلاً من إسقاط نظام الأسد، ولا مخرج بالتالي من هذه الأزمة إلا في سلوك الأطراف المتصارعة الخيار السياسي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر الحوار بين جميع أطراف الصراع، سواء في الداخل السوري، أو خارجه.
هذه القناعة لم تفرضه مصالح الدولتين العظميين فحسب، وإنما أيضاً الوقائع وموازين القوى على الأرض، والتي تقول بأنّ لا نصر قريب لأيّ من طرفي الصراع في سوريا، والخاسر الأكبر بينهما هو الشعب السوري نفسه، الذي لم يحصد حتى الآن سوى الموت الزؤام بدلاً من الحرية والكرامة المفترضَتين.
هذا ناهيك عن أن أميركا قد اقتنعت في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد التقدم الذي أحرزته القوات النظامية على محتلف الجبهات، أنّ أي محاولة منها لتغيير موازين القوى عبر دعم المعارضة السورية بالمال والسلاح، قد يعرضها إلى مخاطر الإنخراط في “حرب بالوكالة” غير مضمونة النتائج، وهو ما لا يريده الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته، كما أشار إلى ذلك أكثر من مرّة.
أوباما قرأ ودرس تجربة سلفه جورج بوش الإبن جيداً، ولا يريد أن يكرر الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبها هذا الأخير في حروبٍ كلّفت أميركا والأميركيين الكثير.
ربما تأسيساً على هذه القناعة، ذهب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لقائه الأخير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى أنّ “البديل عن الخيار السياسي لن يكون سوى المزيد من العنف..
البديل هو اقتراب سوريا بشكل اكبر من هاوية إن لم يكن السقوط في هاوية الفوضى..البديل هو تصاعد الأزمة الإنسانية.
لا بل البديل ربما يكون تفكك سوريا”.
في ظل انعدام البدائل والحلول للأزمة السورية، يمكن إعادة تبرير هذا الهروب الأممي إلى “جينف 2” كأفضل الخيارات المتاحة، والتي من شأنها أن توفر فرصةً لجميع الأطراف المتصارعة للإبتعاد عن حافة الهاوية التي تقف عليها الآن، إلى الأسباب التالية:
أولاً: فشل المعارضة السورية، التي انتهت إلى “معارضات”، في أن تقدّم نفسها كبديل ديمقراطي موّحد لنظام ديكتاتوري شمولي، خصوصاً في ظل سيطرة التيارات الإسلامية، وعلى رأسها الأخوان المسلمين على المعارضة السياسية في الخارج، وسيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة على المعارضة المسلحة وجيوشها في الداخل، وفي مقدمتها “جبهة النُصرة” وأخواتها.
الأمر الذي حوّل الصراع في سوريا من صراع بين نظام ديكتاتوري ظالم وشعب مظلوم، إلى صراع طائفي مقيت بين “سوريا علوية” و”سوريا سنية”.
ما أدى في المحصلة إلى فقدان ثقة المجتمع الدولي بقادم سوريا، وقادم معارضتها التي هي مشروع “سوريا طائفية”، كما يقول قيامها وقعودها، أكثر من كونها مشروعاً لسوريا علمانية، مدنية، تعددية، ديمقراطية.
ثانياً: خطف بعض الجماعات المسلحة الإرهابية المحسوبة على القاعدة وأخواتها للثورة السورية، وتقديمها لنفسها ك”وريثة شرعية” لها، وسكوت المعارضة السورية الممثلة ب”الإئتلاف السوري” و”المجلس الوطني السوري” على إرهابها، لكأنه “إرهاب وطني مُباح” أو “إرهاب حلال زلال”، ل”ضرورات ثورية”، أو بحجة وقوفهم في خندق واحد لمواجهة العدو المشترك.
هذا السكوت “الوطني”، على إرهاب هاته الجماعات، وعدم قبولها لإعتبارات لها علاقة ب”الشرعية الثورية” إدراجها تحت خانة الإرهاب، كما يقول العالم المدني، أو نأيها عن وصفها حتى ب”الجماعات المتشددة”، أفقد الثورة بريقها ورونقها، ما أدى إلى وضع الغرب وعلى رأسه أميركا للكثير من إشارات الإستفهام عليها، وعلى أهلها من “الثوار الإرهابيين”.
ثالثاً: تفاقم أزمة اللاجئين السوريين المنتشرين بين دول الجوار، والذين تجاوز عددهم المليونين ونصف، ووصول جهود الأمم المتحدة لمعالجة أزمتهم إلى حدّ الإنهيار بسبب العجز الهائل في الأموال، وفشل مؤسساتها الإنسانية في تأمين أبسط مستلزمات الحياة لهم.
رابعاً: خوف العالم من امتداد الحريق السوري إلى دول الجوار، وتحوّل الصراع في سوريا، تالياً، إلى صراع إقليمي بين دول “المحور السني” ودول “المحور الشيعي”، وهو الأمر الذي يمكن أن يعرّض أمن المنطقة، وأمن إسرائيل واستقرارها بالدرجة الأساس إلى الخطر.
لهذه الأسباب مجتمعةً، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بمصالح الدول الكبرى، وعلى رأسها أميركا وروسيا، خصوصاً وأنّ سوريا ليست بالعراق ولا بليبيا الغنيتين بالنفط، هرب العالم إلى “الحل السياسي”، مديراً ظهره للثورة السورية، في كونها “صراعاً طائفياً”، أكثر من إعتبارها قضية “شعب مظلوم ضد ديكتاتورية ظالمة”.
لا إشارات إيجابية حتى الآن على نجاح هذا المؤتمر، خصوصاً في ظل موقف المعارضة السورية الممثلة ب”الإئتلاف السوري”، الذي أصرّ منذ الأول من الإتفاق الأميركي الروسي، ولا يزال، على “أن أي حل سلمي يتطلب الرحيل الفوري لبشار الأسد ورؤساء اجهزته الأمنية.
أي حل لا يحتوي على هذه العناصر مرفوض على المستوى السياسي ومن عموم الشعب السوري”، كما جاء في أول رد فعل له على المفاوضات الأميركية الروسية الأخيرة.
علماً أنّ أحد المبادئ الأساسية التي يمكن أن تنطلق على قاعدتها المفاوضات بين طرفي الصراع، هو اعتراف كلّ منهما بأنهما لم ينتصرا، وليس أمامهما سوى الطريق الأسلم والأسلك للعبور إلى سوريا لكلّ السوريين، ألا وهو سلوك طريق المفاوضات كحل وسط لإنقاذ البلاد من السقوط في أتون حرب أهلية طاحنة.
كلا الطرفين، بحسب “جينف 1 و 2″، عليهما الإعتراف بعدم جدوى الحل العسكري، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بقبول الحل السياسي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا.
لكن في الوقت الذي يرفض أهل النظام النزول إلى درك “المفاوضات” مع المعارضة أو ما يسميها ب”الجماعات الإرهابية”، ترفض المعارضة أيضاً في المقابل، بشقيها السياسي والعسكري، أي قبول للحل السياسي، بدون تنحي الأسد ورحيل كافة مرتكزات النظام وتفكيك أجهزته الأمنية.
وفي الوقت الذي تضمن روسيا، كما تشير تصريحات مسؤوليها، مشاركة النظام السوري، كطرف أساسي محسوب عليها في الصراع، في “جينف 2″، لا توجد أية ضمانات أميركية، حتى الآن، للضغط على المعارضة السورية، سواء تلك السياسية منها الممثلة ب”الإئتلاف”، أو العسكرية منها الممثلة ب”الجيش الحر”، للمشاركة في هذا المؤتمر، سيما وأنّ المعارضة بشقيها السياسي والعسكري، هي معارضة مشرذمة ومنقسمة على نفسها بين أكثر من تيار، وأكثر من قوة إقليمية.
لكنّ السؤال الجوهري الذي سيبقى يفرض نفسه على الكلّ المفاوض، سواء على أهل الصراع في الداخل السوري، أو على المستقطبين إقليمياً ودولياً من حوله، هو ما الضمان للإنتقال بالفعل إلى سوريا أفضل، سوريا حرّة ديمقراطية تعددية لكلّ السوريين، سوريا بلا ملوك طوائف، بلا تجار حروب، بلا “محاكم شرعية”، وبلا دساتير “فوق بشرية”؟
عودة إميركا و روسيا إلى مربع جنيف الأول، واتفاقهما بالتالي على إحياء اتفاقية “جنيف 1” التي وقعّت عليها الدول الكبرى في يونيو حزيران الماضي، بمشاركة الجامعة العربية، هي إشارة واضحة على يأس العالم من الأزمة السورية، وفشل الخيار العسكري الذي لم يؤدِ سوى إلى المزيد من تدمير سوريا لسوريا، والمزيد من قتل السوريين للسوريين، هذا ناهيك عن امتداد الصراع وتحوّله، رويداً رويداً، من صراع سوري سوري بين نظامٍ وشعبه، إلى صراعٍ طائفي بين سوريتَين، لا بل بين محورين إقليميين.
أميركا توّصلت مع روسيا، على ما يبدو، إلى قناعة شبه أكيدة، بأنّ سلوك الخيار العسكري، في ظلّ توازن الرعب الحاصل بين الجيشين “النظامي” و”الحر”، لن يؤدي سوى إلى المزيد من “إسقاط” الشعب السوري، وربما شعوب المنطقة برمتها أيضاً في حروبٍ طائفية طاحنة، بدلاً من إسقاط نظام الأسد، ولا مخرج بالتالي من هذه الأزمة إلا في سلوك الأطراف المتصارعة الخيار السياسي، والجلوس إلى طاولة المفاوضات عبر الحوار بين جميع أطراف الصراع، سواء في الداخل السوري، أو خارجه.
هذه القناعة لم تفرضه مصالح الدولتين العظميين فحسب، وإنما أيضاً الوقائع وموازين القوى على الأرض، والتي تقول بأنّ لا نصر قريب لأيّ من طرفي الصراع في سوريا، والخاسر الأكبر بينهما هو الشعب السوري نفسه، الذي لم يحصد حتى الآن سوى الموت الزؤام بدلاً من الحرية والكرامة المفترضَتين.
هذا ناهيك عن أن أميركا قد اقتنعت في الآونة الأخيرة، خصوصاً بعد التقدم الذي أحرزته القوات النظامية على محتلف الجبهات، أنّ أي محاولة منها لتغيير موازين القوى عبر دعم المعارضة السورية بالمال والسلاح، قد يعرضها إلى مخاطر الإنخراط في “حرب بالوكالة” غير مضمونة النتائج، وهو ما لا يريده الرئيس الأميركي باراك أوباما وإدارته، كما أشار إلى ذلك أكثر من مرّة.
أوباما قرأ ودرس تجربة سلفه جورج بوش الإبن جيداً، ولا يريد أن يكرر الأخطاء الإستراتيجية التي ارتكبها هذا الأخير في حروبٍ كلّفت أميركا والأميركيين الكثير.
ربما تأسيساً على هذه القناعة، ذهب وزير الخارجية الأميركي جون كيري في لقائه الأخير مع نظيره الروسي سيرغي لافروف إلى أنّ “البديل عن الخيار السياسي لن يكون سوى المزيد من العنف..
البديل هو اقتراب سوريا بشكل اكبر من هاوية إن لم يكن السقوط في هاوية الفوضى..البديل هو تصاعد الأزمة الإنسانية.
لا بل البديل ربما يكون تفكك سوريا”.
في ظل انعدام البدائل والحلول للأزمة السورية، يمكن إعادة تبرير هذا الهروب الأممي إلى “جينف 2” كأفضل الخيارات المتاحة، والتي من شأنها أن توفر فرصةً لجميع الأطراف المتصارعة للإبتعاد عن حافة الهاوية التي تقف عليها الآن، إلى الأسباب التالية:
أولاً: فشل المعارضة السورية، التي انتهت إلى “معارضات”، في أن تقدّم نفسها كبديل ديمقراطي موّحد لنظام ديكتاتوري شمولي، خصوصاً في ظل سيطرة التيارات الإسلامية، وعلى رأسها الأخوان المسلمين على المعارضة السياسية في الخارج، وسيطرة الجماعات الإسلامية المتشددة على المعارضة المسلحة وجيوشها في الداخل، وفي مقدمتها “جبهة النُصرة” وأخواتها.
الأمر الذي حوّل الصراع في سوريا من صراع بين نظام ديكتاتوري ظالم وشعب مظلوم، إلى صراع طائفي مقيت بين “سوريا علوية” و”سوريا سنية”.
ما أدى في المحصلة إلى فقدان ثقة المجتمع الدولي بقادم سوريا، وقادم معارضتها التي هي مشروع “سوريا طائفية”، كما يقول قيامها وقعودها، أكثر من كونها مشروعاً لسوريا علمانية، مدنية، تعددية، ديمقراطية.
ثانياً: خطف بعض الجماعات المسلحة الإرهابية المحسوبة على القاعدة وأخواتها للثورة السورية، وتقديمها لنفسها ك”وريثة شرعية” لها، وسكوت المعارضة السورية الممثلة ب”الإئتلاف السوري” و”المجلس الوطني السوري” على إرهابها، لكأنه “إرهاب وطني مُباح” أو “إرهاب حلال زلال”، ل”ضرورات ثورية”، أو بحجة وقوفهم في خندق واحد لمواجهة العدو المشترك.
هذا السكوت “الوطني”، على إرهاب هاته الجماعات، وعدم قبولها لإعتبارات لها علاقة ب”الشرعية الثورية” إدراجها تحت خانة الإرهاب، كما يقول العالم المدني، أو نأيها عن وصفها حتى ب”الجماعات المتشددة”، أفقد الثورة بريقها ورونقها، ما أدى إلى وضع الغرب وعلى رأسه أميركا للكثير من إشارات الإستفهام عليها، وعلى أهلها من “الثوار الإرهابيين”.
ثالثاً: تفاقم أزمة اللاجئين السوريين المنتشرين بين دول الجوار، والذين تجاوز عددهم المليونين ونصف، ووصول جهود الأمم المتحدة لمعالجة أزمتهم إلى حدّ الإنهيار بسبب العجز الهائل في الأموال، وفشل مؤسساتها الإنسانية في تأمين أبسط مستلزمات الحياة لهم.
رابعاً: خوف العالم من امتداد الحريق السوري إلى دول الجوار، وتحوّل الصراع في سوريا، تالياً، إلى صراع إقليمي بين دول “المحور السني” ودول “المحور الشيعي”، وهو الأمر الذي يمكن أن يعرّض أمن المنطقة، وأمن إسرائيل واستقرارها بالدرجة الأساس إلى الخطر.
لهذه الأسباب مجتمعةً، إلى جانب أسباب أخرى تتعلق بمصالح الدول الكبرى، وعلى رأسها أميركا وروسيا، خصوصاً وأنّ سوريا ليست بالعراق ولا بليبيا الغنيتين بالنفط، هرب العالم إلى “الحل السياسي”، مديراً ظهره للثورة السورية، في كونها “صراعاً طائفياً”، أكثر من إعتبارها قضية “شعب مظلوم ضد ديكتاتورية ظالمة”.
لا إشارات إيجابية حتى الآن على نجاح هذا المؤتمر، خصوصاً في ظل موقف المعارضة السورية الممثلة ب”الإئتلاف السوري”، الذي أصرّ منذ الأول من الإتفاق الأميركي الروسي، ولا يزال، على “أن أي حل سلمي يتطلب الرحيل الفوري لبشار الأسد ورؤساء اجهزته الأمنية.
أي حل لا يحتوي على هذه العناصر مرفوض على المستوى السياسي ومن عموم الشعب السوري”، كما جاء في أول رد فعل له على المفاوضات الأميركية الروسية الأخيرة.
علماً أنّ أحد المبادئ الأساسية التي يمكن أن تنطلق على قاعدتها المفاوضات بين طرفي الصراع، هو اعتراف كلّ منهما بأنهما لم ينتصرا، وليس أمامهما سوى الطريق الأسلم والأسلك للعبور إلى سوريا لكلّ السوريين، ألا وهو سلوك طريق المفاوضات كحل وسط لإنقاذ البلاد من السقوط في أتون حرب أهلية طاحنة.
كلا الطرفين، بحسب “جينف 1 و 2″، عليهما الإعتراف بعدم جدوى الحل العسكري، والجلوس إلى طاولة المفاوضات، بقبول الحل السياسي، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من سوريا.
لكن في الوقت الذي يرفض أهل النظام النزول إلى درك “المفاوضات” مع المعارضة أو ما يسميها ب”الجماعات الإرهابية”، ترفض المعارضة أيضاً في المقابل، بشقيها السياسي والعسكري، أي قبول للحل السياسي، بدون تنحي الأسد ورحيل كافة مرتكزات النظام وتفكيك أجهزته الأمنية.
وفي الوقت الذي تضمن روسيا، كما تشير تصريحات مسؤوليها، مشاركة النظام السوري، كطرف أساسي محسوب عليها في الصراع، في “جينف 2″، لا توجد أية ضمانات أميركية، حتى الآن، للضغط على المعارضة السورية، سواء تلك السياسية منها الممثلة ب”الإئتلاف”، أو العسكرية منها الممثلة ب”الجيش الحر”، للمشاركة في هذا المؤتمر، سيما وأنّ المعارضة بشقيها السياسي والعسكري، هي معارضة مشرذمة ومنقسمة على نفسها بين أكثر من تيار، وأكثر من قوة إقليمية.
لكنّ السؤال الجوهري الذي سيبقى يفرض نفسه على الكلّ المفاوض، سواء على أهل الصراع في الداخل السوري، أو على المستقطبين إقليمياً ودولياً من حوله، هو ما الضمان للإنتقال بالفعل إلى سوريا أفضل، سوريا حرّة ديمقراطية تعددية لكلّ السوريين، سوريا بلا ملوك طوائف، بلا تجار حروب، بلا “محاكم شرعية”، وبلا دساتير “فوق بشرية”؟