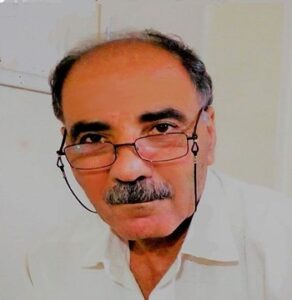د.
د.عبد الباسط سيدا
يبدو أن الزمرة اللامرئية التي تمسك بزمام أمور الحكم في سورية قد فقدت توازنها، نتيجة تيقّنها من أن ما تواجهه ليس مجرد موجة غضب ستهدأ بعد حين؛ أو ردة فعل تجاه تصرفات غير مقبولة من هذا المسؤول أو ذك؛ أو حالة احتجاجية محدودة النطاق والأهداف؛ لأن ما تشهده سورية بأسرها منذ الخامس عشر من آذار المنصرم إنما هو في حقيقته ثورة شعبية عامة، ثورة عارمة ترمي إلى القطع مع سلطة الاستبداد والإفساد.
وهي حالة تولدت بفعل جملة تراكمات كمية على مدى عقود، لتتحوّل إلى نهوض نوعي لم تكن الزمرة المعنية تتمناه أو تتخيله في يوم من الأيام؛ وهي الزمرة ذاتها التي اعتقدت في يوما ما بأنها قد صادرت على كل احتمال من شأنه تهديد سلطتها المطلقة، وذلك بعد أن هيمنت على الدولة، والحزب، والجيش، والجامعة والسوق.
وامتدت أذرعها الأمنية- القمعية إلى الخاص الخاص من حياة الأفراد.
وهي حالة تولدت بفعل جملة تراكمات كمية على مدى عقود، لتتحوّل إلى نهوض نوعي لم تكن الزمرة المعنية تتمناه أو تتخيله في يوم من الأيام؛ وهي الزمرة ذاتها التي اعتقدت في يوما ما بأنها قد صادرت على كل احتمال من شأنه تهديد سلطتها المطلقة، وذلك بعد أن هيمنت على الدولة، والحزب، والجيش، والجامعة والسوق.
وامتدت أذرعها الأمنية- القمعية إلى الخاص الخاص من حياة الأفراد.
لكن العشب الأخضر لا يبقى دائما تحت الأحجار كما يقول المثل الكردي؛ فإرادة الحياة العزيزة الكريمة تتحول في لحظة نوعية مفصلية إلى قوة هائلة في مقدورها الإتيان بالمعجزات، فكيف إذا كانت هذه الإرادة تجسد تطلعاً نبيلاً لشعب بكامله في مواجهة قلة أقل من القليل، قلة لم تقدم للبلد وأهله سوى القمع والإفساد والنهب والتسطيح.
غير أن الزمرة المعنية مصرة مع ذلك على تخبطها؛ توّزع قواها في مختلف الاتجاهات؛ علّها تتمكّن من إقناع الذات قبل الآخر بأن صلاحيتها لم تنته بعد.
وفي إطار محاولاتها العبثية هذه من أجل البقاء وبأي ثمن، يأتي مشروع قانون الأحزاب الذي أعلنت عنه قبل أيام من خلال مجلس الوزراء – الواجهة، وهو قانون توحي القراءة الأولية له بأن الذهنية التي أصدرته تعاني حالة اضطراب بنيوية، أفقدتها القدرة على مراعاة أبسط قواعد المنطق الشعبوي، ناهيك عن العلمي الرصين.
فالقانون المشار إليه يحدد الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب، وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها في سورية؛ وهي كلها مبادئ تتعارض بالمطلق مع تلك التي تأسس عليها حزب البعث الذي ما زال بموجب الدستور السوري المفروض هو القائد للدولة والمجتمع، وهو الدستور ذاته الذي تطالب المادة الأولى من القانون الجديد بضرورة الالتزام به.
فالقانون موضوع البحث يحدد الحفاظ على وحدة الوطن، وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع من شروط حصول الحزب على الترخيص؛ ومن المفروض ان الوحدة الوطنية تقوم على أساس احترام سائر المكوّنات السوري، خاصة تلك التي ارتبط مصيرها بمصير الكيان السياسي السوري بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك بناء على الاتفاقيات التي تمت بين الدول الاستعمارية المنتصرة في الحرب وتركيا المهزومة.
ويُشار هنا بصورة خاصة إلى المكوّن الكردي تحديداً الذي قُسّم أرضاً وشعباً، واُلحق بسورية الكيان السياسي الوليد.
هذه حقيقة واقعة مثبتة في كتب التاريخ والجغرافيا وفي مراكز الأرشيف والبحث، ويمكن لأي مهتم موضوعي أن يطلع عليها.
والكرد راهناً يمثلون نسبة تبلغ 15% من السكان، وهي نسبة كبيرة إذا أخذنا الواقع التعددي الذي يتسم به المجتمع السوري؛ ولا يمكن لأية دعوة إلى الوحدة الوطنية الفعلية أن تتجاهل حقيقة الوجود الكردي في سورية، مهما بلغت درجة لطافة المجاملات، وارتفعت وتيرة التشنجات الرغبوية.
ويبدو أن رواد الاستقلال السوري الأوائل كانوا يدركون هذه الحقيقة ويحترمونها، وانتهجوا من أجل ذلك نهجاً توافقياً استيعابياً، لم يشعر بفعله أي مواطن بأنه غريب عن الوطن وأهله؛ ولم يجد أمامه من الحواجز التي كان من شأنها أن تشعره بأن عقلية إقصائية ما تحول بينه وبين بلوغ ما يتناسب مع كفاءاته وتطلعاته.
ومن هنا كان حرص رواد الاستقلال الدولة على اختيار اسم للدولة الجديدة يتناسب مع بنيتها وطبيعتها، ووقع الاختيار على الدولة/الجمهورية السورية، ليكون مفهوما يشمل ما صدقه كل السوريين من دون استثناء؛ في حين أصر الانقلابيون الانفصاليون على إضافة صفة العروبة، سعياً منهم لتسويق نزوعهم ما قبل الوطني؛ وكان الاسم الجديد: الجمهورية العربية السورية، وتراجع الما صدق لصالح التضمن – إذا جاز لنا استخدام هذه المصطلحات المنطقية- وجاءت سلطة البعث لتحكم البلد بقوة السلاح بعد انقلاب 8 آذار 1963 ،والتزمت سياسات تمييزية عنصرية تحت يافطات قوموية، سرعان ما تبين للجميع بأنها كانت تمويهاً لعملية تصفية حسابات بين المجموعات المتصادمة، المتصارعة على كيفية الانقضاض على الوطن وأهله.
سياسات اعتمدت جملة من المبادئ العنصرية التي ما زال دستور حزب البعث يعج بها، وما زال هذا الدستور يشكل المنظومة المفهومية لكثير من أصحاب النزعة القومية.
فالدستور المعني يرى – المبدأ الأول من المبادئ الأساسية- أن الوطن العربي ” هو للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته”.
كلام عام متفق عليه؛ ولكن ما أن تأتي التفاصيل الخاصة برسم حدود هذا الوطن، حتى تبدأ الخلافات والمشكلات؛ لأن الدستور – موضوع البحث- يقدم تصوره للحدود المعنية بناء على نزوع ذاتي غير واقعي، مفارق لأي سند بحثي علمي آثاري تاريخي.
وهذا ما نقرأه في المادة السابعة من المبادئ الأساسية من الدستور نفسه: “الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط” .
فحزب البعث يلغي نهائياً وجود القوميات الأخرى من كرد وأمازيغ وقوميات أفريقية وغيرها، وهي القوميات التي كانت في مناطقها قبل وصول العرب إليها ضمن إطار الحملات التي نشرت الإسلام هناك.
ولا يكتفي الدستور البعثي بهذا السلب لحقوق الشعوب الأخرى، بل يصر على تقديم تعريف خاص للعربي ينسجم مع مقاسات التوجه الإيديولوجي لواضعيه؛ أولئك الذين اعتمدوا دستورهم لتسويغ غير المسوغ؛ فالعربي وفق المادة العاشرة من المبادئ العامة من الدستور المعني “هو من كانت لغته العربية وعاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها وأمن بانتسابه للأمة العربية”.
أما من يصر على انتمائه القومي، فـ “سيجلى عن الوطن العربي” – وذلك بناء على المادة الحادية عشرة من الدستور عينه- “ولن يمنح أية حقوق” لأن هذه الأخيرة تمنح – بموجب المادة 20 من المصدر ذاته- “كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية وأخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري”.
إننا إذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار، فسنلاحظ أن دستور حزب البعث يتعارض بصورة صارخة مع الشروط التي حددها مشروع قانون الأحزاب الأخير- على الأقل وفق القراء الظاهرية له- الذي أقره مجلس الوزراء السوري مؤخراً.
وهذا أمر فحواه أن الغرض من القانون الأخير ليس المعالجة الجادة للأوضاع غير السوية التي تعيشها سورية منذ سيطرة حزب البعث على السلطة في سورية عام 1963، وإنما هو في حقيقة الأمر ذر الرماد في الأعين، وتضليل الداخل والخارج.
أما إذا انتقلنا إلى الشروط الأخرى التي يحددها مشروع القانون موضوع البحث، فسنلاحظ أن الشرط السادس يقضي بضرورة عدم اعتماد الحزب أية” تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية….
أو استخدام العنف بكل أشكاله”.
وهذا الشرط يتعارض بالمطلق مع وضعية حزب البعث الذي يلزم أعضاءه بدورات عسكرية وشبه عسكرية؛ كما أنه الحزب الوحيد الذي يمارس نشاطه العلني داخل الجيش، حتى أن هذا الأخير أُعلن جيشاَ عقائدياً، يلتزم بعقيدة البعث؛ بل أن الضابط غير الحزبي لا يتولى أي منصب قيادي مهما كانت مؤهلاته.
من جهة أخرى، نرى أن قسماً كبيراً من البعثيين اليوم، يلتزمون أو يُلزمون باستخدام العنف لقمع المتظاهرين السلميين في المدن والبلدات السورية، وذلك في عداد شبيحة النظام القمعي.
أما الشرط الآخر القائل بـ : “أن الحزب ينبغي ألاّ يكون فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري”.
فهو الآخر لا ينطبق على حزب البعث الذي له فروع في دول عربية عدة من دون رغبة أو موافقة هذه الأخيرة.
وفيما يتصل بالشرط الخاص بعلنية مصادر تمويل الحزب، فهو الآخر لا يتناول حزب البعث الذي يتصرف وكأن الدولة ملكه؛ فهو يستخدم المباني الحكومية، وينفق أموال الدولة – وهي أموال الشعب أولاً وأخيراً- على رواتب كوادره وقياداته ودوارته الحزبية والعسكرية، وعلى إجازات الفئة المصطفاة.
كما أن أعضاءه لهم الأولوية في التعيين والامتيازات ووظائف الإدارة.
وللحزب ذاته نسبة 51% من أعضاء مجالس الإدارة المحلية في البلدان والمدن والمناطق والمحافظات إلى جانب مجلس الشعب.
وهذا كله معناه أن حزب البعث -على الأقل نظرياً- لا يعامل على أساس أنه قائد الدولة والمجتمع فحسب، بل يعتبر المالك لهما أيضاً، المتغلغل في كل مفاصلهما، وذلك بالتناغم مع وضعية تحوله إلى امتداد لسلطة الأجهزة الأمنية، ويافطة تُستخدم لإخفاء معالم دولة الأجهزة الأمنية الخفية، الدولة العميقة التي تتحكم بكل شاردة وواردة تخص الدولة والمجتمع وحياة المواطنين الأفراد في سورية.
واعتماداً على ما تقدم، نرى أن مشروع قانون الأحزاب الأخير إنما هو في حقيقته محاولة من محاولات التضليل التي تلجأ إليها مجموعة الحكم في سورية بغية التغطية على جرائمها على الأرض، وهي جرائم تشمل قتل واعتقال وتعذيب المواطنين الأبرياء المعارضين لسلطة الاستبداد والإفساد، وانتهاك حرمات الناس.
لكن شعبنا الذي يستلهم خبرة طويلة عميقة، ويمتلك تجربة غنية مع السلطة المافيوية لم يعد يولي أي اهتمام يذكر لهكذا أحابيل، أحبايل لا هدف لها سوى ضخ مزيد من الطاقة في آلة بطش النظام، هذا النظام الأمني- القمعي الذي لا يمكن من دون تفكيكه، وإسقاطه، التحدث عن أية إمكانية للشروع في حوار وطني جاد، حوار من شأنه التأسيس لمشروع وطني ديمقراطي سوري عام يؤكد أن سورية الجديدة ستكون بكل ولكل أبنائها.
غير أن الزمرة المعنية مصرة مع ذلك على تخبطها؛ توّزع قواها في مختلف الاتجاهات؛ علّها تتمكّن من إقناع الذات قبل الآخر بأن صلاحيتها لم تنته بعد.
وفي إطار محاولاتها العبثية هذه من أجل البقاء وبأي ثمن، يأتي مشروع قانون الأحزاب الذي أعلنت عنه قبل أيام من خلال مجلس الوزراء – الواجهة، وهو قانون توحي القراءة الأولية له بأن الذهنية التي أصدرته تعاني حالة اضطراب بنيوية، أفقدتها القدرة على مراعاة أبسط قواعد المنطق الشعبوي، ناهيك عن العلمي الرصين.
فالقانون المشار إليه يحدد الأهداف والمبادئ الأساسية الناظمة لعمل الأحزاب، وشروط وإجراءات تأسيسها وترخيصها في سورية؛ وهي كلها مبادئ تتعارض بالمطلق مع تلك التي تأسس عليها حزب البعث الذي ما زال بموجب الدستور السوري المفروض هو القائد للدولة والمجتمع، وهو الدستور ذاته الذي تطالب المادة الأولى من القانون الجديد بضرورة الالتزام به.
فالقانون موضوع البحث يحدد الحفاظ على وحدة الوطن، وترسيخ الوحدة الوطنية للمجتمع من شروط حصول الحزب على الترخيص؛ ومن المفروض ان الوحدة الوطنية تقوم على أساس احترام سائر المكوّنات السوري، خاصة تلك التي ارتبط مصيرها بمصير الكيان السياسي السوري بعد الحرب العالمية الأولى، وذلك بناء على الاتفاقيات التي تمت بين الدول الاستعمارية المنتصرة في الحرب وتركيا المهزومة.
ويُشار هنا بصورة خاصة إلى المكوّن الكردي تحديداً الذي قُسّم أرضاً وشعباً، واُلحق بسورية الكيان السياسي الوليد.
هذه حقيقة واقعة مثبتة في كتب التاريخ والجغرافيا وفي مراكز الأرشيف والبحث، ويمكن لأي مهتم موضوعي أن يطلع عليها.
والكرد راهناً يمثلون نسبة تبلغ 15% من السكان، وهي نسبة كبيرة إذا أخذنا الواقع التعددي الذي يتسم به المجتمع السوري؛ ولا يمكن لأية دعوة إلى الوحدة الوطنية الفعلية أن تتجاهل حقيقة الوجود الكردي في سورية، مهما بلغت درجة لطافة المجاملات، وارتفعت وتيرة التشنجات الرغبوية.
ويبدو أن رواد الاستقلال السوري الأوائل كانوا يدركون هذه الحقيقة ويحترمونها، وانتهجوا من أجل ذلك نهجاً توافقياً استيعابياً، لم يشعر بفعله أي مواطن بأنه غريب عن الوطن وأهله؛ ولم يجد أمامه من الحواجز التي كان من شأنها أن تشعره بأن عقلية إقصائية ما تحول بينه وبين بلوغ ما يتناسب مع كفاءاته وتطلعاته.
ومن هنا كان حرص رواد الاستقلال الدولة على اختيار اسم للدولة الجديدة يتناسب مع بنيتها وطبيعتها، ووقع الاختيار على الدولة/الجمهورية السورية، ليكون مفهوما يشمل ما صدقه كل السوريين من دون استثناء؛ في حين أصر الانقلابيون الانفصاليون على إضافة صفة العروبة، سعياً منهم لتسويق نزوعهم ما قبل الوطني؛ وكان الاسم الجديد: الجمهورية العربية السورية، وتراجع الما صدق لصالح التضمن – إذا جاز لنا استخدام هذه المصطلحات المنطقية- وجاءت سلطة البعث لتحكم البلد بقوة السلاح بعد انقلاب 8 آذار 1963 ،والتزمت سياسات تمييزية عنصرية تحت يافطات قوموية، سرعان ما تبين للجميع بأنها كانت تمويهاً لعملية تصفية حسابات بين المجموعات المتصادمة، المتصارعة على كيفية الانقضاض على الوطن وأهله.
سياسات اعتمدت جملة من المبادئ العنصرية التي ما زال دستور حزب البعث يعج بها، وما زال هذا الدستور يشكل المنظومة المفهومية لكثير من أصحاب النزعة القومية.
فالدستور المعني يرى – المبدأ الأول من المبادئ الأساسية- أن الوطن العربي ” هو للعرب، ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته”.
كلام عام متفق عليه؛ ولكن ما أن تأتي التفاصيل الخاصة برسم حدود هذا الوطن، حتى تبدأ الخلافات والمشكلات؛ لأن الدستور – موضوع البحث- يقدم تصوره للحدود المعنية بناء على نزوع ذاتي غير واقعي، مفارق لأي سند بحثي علمي آثاري تاريخي.
وهذا ما نقرأه في المادة السابعة من المبادئ الأساسية من الدستور نفسه: “الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط” .
فحزب البعث يلغي نهائياً وجود القوميات الأخرى من كرد وأمازيغ وقوميات أفريقية وغيرها، وهي القوميات التي كانت في مناطقها قبل وصول العرب إليها ضمن إطار الحملات التي نشرت الإسلام هناك.
ولا يكتفي الدستور البعثي بهذا السلب لحقوق الشعوب الأخرى، بل يصر على تقديم تعريف خاص للعربي ينسجم مع مقاسات التوجه الإيديولوجي لواضعيه؛ أولئك الذين اعتمدوا دستورهم لتسويغ غير المسوغ؛ فالعربي وفق المادة العاشرة من المبادئ العامة من الدستور المعني “هو من كانت لغته العربية وعاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها وأمن بانتسابه للأمة العربية”.
أما من يصر على انتمائه القومي، فـ “سيجلى عن الوطن العربي” – وذلك بناء على المادة الحادية عشرة من الدستور عينه- “ولن يمنح أية حقوق” لأن هذه الأخيرة تمنح – بموجب المادة 20 من المصدر ذاته- “كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية وأخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري”.
إننا إذا أخذنا كل ذلك بعين الاعتبار، فسنلاحظ أن دستور حزب البعث يتعارض بصورة صارخة مع الشروط التي حددها مشروع قانون الأحزاب الأخير- على الأقل وفق القراء الظاهرية له- الذي أقره مجلس الوزراء السوري مؤخراً.
وهذا أمر فحواه أن الغرض من القانون الأخير ليس المعالجة الجادة للأوضاع غير السوية التي تعيشها سورية منذ سيطرة حزب البعث على السلطة في سورية عام 1963، وإنما هو في حقيقة الأمر ذر الرماد في الأعين، وتضليل الداخل والخارج.
أما إذا انتقلنا إلى الشروط الأخرى التي يحددها مشروع القانون موضوع البحث، فسنلاحظ أن الشرط السادس يقضي بضرورة عدم اعتماد الحزب أية” تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية….
أو استخدام العنف بكل أشكاله”.
وهذا الشرط يتعارض بالمطلق مع وضعية حزب البعث الذي يلزم أعضاءه بدورات عسكرية وشبه عسكرية؛ كما أنه الحزب الوحيد الذي يمارس نشاطه العلني داخل الجيش، حتى أن هذا الأخير أُعلن جيشاَ عقائدياً، يلتزم بعقيدة البعث؛ بل أن الضابط غير الحزبي لا يتولى أي منصب قيادي مهما كانت مؤهلاته.
من جهة أخرى، نرى أن قسماً كبيراً من البعثيين اليوم، يلتزمون أو يُلزمون باستخدام العنف لقمع المتظاهرين السلميين في المدن والبلدات السورية، وذلك في عداد شبيحة النظام القمعي.
أما الشرط الآخر القائل بـ : “أن الحزب ينبغي ألاّ يكون فرعاً أو تابعاً لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري”.
فهو الآخر لا ينطبق على حزب البعث الذي له فروع في دول عربية عدة من دون رغبة أو موافقة هذه الأخيرة.
وفيما يتصل بالشرط الخاص بعلنية مصادر تمويل الحزب، فهو الآخر لا يتناول حزب البعث الذي يتصرف وكأن الدولة ملكه؛ فهو يستخدم المباني الحكومية، وينفق أموال الدولة – وهي أموال الشعب أولاً وأخيراً- على رواتب كوادره وقياداته ودوارته الحزبية والعسكرية، وعلى إجازات الفئة المصطفاة.
كما أن أعضاءه لهم الأولوية في التعيين والامتيازات ووظائف الإدارة.
وللحزب ذاته نسبة 51% من أعضاء مجالس الإدارة المحلية في البلدان والمدن والمناطق والمحافظات إلى جانب مجلس الشعب.
وهذا كله معناه أن حزب البعث -على الأقل نظرياً- لا يعامل على أساس أنه قائد الدولة والمجتمع فحسب، بل يعتبر المالك لهما أيضاً، المتغلغل في كل مفاصلهما، وذلك بالتناغم مع وضعية تحوله إلى امتداد لسلطة الأجهزة الأمنية، ويافطة تُستخدم لإخفاء معالم دولة الأجهزة الأمنية الخفية، الدولة العميقة التي تتحكم بكل شاردة وواردة تخص الدولة والمجتمع وحياة المواطنين الأفراد في سورية.
واعتماداً على ما تقدم، نرى أن مشروع قانون الأحزاب الأخير إنما هو في حقيقته محاولة من محاولات التضليل التي تلجأ إليها مجموعة الحكم في سورية بغية التغطية على جرائمها على الأرض، وهي جرائم تشمل قتل واعتقال وتعذيب المواطنين الأبرياء المعارضين لسلطة الاستبداد والإفساد، وانتهاك حرمات الناس.
لكن شعبنا الذي يستلهم خبرة طويلة عميقة، ويمتلك تجربة غنية مع السلطة المافيوية لم يعد يولي أي اهتمام يذكر لهكذا أحابيل، أحبايل لا هدف لها سوى ضخ مزيد من الطاقة في آلة بطش النظام، هذا النظام الأمني- القمعي الذي لا يمكن من دون تفكيكه، وإسقاطه، التحدث عن أية إمكانية للشروع في حوار وطني جاد، حوار من شأنه التأسيس لمشروع وطني ديمقراطي سوري عام يؤكد أن سورية الجديدة ستكون بكل ولكل أبنائها.
القدس العربي 1-8-2011